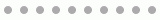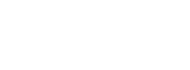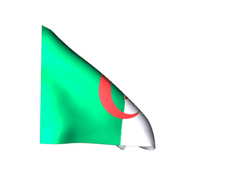ش : أي : أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال : صفات الذات وصفات الفعل . ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال ، وفقدها صفة نقص ، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده . ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الإختيارية ونحوها ، كالخلق والتصوير، والاماتة والاحياء ، والقبض والبسط والطي ، والاستواء والإتيان والمجيء ، والنزول ، والغضب والرضى ، ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله ، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا ، ولكن أصل معناه معلوم لنا ، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه ، لما سئل عن قوله تعالى : ثم استوى على العرش وغيرها : كيف استوى؟ فقال : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول . وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت ، كما في حديث الشفاعة : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله . لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ، ولا يطلق [عليه] أنه حدث بعد أن لم يكن ، ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلمًا بالأمس لا يقال : أنه حدث له الكلام ، ولو كان غير متكلم ، لأنه لآفة كالصغر . والخرس ، ثم تكلم يقال - : حدث له الكلام ، فالساكت لغير آفة يسمى متكلماً بالقوة ، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء ، وفي حال تكلمه يسمى متكلماً بالفعل ، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ، ولا يخرج عن كونه كاتباً في حال عدم مباشرته الكتابة .
وحول الحوادث بالرب تعالى ، المنفي في علم الكلام المذموم ، لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة ، وفيه إجمال : فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة لشيء من مخلوقاته المحدثة ، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن - فهذا نفي صحيح . وإن أريد [به] نفي الصفات الإختيارية ، من أنه لا يفعل ما يريد ، ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والإستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته - فهذا نفي باطل .
وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث ، فيسلم السني للمتكلم ذلك ، على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله ، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الإختيارية وصفات الفعل ، وهو [غير] لازم له . وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل ، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه .
وكذلك مسألة الصفة : هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل ، وكذلك لفظ الغير، فيه إجمال ، فقد يراد [به] ما ليس هو إياه ، وقد يراد به ما جاز مفارقته له .
ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ، ولا أنه ليس غيره . لإن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له ، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو ، إذا كان لفظ الغير فيه إجمال ، فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل : فإن أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها - فهذا غير صحيح ، وان أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة - فهذا حق ، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات ، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها ، وإنما يفرض الذهن ذاتاً وصفة ، كلاً وحده ، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال . ولو لم يكن إلا صفة الوجود، فإنها لا تنفك عن الموجود ، وإن كان الذهن يفرض ذاتاً ووجوداً ، يتصور هذا وحده ، وهذا وحده ، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج .
وقد يقول بعضهم : الصفة لا عين الموصوف ولا غيره . هذا له معنى صحيح ، وهو : أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرها، وليست غير الموصوف ، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد . فاذا قلت : أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الإنفصال بوجه من الوجوه .
وإذا قلت : أعوذ بعزة الله ، فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ، ولم أعذ بغير الله . وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات ، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة ، أي : ذات وجود ، ذات قدرة ، ذات عز، ذات علم ، ذات كرم ، إلى غير ذلك من الصفات . فذات كذا بمعنى صاحبة كذا : تأنيث ذو . هذا أصل معنى الكلمة ، فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه ، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتاً مجردة عن الصفات ، كما يفرض المحال . و[قد] قال صلى الله عليه وسلم : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر . و قال صلى الله عليه وسلم : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله . وكذا قال صلى الله عليه وسلم : اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك . و قال صلى الله عليه وسلم : ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا . و قال صلى الله عليه وسلم : أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات .
وكذلك قولهم : الأسم عين المسمى أو غيره ؟ وطالما غلط كثير من الناس في ذلك ، وجهلو الصواب فيه : فالأسم يراد به المسمى تارة ، [و] يراد به اللفظ الدال عليه أخرى ، فإذا قلت : قال الله كذا ، أو سمع الله لمن حمده ، ونحو ذلك - فهذا المراد به المسمى نفسه ، وإذا قلت : الله إسم عربي ، والرحمن إسم عربي ، والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك - فالأسم ها هنا [هو المراد لا] المسمى ، ولا يقال غيره ، لما في لفظ الغير من الإجمال . : فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق ، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا إسم له ، حتى خلق لنفسه أسماء ، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم - : فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى .
والشيخ رحمه الله أشار بقوله : ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه إلى آخر كلامه - إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة . فإنهم قالوا : إنه تعالى صار قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادراً عليه ، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعاً ، وأنه انقلب من الإمتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي ! وعلي ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما ، فإنهم قالوا : إن الفعل صار ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً منه . وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة ، بل هو شيء واحد لازم لذاته .
وأصل هذا الكلام من الجهمية ، فإنهم قالوا : إن دوام الحوادث ممتنع ، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ ، لامتناع حوادث لا أول لها ، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلاً متكلماً بمشيئة ، بل يمتنع أن يكون قادراً على ذلك ، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة ! وهذا فاسد ، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث ، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاً فلا بد أن يكون ممكناً ، والإمكان ليس له وقت محدود ، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه ، وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه ، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحاً ، فيلزم أنه لم يزل الرب قادراً عليه ، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها .
قالت الجهمية ومن وافقهم : نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له ، لكن نقول ، إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له ، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع ، [بل] يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها ، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه ، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له ، بخلاف جنس الحوادث .
فيقال لهم : هب أنكم تقولون ذلك ، لكن يقال : إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية ، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكناً بعد أن لم يكن ممكناً ، وليس لهذا الإمكان وقت معين ، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله ، فيلزم دوام الإمكان ، وإلا لزم انقلاب الجنس من الإمتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء . ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث ، أو جنس الفعل ، أو جنس الأحداث ، أو ما أشبه هذا من العبارات - من الإمتناع الى الإمكان ، وهو مصير ذلك ممكناً جائزاً بعد أن كان ممتنعاً من غير سبب تجدد ، وهذا ممتنع في صريح العقل ، وهو أيضاً انقلاب الجنس من الإمتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي ، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة ، وهذا الإنقلاب لا يختص بوقت معين ، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله ، فيلزم أنه لم يزل هذا الإنقلاب ممكناً ، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكناً ! وهذا أبلغ في الإمتناع من قولنا : لم يزل الحادث ممكناً ، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه ! فإنه يعقل كون الحادث ممكناً ، ويعقل ، أن هذا الإمكان لم يزل ، وأما كون الممتنع ممكناً فهو ممتنع في نفسه ، فكيف إذا قيل : لم يزل إمكان هذا الممتنع ؟! وهذا مبسوط في موضعه .
فالحاصل : أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا ؟ أو في المستقبل فقط ؟ أو الماضي فقط ؟
فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم :
أضعفها : قول من يقول ، لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل ، كقول جهم بن صفوان وأبي الهديل العلاف .
وثانيها قول من يقول : يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم .
والثالث : قول من يقول : يمكن دوامها في الماضي والمستقبل ، كما يقوله أئمة الحديث ، هي [من] المسائل الكبار. ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل .
ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون : إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن ، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم :
ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارناً لفاعله لم يزل ولا يزال معه - ممتنع [محال] ، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء ، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء . فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال ، يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء . قال تعالى : قال كذلك الله يفعل ما يشاء . وقال تعالى : ولكن الله يفعل ما يريد . وقال تعالى : ذو العرش المجيد * فعال لما يريد . وقال تعالى : ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله . وقال تعالى : قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً .
والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود ، وحينئذ فإذا كان النوع دائماً فالممكن والإكيل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه .
وأما دوام الفعل فهو أيضاً من الكمال ، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال .
قالوا : والتسلسل لفظ مجمل ، لم يرد بنفيه ولا اثباته كتاب ولا سنة ، ليجب مراعاة لفظه ، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن : فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته ، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية .
والتسلسل الواجب : ما دل عليه العقل والشرع ، من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد ، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيماً آخر لا نفاد له ، وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل ، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر ، فهذا واجب في كلامه ، فإنه لم يزل متكلماً إذا شاء ، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت ، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته ، فإن كل حي فعال ، والفرق بين الحي والميت : الفعل ، ولهذا قال غير واحد من السلف : الحي الفعال ، وقال عثمان بن سعيد : كل حي فعال ، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلاً عن كماله ، من الكلام والإرادة والفعل .
وأما التسلسل الممكن : فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف ، كما تتسلسل في طرف الأبد ، فإنه إذا لم يزل حياً قادراً مريداً متكلماً ، وذلك من لوازم ذاته - فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له ، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل ، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه ، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدماً لا أول له ، فلكل مخلوق أول ، والخالق سبحانه لا أول له ، فهو وحده الخالق ، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن .
قالوا : وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه ، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادراً على الفعل لزمه أحد أمرين ، لا بد له منهما : أما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكناً ، وأما أن يقول لم يزل واقعاً ، وإلا تناقض تناقضاً بيناً ، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادراً على الفعل ، والفعل محال ممتنع لذاته ، لو أراده لم يمكن وجوده ، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له . وهذا قول ينقض بعضه بعضاً .
والمقصود : أن الذي دل عليه الشرع والعقل ، أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن . أما كون الرب تعالى لم يزل معطلاً عن الفعل ثم فعل ، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته ، بل كلاهما يدل على نقيضه .
وقد أورد أبو المعالي في ارشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي ، فقالوا : إنك لو قلت : لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهماً ، كان هذا ممكناً ، ولو قلت : لا أعطيك درهماً حتى أعطيك قبله درهماً ، كان هذا ممتنعاً .
وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة ، بل الموازنة الصحيحة أن تقول : ما أعطيتك درهماً الا أعطيتك قبله درهماً ، فتجعل ماضياً قبل ماض ، كما جعلت هناك مستقبلاً بعد مستقبل . وأما قول القائل : لا أعطيك حتى أعطيك قبله ، فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله . فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل ، وهذا ممتنع . أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض ، فإن هذا ممكن . والعطاء المستقبل ابتداؤه من المستقبل . والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له ، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع .
وحول الحوادث بالرب تعالى ، المنفي في علم الكلام المذموم ، لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة ، وفيه إجمال : فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة لشيء من مخلوقاته المحدثة ، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن - فهذا نفي صحيح . وإن أريد [به] نفي الصفات الإختيارية ، من أنه لا يفعل ما يريد ، ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والإستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته - فهذا نفي باطل .
وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث ، فيسلم السني للمتكلم ذلك ، على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله ، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الإختيارية وصفات الفعل ، وهو [غير] لازم له . وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل ، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه .
وكذلك مسألة الصفة : هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل ، وكذلك لفظ الغير، فيه إجمال ، فقد يراد [به] ما ليس هو إياه ، وقد يراد به ما جاز مفارقته له .
ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ، ولا أنه ليس غيره . لإن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له ، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو ، إذا كان لفظ الغير فيه إجمال ، فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل : فإن أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها - فهذا غير صحيح ، وان أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة - فهذا حق ، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات ، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها ، وإنما يفرض الذهن ذاتاً وصفة ، كلاً وحده ، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال . ولو لم يكن إلا صفة الوجود، فإنها لا تنفك عن الموجود ، وإن كان الذهن يفرض ذاتاً ووجوداً ، يتصور هذا وحده ، وهذا وحده ، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج .
وقد يقول بعضهم : الصفة لا عين الموصوف ولا غيره . هذا له معنى صحيح ، وهو : أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرها، وليست غير الموصوف ، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد . فاذا قلت : أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الإنفصال بوجه من الوجوه .
وإذا قلت : أعوذ بعزة الله ، فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ، ولم أعذ بغير الله . وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات ، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة ، أي : ذات وجود ، ذات قدرة ، ذات عز، ذات علم ، ذات كرم ، إلى غير ذلك من الصفات . فذات كذا بمعنى صاحبة كذا : تأنيث ذو . هذا أصل معنى الكلمة ، فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه ، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتاً مجردة عن الصفات ، كما يفرض المحال . و[قد] قال صلى الله عليه وسلم : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر . و قال صلى الله عليه وسلم : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله . وكذا قال صلى الله عليه وسلم : اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك . و قال صلى الله عليه وسلم : ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا . و قال صلى الله عليه وسلم : أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات .
وكذلك قولهم : الأسم عين المسمى أو غيره ؟ وطالما غلط كثير من الناس في ذلك ، وجهلو الصواب فيه : فالأسم يراد به المسمى تارة ، [و] يراد به اللفظ الدال عليه أخرى ، فإذا قلت : قال الله كذا ، أو سمع الله لمن حمده ، ونحو ذلك - فهذا المراد به المسمى نفسه ، وإذا قلت : الله إسم عربي ، والرحمن إسم عربي ، والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك - فالأسم ها هنا [هو المراد لا] المسمى ، ولا يقال غيره ، لما في لفظ الغير من الإجمال . : فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق ، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا إسم له ، حتى خلق لنفسه أسماء ، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم - : فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى .
والشيخ رحمه الله أشار بقوله : ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه إلى آخر كلامه - إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة . فإنهم قالوا : إنه تعالى صار قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادراً عليه ، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعاً ، وأنه انقلب من الإمتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي ! وعلي ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما ، فإنهم قالوا : إن الفعل صار ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً منه . وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة ، بل هو شيء واحد لازم لذاته .
وأصل هذا الكلام من الجهمية ، فإنهم قالوا : إن دوام الحوادث ممتنع ، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ ، لامتناع حوادث لا أول لها ، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلاً متكلماً بمشيئة ، بل يمتنع أن يكون قادراً على ذلك ، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة ! وهذا فاسد ، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث ، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاً فلا بد أن يكون ممكناً ، والإمكان ليس له وقت محدود ، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه ، وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه ، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحاً ، فيلزم أنه لم يزل الرب قادراً عليه ، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها .
قالت الجهمية ومن وافقهم : نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له ، لكن نقول ، إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له ، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع ، [بل] يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها ، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه ، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له ، بخلاف جنس الحوادث .
فيقال لهم : هب أنكم تقولون ذلك ، لكن يقال : إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية ، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكناً بعد أن لم يكن ممكناً ، وليس لهذا الإمكان وقت معين ، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله ، فيلزم دوام الإمكان ، وإلا لزم انقلاب الجنس من الإمتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء . ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث ، أو جنس الفعل ، أو جنس الأحداث ، أو ما أشبه هذا من العبارات - من الإمتناع الى الإمكان ، وهو مصير ذلك ممكناً جائزاً بعد أن كان ممتنعاً من غير سبب تجدد ، وهذا ممتنع في صريح العقل ، وهو أيضاً انقلاب الجنس من الإمتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي ، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة ، وهذا الإنقلاب لا يختص بوقت معين ، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله ، فيلزم أنه لم يزل هذا الإنقلاب ممكناً ، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكناً ! وهذا أبلغ في الإمتناع من قولنا : لم يزل الحادث ممكناً ، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه ! فإنه يعقل كون الحادث ممكناً ، ويعقل ، أن هذا الإمكان لم يزل ، وأما كون الممتنع ممكناً فهو ممتنع في نفسه ، فكيف إذا قيل : لم يزل إمكان هذا الممتنع ؟! وهذا مبسوط في موضعه .
فالحاصل : أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا ؟ أو في المستقبل فقط ؟ أو الماضي فقط ؟
فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم :
أضعفها : قول من يقول ، لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل ، كقول جهم بن صفوان وأبي الهديل العلاف .
وثانيها قول من يقول : يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم .
والثالث : قول من يقول : يمكن دوامها في الماضي والمستقبل ، كما يقوله أئمة الحديث ، هي [من] المسائل الكبار. ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل .
ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون : إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن ، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم :
ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارناً لفاعله لم يزل ولا يزال معه - ممتنع [محال] ، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء ، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء . فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال ، يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء . قال تعالى : قال كذلك الله يفعل ما يشاء . وقال تعالى : ولكن الله يفعل ما يريد . وقال تعالى : ذو العرش المجيد * فعال لما يريد . وقال تعالى : ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله . وقال تعالى : قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً .
والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود ، وحينئذ فإذا كان النوع دائماً فالممكن والإكيل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه .
وأما دوام الفعل فهو أيضاً من الكمال ، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال .
قالوا : والتسلسل لفظ مجمل ، لم يرد بنفيه ولا اثباته كتاب ولا سنة ، ليجب مراعاة لفظه ، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن : فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته ، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية .
والتسلسل الواجب : ما دل عليه العقل والشرع ، من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد ، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيماً آخر لا نفاد له ، وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل ، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر ، فهذا واجب في كلامه ، فإنه لم يزل متكلماً إذا شاء ، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت ، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته ، فإن كل حي فعال ، والفرق بين الحي والميت : الفعل ، ولهذا قال غير واحد من السلف : الحي الفعال ، وقال عثمان بن سعيد : كل حي فعال ، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلاً عن كماله ، من الكلام والإرادة والفعل .
وأما التسلسل الممكن : فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف ، كما تتسلسل في طرف الأبد ، فإنه إذا لم يزل حياً قادراً مريداً متكلماً ، وذلك من لوازم ذاته - فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له ، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل ، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه ، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدماً لا أول له ، فلكل مخلوق أول ، والخالق سبحانه لا أول له ، فهو وحده الخالق ، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن .
قالوا : وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه ، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادراً على الفعل لزمه أحد أمرين ، لا بد له منهما : أما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكناً ، وأما أن يقول لم يزل واقعاً ، وإلا تناقض تناقضاً بيناً ، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادراً على الفعل ، والفعل محال ممتنع لذاته ، لو أراده لم يمكن وجوده ، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له . وهذا قول ينقض بعضه بعضاً .
والمقصود : أن الذي دل عليه الشرع والعقل ، أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن . أما كون الرب تعالى لم يزل معطلاً عن الفعل ثم فعل ، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته ، بل كلاهما يدل على نقيضه .
وقد أورد أبو المعالي في ارشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي ، فقالوا : إنك لو قلت : لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهماً ، كان هذا ممكناً ، ولو قلت : لا أعطيك درهماً حتى أعطيك قبله درهماً ، كان هذا ممتنعاً .
وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة ، بل الموازنة الصحيحة أن تقول : ما أعطيتك درهماً الا أعطيتك قبله درهماً ، فتجعل ماضياً قبل ماض ، كما جعلت هناك مستقبلاً بعد مستقبل . وأما قول القائل : لا أعطيك حتى أعطيك قبله ، فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله . فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل ، وهذا ممتنع . أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض ، فإن هذا ممكن . والعطاء المستقبل ابتداؤه من المستقبل . والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له ، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع .
 عدد المشاهدات *:
عدد المشاهدات *:
871146
 عدد مرات التنزيل *:
عدد مرات التنزيل *:
131340
 حجم الخط :
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 25/12/2012 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 25/12/2012