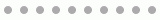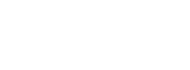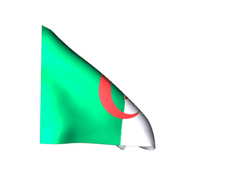ش : المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية . وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة . وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون ، وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين ، وأهل الحديث ، وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة .
وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها ، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون ، وتنافس المتنافسون ، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون ، وعن بابه مردودون .
وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة* إلى ربها ناظرة . وهي من أظهر الأدلة . وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلاً - : فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب ، أسهل من تأويلها على أرباب التأويل . ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص .
وهذا الذي أفسد الدنيا والدين . وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل ، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم . وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم ، وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية . فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد ؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل ، وصفين ، ومقتل الحسين ، والحرة ؟ وهل خرجت الخوارج ، واعتزلت المعتزلة ، ورفضت الروافض ، وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ، إلا بالتأويل الفاسد؟ !
وإضافة النظر إلى الوجه ، الذي هو محله ، في هذه الآية ، وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين ، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله .
فإن النظر له عدة استعمالات ، بحسب صلاته وتعديه بنفسه : فإن عدي بنفسه فمعناه : التوقف والإنتظار : انظرونا نقتبس من نوركم . وإن عدي بـ في فمعناه : التفكر والإعتبار ، كقوله : أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض . وإن عدي بـ إلى فمعناه : المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى : انظروا إلى ثمره إذا أثمر . فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة قال : من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة ، قال في وجه الله عز وجل . عن الحسن قال : نظرت إلى ربها فنضرت بنوره . وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ، [ إلى ربها ناظرة قال : تنظر إلى وجه ربها عز وجل . وقال عكرمة : وجوه يومئذ ناضرة ، قال : من النعيم ، إلى ربها ناظرة ، قال : تنظر إلى ربها نظراً ، ثم حكى عن ابن عباس مثله] . وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث . وقال تعالى : لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد . قال الطبري : قال علي بن أبي طالب و أنس بن مالك : هو النظر إلى وجه الله عز وجل . وقال تعالى : للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، فالحسنى : الجنة ، والزيادة : هي النظر إلى وجهه الكريم ، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده ، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب ، قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار، نادى مناد : يا أهل الجنة ، إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه ، فيقولون : ما هو ؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ فيكشف الحجاب ، فينظرون إليه ، فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر اليه ، وهي الزيادة . ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر ، معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل . وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم . روى ابن جرير [ذلك] عن جماعة ، منهم : أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، و حذيفة ، و أبو موسى الاشعري ، و ابن عباس ، رضي الله عنهم .
وقال تعالى : كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة ، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي . وقال الحاكم : حدثنا الأصم حدثنا الربيع ابن سليمان قال : حضرت محمد بن إدريس الشافعي ، وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : ما تقول في قول الله عز وجل : كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ؟ فقال الشافعي : لما أن حجب هؤلاء في السخط ، كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى .
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : لن تراني ، وبقوله تعالى : لا تدركه الأبصار - فالآيتان دليل عليهم :
أما الآية الأولى : فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه : أحدها : أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته - أن يسأل ما لا يجوز عليه ، بل هو عندهم من أعظم المحال . الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله ، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله ، وقال : إني أعظك أن تكون من الجاهلين . الثالث : أنه تعالى قال : لن تراني ، ولم يقل : اني لا أرى ، أو لا تجوز رؤيتي ، أو لست بمرئي . والفرق بين الجوابين ظاهر . ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاماً فقال : أطعمنيه ، فالجواب الصحيح : أنه لا يؤكل ، أما إذا كان طعاماً صح أن يقال : إنك لن تأكله . وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي ، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار ، لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى . يوضحه : الوجه الرابع : وهو قوله : ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني . فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف ؟ الخامس : أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقراً ، وذلك ممكن ، وقد علق به الرؤية ، ولو كانت محالاً لكان نظير أن يقول : إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام . والكل عندهم سواء . السادس : قوله تعالى : فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً ، فإذا جاز أن يتجلى للجبل ، الذي هو جماد لاثواب له ولا عقاب ، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار، فالبشر أضعف . السابع : أن الله كلم موسى وناداه وناجاه ، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة - فرؤيته أولى بالجواز . ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه ، وقد جمعوا بينهما . وأما دعواهم تأييد النفي بـ لن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة - : ففاسد ، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت ؟ قال تعالى : ولن يتمنوه أبداً ، مع قوله : ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك . ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها ، وقد جاء ذلك ، قال تعالى : فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي . فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد .
قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله :
ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعضدا
وأما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف ، وهو : أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح ، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية ، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به ، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياً ، كمدحه بنفي السنة والنوم ، المتضمن كمال القيومية ، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة ، ونفي اللغوب والإعياء ، المتضمن كمال القدرة ، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير ، المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره ، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه ، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه ، ونفي الظلم ، المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه ، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه ، المتضمن كمال علمه وإحاطته ، ونفي المثل ، المتضمن لكمال ذاته وصفاته . ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتياً ، فإن المعدم يشارك الموصوف في ذلك العدم ، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه ، فإن المعنى : أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به ، فقوله : لا تدركه الأبصار ، يدل على كمال عظمته ، وأنه أكبر من كل شيء ، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به ، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء ، وهو قدر زائد على الرؤية ، كما قال تعالى : فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون * قال كلا ، فلم ينف موسى الرؤية ، وإنما نفى الإدراك ، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه ، فالرب تعالى يرى ولا يدرك ، كما يعلم ولا يحاط به علماً ، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية ، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية . بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه .
وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، الدالة على الرؤية فمتواترة ، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن . فمنها : حديث أبي هريرة : أن ناساً قالوا : يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله ، قال : هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا ، قال فإنكم ترونه كذلك ، الحديث ، أخرجاه في الصحيحين بطوله . وحديث أبي سعيد الخدري أيضاً في الصحيحين نظيره . وحديث جرير بن عبد الله البجلي ، قال : كنا جلوساً مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة ، فقال : إنكم سترون ربكم عياناً ، كما ترون هذا ، لا تضامون في رؤيته ، الحديث أخرجاه في الصحيحين . وحديث صهيب المتقدم ، رواه مسلم وغيره . وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : وجنتان من فضة ، آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب ، آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ، أخرجاه في الصحيحين . ومن حديث عدي بن حاتم : وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ، وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ، فيقول : ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك ؟ فيقول : بلى يا رب ، فيقول : ألم أعطك مالاً وأفضل عليك ؟ فيقول ، بلى يا رب . أخرجه البخاري في صحيحه .
وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياً . ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها ، ولولا أني التزمت الأختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث .
ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية ، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء ، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة ، وأنه فوق العالم ، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ، وأنه يتجلى لعباده ، وأنه يضحك ، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق . وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله ؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ، الذين نزل القرآن بلغتهم ؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم : من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار . وفي رواية : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار . وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى : وفاكهة وأباً . ما الأب ؟ فقال : أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني ، إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ؟
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله ، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية ، لا تشبيه المرئي بالمرئي ، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه . وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟ ومن قال : يرى لا في جهة - فليراجع عقله ! ! فإما أن يكون مكابراً لعقله وفي عقله شيء ، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته ، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة .
ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية ، وقالوا : كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة ، وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا ، لا لامتناع الرؤية ، فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها ، لا لامتناع في ذات المرئي ، بل لعجز الرائي ، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته . ولهذا لما تجلى الله للجبل : خر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ، بأنه لا يراك حي إلا مات ، ولا يابس إلا تدهده ، ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته ، إلا من أيده الله كما أيد نبينا ، قال تعالى : وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر . قال غير واحد من السلف : لا يطيقون أن يروا الملك في صورته ، فلو أنزلنا عليهم ملكاً لجعلناه في صورة بشر ، وحينئذ يشتبه عليهم : هل هو بشر أو ملك ؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولاً منا .
وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه . لكن قول من أثبت موجوداً يرى لا في جهة - أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجوداً قائماً بنفسه لا يرى ولا في جهة .
ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة : أتريد بالجهة أمراً وجودياً ؟ أو أمراً عدمياً ؟ فإن أراد بها أمراً وجودياً كان التقرير : كل ما ليس في شيء موجود لا يرى ، وهذه المقدمة ممنوعة ، ولا دليل على إثباتها ، بل هي باطلة ، فإن سطح العالم يمكن أن يرى، وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمراً عدمياً ، فالمقدمة الثانية ممنوعة ، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار .
وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة ، وإنما يتلقاه من قول فلان ؟! وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ، ولا ينظر فيها، ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان ، المنقول إلينا عن الثقات النقلة ، الذين تخيرهم النقاد، فانهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده ، بل نقلوا نظمه ومعناه ، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان ، بل يتعلمونه بمعانيه . ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه ، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب ، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ ، لكن إن أصاب يضاعف أجره .
وقوله : والرؤية حق لأهل الجنة ، تخصيص أهل الجنة بالذكر، يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم . ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة ، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة ، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويدل عليه قوله تعالى : تحيتهم يوم يلقونه سلام . واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا يراه إلا المؤمنون . الثاني : يراه أهل الموقف ، مؤمنهم وكافرهم ، ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك . الثالث : يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار . وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف .
واتفقت الأمه على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة : منهم من نفى رؤيته بالعين ، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم . وحكى القاضي عياض في كتابه الشفا اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم ، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ، وأنها قالت لمسروق حين سألها : هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : لقد قف شعري مما قلت ، ثم قالت : من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب . ثم قال : وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها ، وهو المشهور عن ابن مسعود و أبي هريرة واختلف عنه ، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه ، وروى عطاء عنه : أنه رآه بقلبه . ثم ذكر أقوالاً وفوائد ، ثم قال : وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص ، والمعول فيه على آيتي النجم ، والتنازع فيهما مأثور ، والاحتمال لهما ممكن ، وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق ، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة ، إذ لو لم تكن ممكنة ، لما سألها موسى عليه السلام ، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية ، وهو ما رواه مسلم في صحيحه ، عن أبي ذر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ فقال : نور أنى أراه . و في رواية : رأيت نوراً . وقد روى مسلم أيضاً عن أبي موس الاشعري رضي الله عنه أنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات ، فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه النور ، ( وفي رواية : النار ) ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . فيكون - والله أعلم - معنى قوله لأبي ذر رأيت نوراً : أنه رأى الحجاب ، ومعنى قوله نور أنى أراه . النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته ، فأنى أراه ؟ أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته ؟ فهذا صريح في نفي الرؤية . والله أعلم .
وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك ، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى ، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى ، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة .
وقوله : بغير إحاطة ولا كيفية - هذا لكمال عظمته وبهائه ، سبحانه وتعالى ، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به ، كما يعلم ولا يحاط به علماً . قال تعالى : لا تدركه الأبصار . وقال تعالى : ولا يحيطون به علماً .
وقوله : وتفسيره على ما أراد الله وعلمه ، إلى أن قال : لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا . أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية ، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه . فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة ، والفاسد المخالف له . فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ، ولا معه قرينة تقتضيه ، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه ، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره ، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ ، فإن الله أنزل كلامه بياناً وهدىً ، فإذا أراد به خلاف ظاهره ، ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد ، لم يكن بياناً ولا هدىً . فالتأويل إخبار بمراد المتكلم ، لا إنشاء .
وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس ، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه ، فإذا قيل : معنى اللفظ كذا وكذا ، كان إخباراً بالذي عنى المتكلم ، فإن لم يكن الخبر مطابقاً كان كذباً على المتكلم ، ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة : منها : أن يصرح بإرادة ذلك المعنى . ومنها : أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى ، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له ، كقوله : وكلم الله موسى تكليماً . و إنكم ترون ربكم عياناً كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب . فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم ، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة ، كان صادقاً في إخباره . وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه ، فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه ، وهو تأويل بالرأي ، وتوهم بالهوى .
وحقيقة الأمر : أن قول القائل : نحمله على كذا ، أو : نتأوله بكذا ، إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له ، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده ، دفع معناه ، وقال : أحمله على خلاف ظاهره .
فإن قيل : بل للحمل معنى آخر، لم تذكروه ، وهو : أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ، ولا يمكن تعطيله ، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد ، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء .
قيل : فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده ، وهو إما صدق وإما كذب ، كما تقدم ، ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده ، بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة ، ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره ، إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك ، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده ! كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز، ويكرره غير مرة ، ويضرب له الامثال .
وقوله : فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه . أي : سلم لنصوص الكتاب والسنة، ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة ، أو بقوله : العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل ! والعقل أصل النقل ! ! فإذا عارضه قدمنا العقل ! ! وهذا لا يكون قط . لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك : فان كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول ، ولو حقق النظر لظهر ذلك . وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبداً . ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره ، فيقال : اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل ، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ، ورفعهما رفع النقيضين ، وتقديم العقل ممتنع ، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل ، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل ، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الاشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه ، فلا يجوز تقديمه . وهذا بين واضح ، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته ، وأن خبره مطابق لمخبره ، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلًا صحيحاً ، وإذا لم يكن دليلاً صحيحاً لم يجز أن يتبع بحال ، فضلاً عن أن يقدم ، فصار تقديم العقل على النقل قدحاً في العقل .
فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم ، والإنقياد لأمره ، وتلقي خبره بالقبول والتصديق ، دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولاً ، أو نحمله شبهة أو شكاً ، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم ، فنوحده بالتحكيم والتسليم والإنقياد والإذعان ، كما نوحد المرسل بالعبادة والخصوع والذل والإنابة والتوكل .
فهما توحيدان ، لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما : توحيد المرسل ، وتوحيد متابعة الرسول ، فلا نحاكم الى غيره ، ولا نرضى بحكم غيره ، ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه ، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره ، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره ، وإلا حرفه عن مواضعه ، وسمى تحريفه تأويلاً وحملاً ، فقال : نؤوله ونحمله . فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب - ما خلا الإشراك بالله - خير له من أن يلقاه بهذه الحال . بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه ؟ ! بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله ، من غير التفات إلى سواه ، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان ، بل يستشكل الآراء لقوله ، ولا يعارض نصه بقياس ، بل نهدر الأقيسة ، ونتلقى نصوصه ، ولا نحرف كلامه عن حقيقته ، لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول ، وعن الصواب معزول ! ولا يوفق قبول قوله على موافقة فلان دون فلان ، كائناً من كان .
قال الإمام أحمد : حدثنا أنس بن عياض ، حدثنا أبو حازم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : لقد جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حمر النعم ، أقبلت أنا وأخي ، وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه ، فكرهنا أن نفرق بينهم ، فجلسنا حجرة ، إذ ذكروا آية من القران ، فتماروا فيها ، حتى ارتفعت أصواتهم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضباً ، قد احمر وجهه ، يرميهم بالتراب ، ويقول : مهلًا يا قوم ! بهذا أهلكت الأمم من قبلكم ، باختلافهم على أنبيائهم ، وضربهم الكتب بعضها ببعض ، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً ، بل يصدق بعضه بعضاً ، فما عرفتم منه فاعملوا به ، وما جهلتم منه فردوه الى عالمه .
ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم ، قال تعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . وقال تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم . فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله ، وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه ، فيصدق بأنه حق وصدق ، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه ، فإن وافقه فهو حق ، وإن خالفه فهو باطل ، وان لم يعلم : هل خالفه أو وافقه - يكون ذلك الكلام مجملاً لا يعرف مراد صاحبه ، أوقد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه - فإنه يمسك عنه ، ولا يتكلم إلا بعلم ، والعلم ما قام عليه الدليل ، والنافع منه ما جاء به الرسول ، وقد يكون علم من غير الرسول ، لكن في الأمور الدنيوية ، مثل الطب والحساب والفلاحة ، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية ، فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير
وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها ، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون ، وتنافس المتنافسون ، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون ، وعن بابه مردودون .
وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة* إلى ربها ناظرة . وهي من أظهر الأدلة . وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلاً - : فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب ، أسهل من تأويلها على أرباب التأويل . ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص .
وهذا الذي أفسد الدنيا والدين . وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل ، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم . وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم ، وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية . فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد ؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل ، وصفين ، ومقتل الحسين ، والحرة ؟ وهل خرجت الخوارج ، واعتزلت المعتزلة ، ورفضت الروافض ، وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ، إلا بالتأويل الفاسد؟ !
وإضافة النظر إلى الوجه ، الذي هو محله ، في هذه الآية ، وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين ، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله .
فإن النظر له عدة استعمالات ، بحسب صلاته وتعديه بنفسه : فإن عدي بنفسه فمعناه : التوقف والإنتظار : انظرونا نقتبس من نوركم . وإن عدي بـ في فمعناه : التفكر والإعتبار ، كقوله : أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض . وإن عدي بـ إلى فمعناه : المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى : انظروا إلى ثمره إذا أثمر . فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة قال : من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة ، قال في وجه الله عز وجل . عن الحسن قال : نظرت إلى ربها فنضرت بنوره . وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ، [ إلى ربها ناظرة قال : تنظر إلى وجه ربها عز وجل . وقال عكرمة : وجوه يومئذ ناضرة ، قال : من النعيم ، إلى ربها ناظرة ، قال : تنظر إلى ربها نظراً ، ثم حكى عن ابن عباس مثله] . وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث . وقال تعالى : لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد . قال الطبري : قال علي بن أبي طالب و أنس بن مالك : هو النظر إلى وجه الله عز وجل . وقال تعالى : للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، فالحسنى : الجنة ، والزيادة : هي النظر إلى وجهه الكريم ، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده ، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب ، قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار، نادى مناد : يا أهل الجنة ، إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه ، فيقولون : ما هو ؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ فيكشف الحجاب ، فينظرون إليه ، فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر اليه ، وهي الزيادة . ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر ، معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل . وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم . روى ابن جرير [ذلك] عن جماعة ، منهم : أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، و حذيفة ، و أبو موسى الاشعري ، و ابن عباس ، رضي الله عنهم .
وقال تعالى : كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة ، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي . وقال الحاكم : حدثنا الأصم حدثنا الربيع ابن سليمان قال : حضرت محمد بن إدريس الشافعي ، وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : ما تقول في قول الله عز وجل : كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ؟ فقال الشافعي : لما أن حجب هؤلاء في السخط ، كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى .
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : لن تراني ، وبقوله تعالى : لا تدركه الأبصار - فالآيتان دليل عليهم :
أما الآية الأولى : فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه : أحدها : أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته - أن يسأل ما لا يجوز عليه ، بل هو عندهم من أعظم المحال . الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله ، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله ، وقال : إني أعظك أن تكون من الجاهلين . الثالث : أنه تعالى قال : لن تراني ، ولم يقل : اني لا أرى ، أو لا تجوز رؤيتي ، أو لست بمرئي . والفرق بين الجوابين ظاهر . ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاماً فقال : أطعمنيه ، فالجواب الصحيح : أنه لا يؤكل ، أما إذا كان طعاماً صح أن يقال : إنك لن تأكله . وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي ، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار ، لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى . يوضحه : الوجه الرابع : وهو قوله : ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني . فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف ؟ الخامس : أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقراً ، وذلك ممكن ، وقد علق به الرؤية ، ولو كانت محالاً لكان نظير أن يقول : إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام . والكل عندهم سواء . السادس : قوله تعالى : فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً ، فإذا جاز أن يتجلى للجبل ، الذي هو جماد لاثواب له ولا عقاب ، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار، فالبشر أضعف . السابع : أن الله كلم موسى وناداه وناجاه ، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة - فرؤيته أولى بالجواز . ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه ، وقد جمعوا بينهما . وأما دعواهم تأييد النفي بـ لن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة - : ففاسد ، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت ؟ قال تعالى : ولن يتمنوه أبداً ، مع قوله : ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك . ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها ، وقد جاء ذلك ، قال تعالى : فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي . فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد .
قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله :
ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعضدا
وأما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف ، وهو : أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح ، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية ، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به ، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياً ، كمدحه بنفي السنة والنوم ، المتضمن كمال القيومية ، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة ، ونفي اللغوب والإعياء ، المتضمن كمال القدرة ، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير ، المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره ، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه ، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه ، ونفي الظلم ، المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه ، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه ، المتضمن كمال علمه وإحاطته ، ونفي المثل ، المتضمن لكمال ذاته وصفاته . ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتياً ، فإن المعدم يشارك الموصوف في ذلك العدم ، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه ، فإن المعنى : أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به ، فقوله : لا تدركه الأبصار ، يدل على كمال عظمته ، وأنه أكبر من كل شيء ، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به ، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء ، وهو قدر زائد على الرؤية ، كما قال تعالى : فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون * قال كلا ، فلم ينف موسى الرؤية ، وإنما نفى الإدراك ، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه ، فالرب تعالى يرى ولا يدرك ، كما يعلم ولا يحاط به علماً ، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية ، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية . بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه .
وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، الدالة على الرؤية فمتواترة ، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن . فمنها : حديث أبي هريرة : أن ناساً قالوا : يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله ، قال : هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا ، قال فإنكم ترونه كذلك ، الحديث ، أخرجاه في الصحيحين بطوله . وحديث أبي سعيد الخدري أيضاً في الصحيحين نظيره . وحديث جرير بن عبد الله البجلي ، قال : كنا جلوساً مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة ، فقال : إنكم سترون ربكم عياناً ، كما ترون هذا ، لا تضامون في رؤيته ، الحديث أخرجاه في الصحيحين . وحديث صهيب المتقدم ، رواه مسلم وغيره . وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : وجنتان من فضة ، آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب ، آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ، أخرجاه في الصحيحين . ومن حديث عدي بن حاتم : وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ، وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ، فيقول : ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك ؟ فيقول : بلى يا رب ، فيقول : ألم أعطك مالاً وأفضل عليك ؟ فيقول ، بلى يا رب . أخرجه البخاري في صحيحه .
وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياً . ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها ، ولولا أني التزمت الأختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث .
ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية ، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء ، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة ، وأنه فوق العالم ، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ، وأنه يتجلى لعباده ، وأنه يضحك ، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق . وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله ؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ، الذين نزل القرآن بلغتهم ؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم : من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار . وفي رواية : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار . وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى : وفاكهة وأباً . ما الأب ؟ فقال : أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني ، إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ؟
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله ، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية ، لا تشبيه المرئي بالمرئي ، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه . وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟ ومن قال : يرى لا في جهة - فليراجع عقله ! ! فإما أن يكون مكابراً لعقله وفي عقله شيء ، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته ، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة .
ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية ، وقالوا : كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة ، وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا ، لا لامتناع الرؤية ، فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها ، لا لامتناع في ذات المرئي ، بل لعجز الرائي ، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته . ولهذا لما تجلى الله للجبل : خر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ، بأنه لا يراك حي إلا مات ، ولا يابس إلا تدهده ، ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته ، إلا من أيده الله كما أيد نبينا ، قال تعالى : وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر . قال غير واحد من السلف : لا يطيقون أن يروا الملك في صورته ، فلو أنزلنا عليهم ملكاً لجعلناه في صورة بشر ، وحينئذ يشتبه عليهم : هل هو بشر أو ملك ؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولاً منا .
وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه . لكن قول من أثبت موجوداً يرى لا في جهة - أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجوداً قائماً بنفسه لا يرى ولا في جهة .
ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة : أتريد بالجهة أمراً وجودياً ؟ أو أمراً عدمياً ؟ فإن أراد بها أمراً وجودياً كان التقرير : كل ما ليس في شيء موجود لا يرى ، وهذه المقدمة ممنوعة ، ولا دليل على إثباتها ، بل هي باطلة ، فإن سطح العالم يمكن أن يرى، وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمراً عدمياً ، فالمقدمة الثانية ممنوعة ، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار .
وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة ، وإنما يتلقاه من قول فلان ؟! وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ، ولا ينظر فيها، ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان ، المنقول إلينا عن الثقات النقلة ، الذين تخيرهم النقاد، فانهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده ، بل نقلوا نظمه ومعناه ، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان ، بل يتعلمونه بمعانيه . ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه ، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب ، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ ، لكن إن أصاب يضاعف أجره .
وقوله : والرؤية حق لأهل الجنة ، تخصيص أهل الجنة بالذكر، يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم . ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة ، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة ، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويدل عليه قوله تعالى : تحيتهم يوم يلقونه سلام . واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا يراه إلا المؤمنون . الثاني : يراه أهل الموقف ، مؤمنهم وكافرهم ، ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك . الثالث : يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار . وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف .
واتفقت الأمه على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة : منهم من نفى رؤيته بالعين ، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم . وحكى القاضي عياض في كتابه الشفا اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم ، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ، وأنها قالت لمسروق حين سألها : هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : لقد قف شعري مما قلت ، ثم قالت : من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب . ثم قال : وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها ، وهو المشهور عن ابن مسعود و أبي هريرة واختلف عنه ، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه ، وروى عطاء عنه : أنه رآه بقلبه . ثم ذكر أقوالاً وفوائد ، ثم قال : وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص ، والمعول فيه على آيتي النجم ، والتنازع فيهما مأثور ، والاحتمال لهما ممكن ، وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق ، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة ، إذ لو لم تكن ممكنة ، لما سألها موسى عليه السلام ، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية ، وهو ما رواه مسلم في صحيحه ، عن أبي ذر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ فقال : نور أنى أراه . و في رواية : رأيت نوراً . وقد روى مسلم أيضاً عن أبي موس الاشعري رضي الله عنه أنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات ، فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه النور ، ( وفي رواية : النار ) ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . فيكون - والله أعلم - معنى قوله لأبي ذر رأيت نوراً : أنه رأى الحجاب ، ومعنى قوله نور أنى أراه . النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته ، فأنى أراه ؟ أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته ؟ فهذا صريح في نفي الرؤية . والله أعلم .
وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك ، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى ، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى ، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة .
وقوله : بغير إحاطة ولا كيفية - هذا لكمال عظمته وبهائه ، سبحانه وتعالى ، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به ، كما يعلم ولا يحاط به علماً . قال تعالى : لا تدركه الأبصار . وقال تعالى : ولا يحيطون به علماً .
وقوله : وتفسيره على ما أراد الله وعلمه ، إلى أن قال : لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا . أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية ، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه . فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة ، والفاسد المخالف له . فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ، ولا معه قرينة تقتضيه ، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه ، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره ، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ ، فإن الله أنزل كلامه بياناً وهدىً ، فإذا أراد به خلاف ظاهره ، ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد ، لم يكن بياناً ولا هدىً . فالتأويل إخبار بمراد المتكلم ، لا إنشاء .
وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس ، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه ، فإذا قيل : معنى اللفظ كذا وكذا ، كان إخباراً بالذي عنى المتكلم ، فإن لم يكن الخبر مطابقاً كان كذباً على المتكلم ، ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة : منها : أن يصرح بإرادة ذلك المعنى . ومنها : أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى ، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له ، كقوله : وكلم الله موسى تكليماً . و إنكم ترون ربكم عياناً كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب . فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم ، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة ، كان صادقاً في إخباره . وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه ، فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه ، وهو تأويل بالرأي ، وتوهم بالهوى .
وحقيقة الأمر : أن قول القائل : نحمله على كذا ، أو : نتأوله بكذا ، إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له ، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده ، دفع معناه ، وقال : أحمله على خلاف ظاهره .
فإن قيل : بل للحمل معنى آخر، لم تذكروه ، وهو : أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ، ولا يمكن تعطيله ، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد ، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء .
قيل : فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده ، وهو إما صدق وإما كذب ، كما تقدم ، ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده ، بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة ، ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره ، إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك ، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده ! كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز، ويكرره غير مرة ، ويضرب له الامثال .
وقوله : فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه . أي : سلم لنصوص الكتاب والسنة، ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة ، أو بقوله : العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل ! والعقل أصل النقل ! ! فإذا عارضه قدمنا العقل ! ! وهذا لا يكون قط . لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك : فان كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول ، ولو حقق النظر لظهر ذلك . وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبداً . ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره ، فيقال : اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل ، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ، ورفعهما رفع النقيضين ، وتقديم العقل ممتنع ، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل ، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل ، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الاشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه ، فلا يجوز تقديمه . وهذا بين واضح ، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته ، وأن خبره مطابق لمخبره ، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلًا صحيحاً ، وإذا لم يكن دليلاً صحيحاً لم يجز أن يتبع بحال ، فضلاً عن أن يقدم ، فصار تقديم العقل على النقل قدحاً في العقل .
فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم ، والإنقياد لأمره ، وتلقي خبره بالقبول والتصديق ، دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولاً ، أو نحمله شبهة أو شكاً ، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم ، فنوحده بالتحكيم والتسليم والإنقياد والإذعان ، كما نوحد المرسل بالعبادة والخصوع والذل والإنابة والتوكل .
فهما توحيدان ، لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما : توحيد المرسل ، وتوحيد متابعة الرسول ، فلا نحاكم الى غيره ، ولا نرضى بحكم غيره ، ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه ، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره ، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره ، وإلا حرفه عن مواضعه ، وسمى تحريفه تأويلاً وحملاً ، فقال : نؤوله ونحمله . فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب - ما خلا الإشراك بالله - خير له من أن يلقاه بهذه الحال . بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه ؟ ! بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله ، من غير التفات إلى سواه ، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان ، بل يستشكل الآراء لقوله ، ولا يعارض نصه بقياس ، بل نهدر الأقيسة ، ونتلقى نصوصه ، ولا نحرف كلامه عن حقيقته ، لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول ، وعن الصواب معزول ! ولا يوفق قبول قوله على موافقة فلان دون فلان ، كائناً من كان .
قال الإمام أحمد : حدثنا أنس بن عياض ، حدثنا أبو حازم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : لقد جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حمر النعم ، أقبلت أنا وأخي ، وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه ، فكرهنا أن نفرق بينهم ، فجلسنا حجرة ، إذ ذكروا آية من القران ، فتماروا فيها ، حتى ارتفعت أصواتهم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضباً ، قد احمر وجهه ، يرميهم بالتراب ، ويقول : مهلًا يا قوم ! بهذا أهلكت الأمم من قبلكم ، باختلافهم على أنبيائهم ، وضربهم الكتب بعضها ببعض ، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً ، بل يصدق بعضه بعضاً ، فما عرفتم منه فاعملوا به ، وما جهلتم منه فردوه الى عالمه .
ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم ، قال تعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . وقال تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم . فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله ، وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه ، فيصدق بأنه حق وصدق ، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه ، فإن وافقه فهو حق ، وإن خالفه فهو باطل ، وان لم يعلم : هل خالفه أو وافقه - يكون ذلك الكلام مجملاً لا يعرف مراد صاحبه ، أوقد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه - فإنه يمسك عنه ، ولا يتكلم إلا بعلم ، والعلم ما قام عليه الدليل ، والنافع منه ما جاء به الرسول ، وقد يكون علم من غير الرسول ، لكن في الأمور الدنيوية ، مثل الطب والحساب والفلاحة ، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية ، فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير
 عدد المشاهدات *:
عدد المشاهدات *:
899798
 عدد مرات التنزيل *:
عدد مرات التنزيل *:
134166
 حجم الخط :
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 25/12/2012 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 25/12/2012