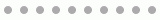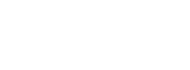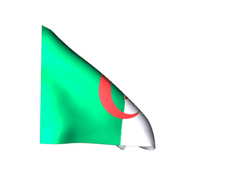فصــل
في مرض القلوب وشفائها
قد ذكرنا في غير موضع: أن صلاح حال الإنسان في العدل، كما أن فساده في الظلم. وأن اللّه ـ سبحانه ـ عدله وسواه لما خلقه، وصحة جسمه وعافيته من اعتدال أخلاطه وأعضائه ومرض ذلك الانحراف والميل.
وكذلك استقامة القلب، واعتداله، واقتصاده، وصحته، وعافيته، وصلاحه متلازمة.
/وقد ذكر اللّه مرض القلوب وشفاءها في مواضع من كتابه وجاء ذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله ـ تعالى ـ عن المنافقين: {فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا} [البقرة: 10]، وقال: {فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم} [المائدة: 52]، وقال تعالى: {وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ . وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} [التوبة: 14، 15]، وقال: {قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ} [يونس: 57]، وقال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء: 82]، وقال تعالى: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ} [فصلت: 44]، وقال تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: 32]، وقال: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ} [الأحزاب: 60]، وقال: {وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا} [الأحزاب: 12].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيِّ السؤال)، وقال الرشيد: الآن شفيتني يا مالك، وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود: أن أحدًا لا يزال بخير ما اتقى اللّه، وإذا شك في تفسير شيء سأل رجلًا فشفاه، وأوشك ألا يجده والذي لا إله إلا هو.
وما ذكر اللّه من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها / وحياتها وسمعها وبصرها وعقلها وصممها وبكمها وعماها.
لكن المقصود معرفة مرض القلب فنقول: المرض نوعان:
فساد الحس.
وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادية.
وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب، فكما أنه مع صحة الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل اللذة والنعمة، فكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب؛ ولهذا كانت النعمة من النعيم، وهو ما ينعم اللّه به على عباده، مما يكون فيه لذة ونعيم، وقال: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8]، أي: عن شكره.
فسبب اللذة إحساس الملائم، وسبب الألم إحساس المنافي، ليس اللذة والألم نفس الإحساس والإدراك، وإنما هو نتيجته وثمرته ومقصوده وغايته، فالمرض فيه ألم لابد منه وإن كان قد يسكن أحيانًا لمعارض راجح، فالمقتضى له قائم يهيج بأدنى سبب، فلابد في المرض من وجود سبب الألم، وإنما يزول الألم بوجود المعارض الراجح.
ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه، أعني ألمه ولذته النفسانيتان، / وإن كان قد يحصل فيه من الألم من جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب مرض الجسم، فذلك شيء آخر.
فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه، أعظم من مرض الجسم وشفائه، فتارة يكون من جملة الشبهات. كما قال: {فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ}، وكما صنف الخرائطي كتاب [اعتلال القلوب بالأهواء] ففي قلوب المنافقين: المرض من هذا الوجه، ومن هذا الوجه: من جهة فساد الاعتقادات، وفساد الإرادات.
والمظلوم في قلبه مرض وهو الألم الحاصل بسبب ظلم الغير له، فإذا استوفى حقه اشتفى قلبه. كما قال تعالى: {وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ . وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} [التوبة: 14، 15]، فإن غيظ القلب إنما هو لدفع الأذي والألم عنه، فإذا اندفع عنه الأذى واستوفى حقه زال غيظه.
فكما أن للإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولايبصر بعينه ولا ينطق بلسانه كان ذلك مرضًا مؤلمًا له يفوته من المصالح ويحصل له من المضار، فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل، ولم يميز بين الخير والشر، والغي والرشاد، كان ذلك من أعظم أمراض قلبه وألمه، وكما أنه إذا اشتهى ما يضره مثل الطعام الكثير في الشهوة الكلية، ومثل أكل الطين ونحوه كان ذلك مرضًا، فإنه يتألم حتى يزول ألمه/ بهذا الأكل الذي يوجد ألمًا أكثر من الأول، فهو يتألم إن أكل، ويتألم إن لم يأكل.
فكذلك إذا بلي بحب من لا ينفعه العشق، ونحوه سواء كان لصورة أو لرئاسة أو لمال ونحو ذلك، فإن لم يحصل محبوبه ومطلوبه فهو متألم ومريض سقيم، وإن حصل محبوبه فهو أشد مرضًا وألمًا وسقمًا، ولذلك كما أن المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه من الطعام والشراب، كان ذلك الألم حاصلًا، وكان دوامه على ذلك يوجب من الألم أكثر من ذلك حتى يقتله، حتى يزول ما يوجب بغضه لما ينفعه ويحتاج إليه، فهو متألم في الحال، وتألمه فيما بعد ـ إن لم يعافهِ اللّه ـ أعظم وأكبر.
فبغض الحاسد لنعمة اللّه على المحسود، كبغض المريض لأكل الأصحاء لأطعمتهم وأشربتهم، حتى لا يقدر أن يراهم يأكلون، ونفرته عن أن يقوم بحقه كنفرة المريض عما يصلح له من طعام وشراب، فالحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة في الجسم، وعمى القلب وبكمه أن يبصر الحقائق ويميز ما ينفعه ويضره، كعمى الجسم، وخرسه عن أن يبصر الأمور المرتبة، ويتكلم بها ويميز بين ما ينفعه ويضره.
وكما أن الضرير إذا أبصر وجد أن الراحة والعافية والسرور أمرًا / عظيمًا. فبصر القلب ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت ما لا يحصيه إلا اللّه، وإنما الغرض هنا تشبيه أحد المرضين بالآخر، فطب الأديان يحتذى حذو طب الأبدان.
وقد كتب سليمان إلى أبي الدرداء: أما بعد: فقد بلغني أنك قعدت طبيبًا، فإياك أن تقتل، واللّه أنزل كتابه شفاء لما في الصدور. وقال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} [الإسراء: 82]، ذلك أن الشفاء إنما يحصل لمن يتعمد الدواء، وهم المؤمنون وضعوا دواء القرآن على داء قلوبهم.
فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة، والنفرة الطبيعية عن الاعتدال، أما شهوة ما لا يحصل أو يفقد الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما يضر، ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة، كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال، وهي الأهواء التي قال اللّه فيها: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ} [القصص: 50]، وقال: {بَلْ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الروم: 29].
كما يكون الجسد خارجًا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب، ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه ويصلح له، وكما أن المرضى الجهال قد يتناولون ما يشتهون، فلا / يحتمون ولا يصبرون على الأدوية الكريهة لما في ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذة، ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما يعظم قدره، أو يعجل الهلاك.
فكذلك بنو آدم هم جهال ظلموا أنفسهم، يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته ويترك ما تكرهه نفسه، مما هو لا يصلح له، فيعقبهم ذلك من الألم والعقوبات، إما في الدنيا وإما في الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الأعظم.
والتقوى: هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه، فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع، وأما استعمال النافع فقد يكون معه أيضًا استعمالًا لضار، فلا يكون صاحبه من المتقين.
وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكون؛ فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتذيًا بما معه من المواد التي تضره حتى يهلك؛ ولهذا كانت العاقبة للتقوى، وللمتقين؛ لأنهم المحتمون عما يضرهم فعاقبتهم الإسلام والكرامة، وإن وجدوا ألمًا في الابتداء لتناول الدواء والاحتماء، كفعل الأعمال الصالحة المكروهة. كما قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ} [البقرة: 216].
ولكثرة الأعمال الباطلة المشتهاة، كما قال تعالى: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات: 40، 41]. وكما قال: {وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ} [الأنفال: 7]، فأما من لم يحتم فإن ذلك سبب لضرره في العاقبة، ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط، فهو أصلح ممن احتمى حمية كاملة ولم يتناول الأشياء سرًا، فإن الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض، فهكذا من ترك السيئات ولم يفعل الحسنات.
وقد قدمنا في قاعدة كبيرة أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات، كما أن جنس الاغتذاء من جنس الاحتماء، وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذلك مقصود لغيره بالانضمام إلى غيره، وكما أن الواجب الاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله، وإزالته بعد حصوله، فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتها ـ بأن عرض له المرض ـ دوامًا، والصحة تحفظ بالمثل، والمرض يزول بالضد، فصحة القلب تحفظ باستعمال أمثال ما فيها، أو هو ما يقوي العلم والإيمان من الذكر والتفكر والعبادات المشروعة، وتزول بالضد، فتزال الشبهات بالبينات، وتزال محبة الباطل ببغضه ومحبة الحق.
ولهذا قال يحيى بن عمار: العلوم خمسة: فعلم هو حياة الدنيا، وهو علم التوحيد، وعلم هو غذاء الدين، وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث، وعلم هو دواء الدين، وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من/ يشفيه منها، كما قال ابن مسعود: وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث، وعلم هو هلاك الدين، وهو علم السحر ونحوه.
فحفظ الصحة بالمثل، وإزالة المرض بالضد، في مرض الجسم الطبيعي، ومرض القلب النفساني الديني الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يُهَوِّدَانِه أو يُنَصِّرَانه أو يُمَجِّسَانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء) ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30]، أخرجاه في الصحيـحين. قال اللّه تعالى: {وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} إلى قوله: {بَلْ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} إلى قوله: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [الروم: 26ـ30].
فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفًا، وهو عبادة اللّه وحده لا شريك له، فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب، وتركها ظلم عظيم اتبع أهله أهواءهم بغير علم، ولابد لهذه الفطرة والخلقة ـ وهي صحة الخلقة ـ من قوت وغذاء يمدها بنظير ما فيها مما فطرت عليه علمًا وعملًا؛ ولهذا كان تمام الدين بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة، وهي مأدبة اللّه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: (إن كل آدب يحب أن /تؤتي مأدبته، وإن مأدبة اللّه هي القرآن)، ومثله كماء أنزله اللّه من السماء، كما جرى تمثيله بذلك في الكتاب والسنة. والمحرفون للفطرة المغيرون للقلب عن استقامته، هم ممرضون القلوب مسقمون لها، وقد أنزل اللّه كتابه شفاء لما في الصدور.
وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هي بمنزلة ما تصيب الجسم من الألم، يصح بها الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر اللّه بها خطاياه)، وذلك تحقيق لقوله: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123].
ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض فيؤب صحيحًا، وإلا احتاج أن يطهر منها في الآخرة فيعذبه اللّه. كالذي اجتمعت فيه أخلاطه، ولم يستعمل الأدوية لتخفيفها عنه فتجتمع حتى يكون هلاكه بها؛ ولهذا جاء في الأثر: (إذا قالوا للمريض: اللّهم ارحمه، يقول اللّه: كيف أرحمه من شيء به أرحمه؟!)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (المرض حطة، يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها).
وكما أن أمراض الجسم ما إذا مات الإنسان منه كان شهيدًا. كالمطعون والمبطون وصاحب ذات الجَنْب، وكذلك الميت بغرق، أو حرق، أو هدم، فمن / أمراض النفس، ما إذا اتقى العبد ربه فيه وصبر عليه حتى مات كان شهيدًا، كالجبان الذي يتقى اللّه ويصبر للقتال حتى يقتل، فإن البخل والجبن من أمراض النفوس إن أطاعه أوجب له الألم، وإن عصاه تألم كأمراض الجسم.
وكذلك العشق، فقد روى: (من عشق فعف وكتم وصبر، ثم مات مات شهيدًا) فإنه مرض في النفس، يدعو إلى ما يضر النفس، كما يدعو المريض إلى تناول ما يضر. فإن أطاع هواه عظم عذابه في الأخرة وفي الدنيا أيضًا، وإن عصى الهوى بالعفة والكتمان صار في نفسه من الألم والسقم ما فيها، فإذا مات من ذلك المرض كان شهيدًا، هذا يدعوه إلى النار فيمنعه كالجبان تمنعه نفسه عن الجنة فيقدمها.
فهذه الأمراض إذا كان معها إيمان وتقوى كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقضي اللّه للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له إن أصابته سراء فشكر، كان خيرًا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له).
والحمد للّه رب العالمين، وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا.
في مرض القلوب وشفائها
قد ذكرنا في غير موضع: أن صلاح حال الإنسان في العدل، كما أن فساده في الظلم. وأن اللّه ـ سبحانه ـ عدله وسواه لما خلقه، وصحة جسمه وعافيته من اعتدال أخلاطه وأعضائه ومرض ذلك الانحراف والميل.
وكذلك استقامة القلب، واعتداله، واقتصاده، وصحته، وعافيته، وصلاحه متلازمة.
/وقد ذكر اللّه مرض القلوب وشفاءها في مواضع من كتابه وجاء ذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله ـ تعالى ـ عن المنافقين: {فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا} [البقرة: 10]، وقال: {فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم} [المائدة: 52]، وقال تعالى: {وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ . وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} [التوبة: 14، 15]، وقال: {قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ} [يونس: 57]، وقال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء: 82]، وقال تعالى: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ} [فصلت: 44]، وقال تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: 32]، وقال: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ} [الأحزاب: 60]، وقال: {وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا} [الأحزاب: 12].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيِّ السؤال)، وقال الرشيد: الآن شفيتني يا مالك، وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود: أن أحدًا لا يزال بخير ما اتقى اللّه، وإذا شك في تفسير شيء سأل رجلًا فشفاه، وأوشك ألا يجده والذي لا إله إلا هو.
وما ذكر اللّه من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها / وحياتها وسمعها وبصرها وعقلها وصممها وبكمها وعماها.
لكن المقصود معرفة مرض القلب فنقول: المرض نوعان:
فساد الحس.
وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادية.
وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب، فكما أنه مع صحة الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل اللذة والنعمة، فكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب؛ ولهذا كانت النعمة من النعيم، وهو ما ينعم اللّه به على عباده، مما يكون فيه لذة ونعيم، وقال: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8]، أي: عن شكره.
فسبب اللذة إحساس الملائم، وسبب الألم إحساس المنافي، ليس اللذة والألم نفس الإحساس والإدراك، وإنما هو نتيجته وثمرته ومقصوده وغايته، فالمرض فيه ألم لابد منه وإن كان قد يسكن أحيانًا لمعارض راجح، فالمقتضى له قائم يهيج بأدنى سبب، فلابد في المرض من وجود سبب الألم، وإنما يزول الألم بوجود المعارض الراجح.
ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه، أعني ألمه ولذته النفسانيتان، / وإن كان قد يحصل فيه من الألم من جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب مرض الجسم، فذلك شيء آخر.
فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه، أعظم من مرض الجسم وشفائه، فتارة يكون من جملة الشبهات. كما قال: {فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ}، وكما صنف الخرائطي كتاب [اعتلال القلوب بالأهواء] ففي قلوب المنافقين: المرض من هذا الوجه، ومن هذا الوجه: من جهة فساد الاعتقادات، وفساد الإرادات.
والمظلوم في قلبه مرض وهو الألم الحاصل بسبب ظلم الغير له، فإذا استوفى حقه اشتفى قلبه. كما قال تعالى: {وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ . وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} [التوبة: 14، 15]، فإن غيظ القلب إنما هو لدفع الأذي والألم عنه، فإذا اندفع عنه الأذى واستوفى حقه زال غيظه.
فكما أن للإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولايبصر بعينه ولا ينطق بلسانه كان ذلك مرضًا مؤلمًا له يفوته من المصالح ويحصل له من المضار، فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل، ولم يميز بين الخير والشر، والغي والرشاد، كان ذلك من أعظم أمراض قلبه وألمه، وكما أنه إذا اشتهى ما يضره مثل الطعام الكثير في الشهوة الكلية، ومثل أكل الطين ونحوه كان ذلك مرضًا، فإنه يتألم حتى يزول ألمه/ بهذا الأكل الذي يوجد ألمًا أكثر من الأول، فهو يتألم إن أكل، ويتألم إن لم يأكل.
فكذلك إذا بلي بحب من لا ينفعه العشق، ونحوه سواء كان لصورة أو لرئاسة أو لمال ونحو ذلك، فإن لم يحصل محبوبه ومطلوبه فهو متألم ومريض سقيم، وإن حصل محبوبه فهو أشد مرضًا وألمًا وسقمًا، ولذلك كما أن المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه من الطعام والشراب، كان ذلك الألم حاصلًا، وكان دوامه على ذلك يوجب من الألم أكثر من ذلك حتى يقتله، حتى يزول ما يوجب بغضه لما ينفعه ويحتاج إليه، فهو متألم في الحال، وتألمه فيما بعد ـ إن لم يعافهِ اللّه ـ أعظم وأكبر.
فبغض الحاسد لنعمة اللّه على المحسود، كبغض المريض لأكل الأصحاء لأطعمتهم وأشربتهم، حتى لا يقدر أن يراهم يأكلون، ونفرته عن أن يقوم بحقه كنفرة المريض عما يصلح له من طعام وشراب، فالحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة في الجسم، وعمى القلب وبكمه أن يبصر الحقائق ويميز ما ينفعه ويضره، كعمى الجسم، وخرسه عن أن يبصر الأمور المرتبة، ويتكلم بها ويميز بين ما ينفعه ويضره.
وكما أن الضرير إذا أبصر وجد أن الراحة والعافية والسرور أمرًا / عظيمًا. فبصر القلب ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت ما لا يحصيه إلا اللّه، وإنما الغرض هنا تشبيه أحد المرضين بالآخر، فطب الأديان يحتذى حذو طب الأبدان.
وقد كتب سليمان إلى أبي الدرداء: أما بعد: فقد بلغني أنك قعدت طبيبًا، فإياك أن تقتل، واللّه أنزل كتابه شفاء لما في الصدور. وقال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} [الإسراء: 82]، ذلك أن الشفاء إنما يحصل لمن يتعمد الدواء، وهم المؤمنون وضعوا دواء القرآن على داء قلوبهم.
فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة، والنفرة الطبيعية عن الاعتدال، أما شهوة ما لا يحصل أو يفقد الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما يضر، ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة، كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال، وهي الأهواء التي قال اللّه فيها: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ} [القصص: 50]، وقال: {بَلْ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الروم: 29].
كما يكون الجسد خارجًا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب، ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه ويصلح له، وكما أن المرضى الجهال قد يتناولون ما يشتهون، فلا / يحتمون ولا يصبرون على الأدوية الكريهة لما في ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذة، ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما يعظم قدره، أو يعجل الهلاك.
فكذلك بنو آدم هم جهال ظلموا أنفسهم، يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته ويترك ما تكرهه نفسه، مما هو لا يصلح له، فيعقبهم ذلك من الألم والعقوبات، إما في الدنيا وإما في الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الأعظم.
والتقوى: هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه، فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع، وأما استعمال النافع فقد يكون معه أيضًا استعمالًا لضار، فلا يكون صاحبه من المتقين.
وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكون؛ فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتذيًا بما معه من المواد التي تضره حتى يهلك؛ ولهذا كانت العاقبة للتقوى، وللمتقين؛ لأنهم المحتمون عما يضرهم فعاقبتهم الإسلام والكرامة، وإن وجدوا ألمًا في الابتداء لتناول الدواء والاحتماء، كفعل الأعمال الصالحة المكروهة. كما قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ} [البقرة: 216].
ولكثرة الأعمال الباطلة المشتهاة، كما قال تعالى: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات: 40، 41]. وكما قال: {وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ} [الأنفال: 7]، فأما من لم يحتم فإن ذلك سبب لضرره في العاقبة، ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط، فهو أصلح ممن احتمى حمية كاملة ولم يتناول الأشياء سرًا، فإن الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض، فهكذا من ترك السيئات ولم يفعل الحسنات.
وقد قدمنا في قاعدة كبيرة أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات، كما أن جنس الاغتذاء من جنس الاحتماء، وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذلك مقصود لغيره بالانضمام إلى غيره، وكما أن الواجب الاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله، وإزالته بعد حصوله، فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتها ـ بأن عرض له المرض ـ دوامًا، والصحة تحفظ بالمثل، والمرض يزول بالضد، فصحة القلب تحفظ باستعمال أمثال ما فيها، أو هو ما يقوي العلم والإيمان من الذكر والتفكر والعبادات المشروعة، وتزول بالضد، فتزال الشبهات بالبينات، وتزال محبة الباطل ببغضه ومحبة الحق.
ولهذا قال يحيى بن عمار: العلوم خمسة: فعلم هو حياة الدنيا، وهو علم التوحيد، وعلم هو غذاء الدين، وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث، وعلم هو دواء الدين، وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من/ يشفيه منها، كما قال ابن مسعود: وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث، وعلم هو هلاك الدين، وهو علم السحر ونحوه.
فحفظ الصحة بالمثل، وإزالة المرض بالضد، في مرض الجسم الطبيعي، ومرض القلب النفساني الديني الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يُهَوِّدَانِه أو يُنَصِّرَانه أو يُمَجِّسَانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء) ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30]، أخرجاه في الصحيـحين. قال اللّه تعالى: {وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} إلى قوله: {بَلْ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} إلى قوله: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [الروم: 26ـ30].
فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفًا، وهو عبادة اللّه وحده لا شريك له، فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب، وتركها ظلم عظيم اتبع أهله أهواءهم بغير علم، ولابد لهذه الفطرة والخلقة ـ وهي صحة الخلقة ـ من قوت وغذاء يمدها بنظير ما فيها مما فطرت عليه علمًا وعملًا؛ ولهذا كان تمام الدين بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة، وهي مأدبة اللّه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: (إن كل آدب يحب أن /تؤتي مأدبته، وإن مأدبة اللّه هي القرآن)، ومثله كماء أنزله اللّه من السماء، كما جرى تمثيله بذلك في الكتاب والسنة. والمحرفون للفطرة المغيرون للقلب عن استقامته، هم ممرضون القلوب مسقمون لها، وقد أنزل اللّه كتابه شفاء لما في الصدور.
وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هي بمنزلة ما تصيب الجسم من الألم، يصح بها الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر اللّه بها خطاياه)، وذلك تحقيق لقوله: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123].
ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض فيؤب صحيحًا، وإلا احتاج أن يطهر منها في الآخرة فيعذبه اللّه. كالذي اجتمعت فيه أخلاطه، ولم يستعمل الأدوية لتخفيفها عنه فتجتمع حتى يكون هلاكه بها؛ ولهذا جاء في الأثر: (إذا قالوا للمريض: اللّهم ارحمه، يقول اللّه: كيف أرحمه من شيء به أرحمه؟!)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (المرض حطة، يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها).
وكما أن أمراض الجسم ما إذا مات الإنسان منه كان شهيدًا. كالمطعون والمبطون وصاحب ذات الجَنْب، وكذلك الميت بغرق، أو حرق، أو هدم، فمن / أمراض النفس، ما إذا اتقى العبد ربه فيه وصبر عليه حتى مات كان شهيدًا، كالجبان الذي يتقى اللّه ويصبر للقتال حتى يقتل، فإن البخل والجبن من أمراض النفوس إن أطاعه أوجب له الألم، وإن عصاه تألم كأمراض الجسم.
وكذلك العشق، فقد روى: (من عشق فعف وكتم وصبر، ثم مات مات شهيدًا) فإنه مرض في النفس، يدعو إلى ما يضر النفس، كما يدعو المريض إلى تناول ما يضر. فإن أطاع هواه عظم عذابه في الأخرة وفي الدنيا أيضًا، وإن عصى الهوى بالعفة والكتمان صار في نفسه من الألم والسقم ما فيها، فإذا مات من ذلك المرض كان شهيدًا، هذا يدعوه إلى النار فيمنعه كالجبان تمنعه نفسه عن الجنة فيقدمها.
فهذه الأمراض إذا كان معها إيمان وتقوى كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقضي اللّه للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له إن أصابته سراء فشكر، كان خيرًا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له).
والحمد للّه رب العالمين، وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا.
 عدد المشاهدات *:
عدد المشاهدات *:
671687
 عدد مرات التنزيل *:
عدد مرات التنزيل *:
295007
 حجم الخط :
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013