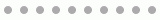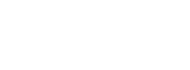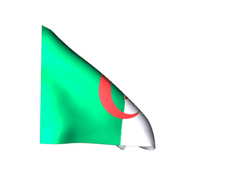والسعادة فى معاملة الخلق: أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم فى الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم فى الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفًا من الله لا منهم، كما جاء فى الأثر: (ارج الله فى الناس ولا ترج الناس فى الله، وخف الله فى الناس ولا تخف الناس فى الله) أى: لا تفعل شيئًا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم، لا رجاء مدحهم ولا خوفًا من ذمهم، بل ارج الله ولا تخفهم فى الله فيما تأتى وما تذر، بل افعل ما أمرت به وإن كرهوه. وفى الحديث: (إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله، أو تَذُمَّهُمْ على ما لم يؤتك الله) فإن اليقين يتضمن اليقين فى القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا، لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك، إما ميل إلى ما فى أيديهم من الدنيا، فيترك القيام فيهم بأمر الله؛ لما يرجوه منهم. وإما ضعيف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب فى الدنيا والآخرة، فإنك إذا أرضيت الله نصرك، ورزقك وكفاك مؤنتهم، فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم؛ وذلك من ضعف اليقين.
وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك، فالأمر فى ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا ذممتهم على ما لم يقدر، كـان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، لكن من حمده الله ورسوله فهو المحمود، ومن ذمَّه الله ورسوله فهو المذموم.
ولما قال بعض وفد بنى تَمِيم: يا محمد، أعطنى، فإن حَمْدِى زَيْنُ وإن ذَمِّى شَيْنٌ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذاك الله عز وجل)
وكتبت عائشة إلى معاوية، وروى أنها رفعته إلى النبى صلى الله عليه وسلم: (من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يُغْنُوا عنه من الله شيئا) هذا لفظ المرفوع، ولفظ الموقوف: (من أرضى الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاماً) هذا لفظ المأثور عنها، وهذا من أعظم الفقه فى الدين، والمرفوع أحق وأصدق، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه، وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، وهو كاف عبده {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } [الطلاق: 2، 3]. فالله يكفيه مُؤْنَةَ الناس بلا رَيْب، وأما كون الناس كلهم يرضون عنه، فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه، إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً، كالظالم الذى يعض على يده يقول: {يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا} [الفرقان: 27، 28]، وأما كون حامده ينقلب ذاماً، فهذا يقع كثيراً، ويحصل فى العاقبة، فإن العاقبة للتقوى، لا يحصل ابتداء عند أهوائهم، وهو سبحانه أعلم.
فالتوحيد ضد الشرك، فإذا قام العبد بالتوحيد الذى هو حق الله، فعبده لا يشرك به شيئاً كان موحداً. ومن توحيد الله وعبادته: التوكل عليه والرجاء له، والخوف منه، فهذا يخلص به العبد من الشرك. وإعطاء الناس حقوقهم، وترك العدوان عليهم، يخلص به العبد من ظلمهم، ومن الشرك بهم. وبطاعة ربه واجتناب معصيته، يخلص العبد من ظلم نفسه، وقد قال ـ تعالى ـ فى الحديث القدسى: (قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين). فالنصفان يعود نفعهما إلى العبد، وكما فى الحديث الذى رواه الطبرانى فى الدعاء: (يا عبادى، إنما هى أربع، واحدة لى، وواحدة لك، وواحدة بينى وبينك، وواحدة بينك وبين خلقى، فالتى لى: تعبدنى لا تشرك بى شيئا. والتى لك: عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه. والتى بينى وبينك: فمنك الدعاء وعلىّ الإجابة. والتى بينك وبين خلقى: فأت إليهم ما تحب أن يأتوه إليك). والله يحب النصفين، ويحب أن يعبدوه.
وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداية هو من فضله وإحسانه، وهو وسيلة إلى ذلك المحبوب، وهو إنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته، والعبد يطلب ما يحتاج أولا، وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى الهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العبادة. فهو يطلب ما يحتاج إليه أولا ليتوسل به إلى محبوب الرب، الذى فيه سعادته. وكذلك قوله: (عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه) ، فإنه يحب الثواب الذى هو جزاء العمل، فالعبد إنما يعمل لنفسه، {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286]، ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هى نافعة له، محصلة لسعادته، محصنة له من عذاب ربه فلا يطلب العبد قط إلا ما فيه حظ له، وإن كان الرب يحب ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائم له، فمن عبد الله لا يشرك به شيئًا أحبه وأثابه، فيحصل للعبد ما يحبه من النعم تبعًا لمحبوب الرب، وهذا كالبائع والمشترى، البائع يريد من المشترى أولا الثمن، ومن لوازم ذلك: إرادة تسليم المبيع، والمشترى يريد السلعة، ومن لوازم ذلك: إرادة إعطاء الثمن.
فالرب يحب أن يحب، ومن لوازم ذلك: أن يحب من لا تحصل العبادة إلا به. والعبد يحب ما يحتاج إليه وينتفع به، ومن لوازم ذلك: محبته لعبادة الله، فمن عبد الله وأحسن إلى الناس، فهذا قائم بحقوق الله وحق عباد الله، فى إخلاص الدين له. ومن طلب من العباد العوض، ثناء أو دعاء أو غير ذلك، لم يكن محسنًا إليهم لله. ومن خاف الله فيهم ولم يخفهم فى الله كان محسنًا إلى الخلق وإلى نفسه، فإن خوف الله يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم، ومن خافهم ولم يخف الله فهذا ظالم لنفسه ولهم، حيث خاف غير الله ورجاه؛ لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع شرهم عنه بكل وجه، إما بمداهنتهم ومراءاتهم، وإما بمقابلتهم بشىء أعظم من شرهم أو مثله، وإذا رجاهم لم يقم فيهم بحق الله، وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم، فإن طبع النفس الظلم لمن لا يظلمها فكيف بمن يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق، كثير الظلم إذا قدر، مهين ذليل إذا قهر، فهو يخاف الناس بحسب ما عنده من ذلك، وهذا مما يوقع الفتن بين الناس.
وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه منهم، فلابد أن يبغضهم فيظلمهم إذا لم يكن خائفا من الله عز وجل، وهذا موجود كثيرًا فى الناس، تجدهم يخاف بعضهم بعضًا ويرجو بعضهم بعضًا، وكل من هؤلاء يتظلم من الآخر، ويطلب ظلمه، فهم ظالمون بعضهم لبعض، ظالمون فى حق الله حيث خافوا غيره ورجوا غيره، ظالمون لأنفسهم، فإن هذا من الذنوب التى تعذب النفس بها وعليها، وهو يجر إلى فعل المعاصى المختصة، كالشرك والزنا، فإن الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه، ولاسيما إذا كان طالبًا ما لم يحصل له؛ فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنها، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه، فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور، وذكر مجريات النفس والهزل واللعب، ومخالطة قرناء السوء وغير ذلك، ولا يستغنى القلب إلا بعبادة الله ـ تعالى.
فإن الإنسان خلق محتاجًا إلى جلب ما ينفعه، ودفع ما يضره، ونفسه مريدة دائمًا، ولابد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به، وليس ذلك إلا لله وحده، فلا تطمئن القلوب إلا به، ولا تسكن النفوس إلا إليه، و {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]، فكل مألوه سواه يحصل به الفساد، ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لا شريك له.
فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين، عبدت غيره من الآلهة التى يعبدها أكثر الناس مما رضوه لأنفسهم، فأشركت بالله بعبادة غيره، واستعانته، فتعبد غيره وتستعين به، لجهلها بسـعادتها التى تنالها بـعبادة خالقها والاستعانة به، فبالعبادة له تستغنى عن معبود آخر، وبالاستعانة به تستغنى عن الاستعانة بالخلق، وإذا لم يكن العبد كذلك، كان مذنبًا محتاجًا، وإنما غناه فى طاعة ربه، وهذا حال الإنسان؛ فإنه فقير محتاج، وهو مع ذلك مذنب خطاء، فلابد له من ربه، فإنه الذى يسدى مغافرَهُ، ولابد له من الاستغفار من ذنوبه، قال تعالى:{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ} [محمد:19]، فبالتوحيد يقوى العبد ويستغنى، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، وبالاستغفار يغفر له ويدفع عنه عذابه، {وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الأنفال: 33]، فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد؛ فإنه لابد له منه، وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرًا محتاجًا معذبًا فى طلب ما لم يحصل له، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به، وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار، حصل له غناه وسعادته، وزال عنه ما يعذبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والعبد مفتقر دائما إلى التوكل على الله والاستعانة به، كما هو مفتقر إلى عبادته، فلابد أن يشهد دائمًا فقره إلى الله، وحاجته فى أن يكون معبودًا له، وأن يكون معينًا له، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه، قال تعالى: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ} [آل عمران: 175] أى يخوفكم بأوليائه. هذا هو الصواب الذى عليه الجمهور، كابن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره. قال ابن الأنبارى: والذى نختاره فى الآية: يخوفكم أولياءه. تقول العرب: أعطيت الأموال: أى أعطيت القوم الأموال، فيحذفون المفعول الأول.
قلت: وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفًا مطلقًا، ليس له فى تخويف ناس بناس ضرورة، فحذف الأول لأنه ليس مقصودًا.
وقال بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقين، والأول أظهر؛ لأنها نزلت بسبب تخويفهم من الكفار، فهى إنما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس، وقد قال: {يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ} [آل عمران: 175] الضمير عائد إلى أولياء الشيطان، الذين قال فيهم: {فَاخْشَوْهُمْ} [آل عمران: 173] قبلها، والذى قال الثانى فسرها من جهة المعنى، وهو أن الشيطان إنما يخوف أولياءه؛ لأن سلطانه عليهم، فهو يدخل عليهم المخاوف دائما، وإن كانوا ذوى عَدَدٍ وعُدَدٍ، وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم الكفار، أو أنهم أرادوا المفعول الأول، أى يخوف المنافقين أولياءه، وهو يخوف الكفار، كما يخوف المنافقين، ولو أريد أنه يجعل أولياءه خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه، وهو قوله: {فّلا تّخّافٍوهٍم}.
وأيضًا، فإنه يعد أولياءه وَيُمَنِّيهِمْ، ولكن الكفار يلقى الله فى قلوبهم الرعب من المؤمنين، والشيطان لا يختار ذلك، قال تعالى: {لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ} [الحشر: 13]، وقال: {سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ} [الأنفال: 12]، ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالون العدو فصاروا بذلك منافقين، وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم، كما قال تعالى: وَلَـكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ} [التوبة :56]، وقال: {فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ} الآية [الأحزاب: 19]. فكلا القولين صحيح من حيث المعنى، لكن لفظ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين، كما دل عليه السياق، وإذا جعلهم مخوفين فإنما يخافهم من خوفه الشيطان منهم.
فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين، ويجعل ناسا خائفين منهم.
ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان، ولا يخاف الناس، كما قال: {فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ} [المائدة: 44]، فخوف الله أمر به، وخوف أولياء الشيطان نَهَى عنه، قال تعالى: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي} [البقرة:150]، فنهى عن خَشْيَةِ الظالم وأمر بخشيته، وقال: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ} [الأحزاب: 39]، وقال: {فَإيَّايَ فَارْهَبُونِ} [النحل: 51].
وبعض الناس يقول: يا رب، إنى أخافك وأخاف من لا يخافك، فهذا كلام ساقط لا يجوز، بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدًا، فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف، فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان، فالخوف منه قد نهى الله عنه، وإذا قيل: قد يؤذينى، قيل: إنما يؤذيك بتسليط الله له، وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه، فالأمر لله، وإنما يسلط على العبد بذنوبه، وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر، ولم يسلطه عليك، فإنه قال: {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق:3]، وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه، فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك، كما قال: {وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الأنفال:33].
وفى الآثار: (يقول الله: أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيها بيدى، فمن أطاعنى جعلت قلوب الملوك عليه رحمة، ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسبِّ الملوك، ولكن توبوا إلىَّ وأطيعون أعطفهم عليكم).
ولما سلط الله العدو عـلى الصحابة يوم أحد قال: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ} الآية [آل عمران: 165]، وقال: {وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ} الآيات [آل عمران: 146] والأكثرون يقرؤون: قاتل ـ والربيون الكثير عند جماهير السلف والخلف: هم الجماعات الكثيرة، قال ابن مسعود وابن عباس ـ فى رواية عنه ـ والفراء: ألوف كثيرة. وقال ابن عباس فى أخرى ومجاهد وقتادة: جماعات كثيرة، وقرئ بالحركات الثلاث فى الراء، فعلى هذه القراءة فالربيون الذين قاتلوا معه: الذين ما وهنوا وما ضعفوا. وأما على قراءة أبى عمرو وغيره ففيها وجهان:
أحدهما: يوافق الأول، أى الربيون يقتلون فما وهنوا، أى ما وهن من بقى منهم، لقتل كثير منهم، أى ما ضعفوا لذلك ولا دخلهم خور ولا ذلوا لعدوهم، بل قاموا بأمر الله فى القتال حتى أدَالُهم الله عليهم وصارت كلمة الله هى العليا.
والثانى: أن النبى صلى الله عليه وسلم قتل معه ربيون كثير فما وهن من بقى منهم لقتل النبى صلى الله عليه وسلم. وهذا يناسب صرخ الشيطان أن محمدًا قد قتل، لكن هذا لا يناسب لفظ الآية، فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة ما وهنوا، ولو أريد أن النبى قتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم بل تقليلهم هو المناسب لها، فإذا كثروا لم يكن فى مدحهم بذلك عبرة.
وأيضا، لم يكن فيه حجة على الصحابة، فإنهم يوم أحد قليلون والعدو أضعافهم، فيقولون ولم يهنوا؛ لأنهم ألوف ونحن قليلون.
وأيضًا، فقوله: {وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ} [آل عمران: 146] يقتضى كثرة ذلك، وهذا لا يعرف أن أنبياء كثيرون قتلوا فى الجهاد.
وأيضا: فيقتضى أن المقتولين مع كل واحد منهم ربيون كثير، وهذا لم يوجد، فإن من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يقاتلون، وموسى وأنبياء بنى إسرائيل لم يقتلوا فى الغزو، بل ولا يعرف نبى قتل فى جهاد، فكيف يكون هذا كثيرًا ويكون جيشه كثيرًا؟!
والله ـ سبحانه ـ أنكر على من ينقلب، سواء كان النبى مقتولا أو ميتا، فلم يذمهم إذا مات أو قتل على الخوف بل على الانقلاب على الأعقاب، ولهذا تلاها الصديق رضى الله عنه ـ بعد موته صلى الله عليه وسلم فكأن لم يسمعوها قبل ذلك.
ثم ذكر بعدها معنى آخر: وهو أن من كان قبلكم كانوا يقاتلون فيقتل منهم خلق كثير وهم لا يهنون، فيكون ذكر الكثرة مناسبا؛ لأن من قتل مع الأنبياء كثير، وقتل الكثير من الجنس يقتضى الوهن، فما وهنوا وإن كانوا كثيرين، ولو وهنوا دل على ضعف إيمانهم، ولم يقل هنا: ولم ينقلبوا على أعقابهم، فلو كان المراد أن نبيهم قتل لقال: فانقلبوا على أعقابهم؛ لأنه هو الذى أنكره إذا مات النبى أو قتل، فأنكر سبحانه شيئين: الارتداد إذا مات أو قتل، والوهن والضعف والاستكانة لما أصابهم فى سبيل الله من استيلاء العدو؛ ولهذا قال: {فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ} [آل عمران: 146]... إلخ. ولم يقل: فما وهنوا لقتل النبى، ولو قتل وهم أحياء لذكر ما يناسب ذلك، ولم يقل: {فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ}، ومعلوم أنّ ما يصيب فى سبيل الله فى عامة الغزوات لا يكون قتل نبى.
وأيضًا: فكون النبى قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير، لا يستلزم أن يكون النبى معهم فى الغزاة، بل كل من اتبع النبى وقاتل على دينه فقد قاتل معه، وكذلك كل من قتل على دينه فقد قتل معه، وهذا الذى فهم الصحابة، فإن أعظم قتالهم كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى فتحوا البلاد شامًا، ومصرًا، وعراقًا، ويمنًا وعربًا، وعجمًا، ورومًا، ومغربًا، ومشرقًا، وحينئذ فظهر كثرة من قتل معه، فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون، ويكون فى هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة، فإنهم كلهم يقاتلون مع النبى صلى الله عليه وسلم على دينه، وإن كان قد مات، والصحابة الذين يغزون فى السرايا، والنبى ليس معهم، كانوا معه يقاتلون، وهم داخلون فى قوله: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ} الآية [الفتح: 29]، وفى قوله: {وَالَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ} الآية [الأنفال: 75]. ليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون مشاهدًا للمطاع ناظرًا إليه.
وقد قيل فى: {ربيون} هنا: إنهم العلماء، فلما جعل هؤلاء هذا كلفظ الربانى، وعن ابن زيد هم الأتباع كأنه جعلهم المربوبين. والأول أصح من وجوه:
أحدها: أن الربانيين عين الأحبار، وهم الذين يربون الناس، وهم أئمتهم فى دينهم، ولا يكون هؤلاء إلا قليلاً.
الثانى: أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم، وأصحاب الأنبياء لم يكونوا كلهم ربانيين، وإن كانوا قد أعطوا علما ومعهم الخوف من الله عز وجل.
الثالث: أن استعمال لفظ الربانى فى هذا ليس معروفا فى اللغة.
الرابع: أن استعمال لفظ الربى فى هذا ليس معروفا فى اللغة، بل المعروف فيها هو الأول، والذين قالوه قالوا: هو نسبة للرب بلا نون والقراءة المشهور [ربى] بالكسر، وما قالوه إنما يتوجه على من قرأه بنصب الراء، وقد قرئ بالضم، فعلم أنها لغات.
الخامس: أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد، سواء كان من الربانيين أو لم يكن.
السادس: أنه لا مناسبة فى تخصيص هؤلاء بالذكر، وإنما المناسب ذكرهم فى مثل قوله: {لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ} الآية [المائدة: 63]. وفى قوله: {وَلَـكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ} [آل عمران: 79] فهناك ذكرهم به مناسبا.
السابع: قيل: إن الربانى منسوب إلى الرب، فزيادة الألف والنون كاللحيانى، وقيل: إلى تربيته الناس، وقيل: إلى ربان السفينة، وهذا أصح، فإن الأصل عدم الزيادة فى النسبة؛ لأنهم منسوبون إلى التربية، وهذه تختص بهم، وأما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك، بل كل عبد له فهو منسوب إليه، إما نسبة عموم أو خصوص ولم يسم الله أولياءه المتقين ربانيين، ولا سمى به رسله وأنبياءه، فإن الربانى من يرب الناس، كما يرب الربانى السفينة، ولهذا كان الربانيون يذمون تارة، ويمدحون أخرى، ولو كانوا منسوبين إلى الرب لم يذموا قط.
الثامن: أنها إن جعلت مدحًا فقد ذموا فى مواضع، وإن لم تكن مدحا لم يكن لهم خاصة يمتازون بها من جهة المدح، وإذا كان منسوبًا إلى ربانى السفينة بطل قول من يجعل الربانى منسوبا إلى الرب، فنسبة الربيون إلى الرب أولى بالبطلان.
التاسع: أنه إذا قدر أنهم منسوبون إلى الرب، فلا تدل النسبة على أنهم علماء. نعم تدل على إيمان وعبادة وتأله، وهذا يعم جميع المؤمنين، فكل من عبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهو متأله عارف بالله، والصحابة كلهم كذلك، ولم يسموا ربانيين ولا ربيين، وإنما جاء أن ابن الحنفية قال لما مات ابن عباس: اليوم مات ربانى هذه الأمة، وذلك لكونه يؤدبهم بما آتاه الله من العلم، والخلفاء أفضل منهم، ولم يسموا ربانيين، وإن كانوا هم الربانيين. وقال إبراهيم: كان علقمة من الربانيين؛ ولهذا قال مجاهد: هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، فهم أهل الأمر والنهى. والأحبار يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدث به وإن لم يأمر، أو ينه، وذلك هو المنقول عن السلف فى الربانى، نقل عن علىّ قال: (هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها) ، وعن ابن عباس قال: [هم الفقهاء المعلمون]
قلت: أهل الأمر والنهى هم الفقهاء المعلمون. وقال قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. قال ابن قتيبة: واحدهم ربانى، وهم العلماء المعلمون. قال أبو عبيد: أحسب الكلمة عبرانية أو سريانية، وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين.
قلت: اللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة الذى ينزلها ويقوم لمصلحتها، ولكن العرب فى جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون؛ لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله عز وجل.
 عدد المشاهدات *:
عدد المشاهدات *:
705330
 عدد مرات التنزيل *:
عدد مرات التنزيل *:
301723
 حجم الخط :
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013