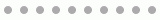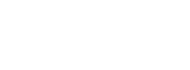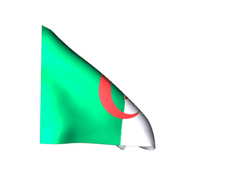فصـــل
وهذا المقام لا أذكر فيه موارد النزاع، فيقال: هو الاستدلال على المختلف بالمختلف، لكن أنا أصف جنس كلامهم، فأقول:
لا ريب أن كلامهم كله منحصر في الحدود التي تفيد التصورات، سواء كانت الحدود حقيقية، أو رسمية أو لفظية، وفي الأقيسة التي تفيد التصديقات، سواء كانت أقيسة عموم وشمول، أو شبه وتمثيل، أو استقراء وتتبع.
وكلامهم غالبه لا يخلو من تكلف، إما في العلم وإما في القول، فإما / أن يتكلفوا علم ما لا يعلمونه، فيتكلمون بغير علم، أو يكون الشيء معلومًا لهم فيتكلفون من بيانه ما هو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق، وهذا من المنكر المذموم في الشرع والعقل، قال تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86]، وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: أيها الناس، من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: لا أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: لا أعلم.
وقد ذم الله القول بغير علم في كتابه، كقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36] لا سيما القول على الله، كقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33] ، وكذلك ذم الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه، وأمر بأن نقول القول السديد والقول البليغ.
وهؤلاء كلامهم في الحدود غالبه من الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه، بل قد يكثر كلامهم في الأقيسة والحجج، كثير منه كذلك، وكثير منه باطل، وهو قول بغير علم، وقول بخلاف الحق.
أما الأول، فإنهم يزعمون أن الحدود التي يذكرونها يفيدون بها تصور الحقائق، وأن ذلك إنما يتم بذكر الصفات الذاتية المشتركة والمميزة، حتى يركب الحد من الجنس المشترك، والفصل المميز. وقد يقولون: إن التصورات / لا تحصل إلا بالحدود، ويقولون: الحدود المركبة لا تكون إلا للأنواع المركبة من الجنس والفصل دون الأنواع البسيطة.
وقد ذكرت في غير هذا الموضع ملخص المنطق ومضمونه، وأشرت إلى بعض ما دخل به على كثير من الناس من الخطأ والضلال، وليس هذا موضع بسط ذلك، لكن نذكر هنا وجوها:
الوجه الأول:
قولهم: إن التصور الذي ليس ببديهي لا ينال إلا بالحد، باطل؛ لأن الحد هو قول الحاد. فإن الحد هنا هو القول الدال على ماهية المحدود. فالمعرفة بالحد لا تكون إلا بعد الحد؛ فإن الحاد الذي ذكر الحد إن كان عرف المحدود بغير حد بطل قولهم: لا يعرف إلا بالحد، وإن كان عرفه بحد آخر، فالقول فيه كالقول في الأول، فإن كان هذا الحاد عرفه بعد الحد الأول، لزم الدور، وإن كان تأخر لزم التسلسل.
/الوجه الثاني:
أنهم إلى الآن لم يسلم لهم حد لشيء من الأشياء إلا ما يدعيه بعضهم وينازعه فيه آخرون. فإن كانت الأصول لا تتصور إلا بالحدود، لزم ألا يكون إلى الآن أحد عرف شيئًا من الأمور، ولم يبق أحد ينتظر صحته؛ لأن الذي يذكره يحتاج إلى معرفة بغير حد وهي متعددة، فلا يكون لبني آدم شيء من المعرفة، وهذه سفسطة ومغالطة.
الوجه الثالث:
أن المتكلمين بالحدود طائفة قليلة في بني آدم، لاسيما الصناعة المنطقية، فإن واضعها هو أرسطو، وسلك خلفه فيها طائفة من بني آدم.
ومن المعلوم أن علوم بني آدم ـ عامتهم وخاصتهم ـ حاصلة بدون ذلك، فبطل قولهم: إن المعرفة متوقفة عليها، أما الأنبياء فلا ريب في استغنائهم عنها، وكذلك أتباع الأنبياء من العلماء والعامة. فإن القرون الثلاثة من هذه الأمة ـ الذين كانوا أعلم بني آدم علومًا ومعارف ـ لم يكن تكلف / هذه الحدود من عادتهم، فإنهم لم يبتدعوها، ولم تكن الكتب الأعجمية الرومية عربت لهم، وإنما حدثت بعدهم من مبتدعة المتكلمين والفلاسفة، ومن حين حدثت صار بينهم من الاختلاف والجهل مالا يعلمه إلا الله.
وكذلك علم [الطب] و [الحساب] وغير ذلك، لا تجد أئمة هذه العلوم يتكلفون هذه الحدود المركبة من الجنس والفصل إلا من خلط ذلك بصناعتهم من أهل المنطق.
وكذلك النحاة مثل سيبويه الذي ليس في العالم مثل كتابه، وفيه حكمة لسان العرب، لم يتكلف فيه حد الاسم والفاعل ونحو ذلك، كما فعل غيره. ولما تكلف النحاة حد الاسم ذكروا حدودًا كثيرة كلها مطعون فيها عندهم . وكذلك ما تكلف متأخروهم من حد الفاعل والمبتدأ والخبر ونحو ذلك، لم يدخل فيها عندهم من هو إمام في الصناعة ولا حاذق فيها.
وكذلك الحدود التي يتكلفها بعض الفقهاء للطهارة والنجاسة، وغير ذلك من معاني الأسماء المتداولة بينهم، وكذلك الحدود التي يتكلفها الناظرون في أصول الفقه لمثل الخبر والقياس والعلم وغير ذلك، لم يدخل فيها إلا من ليس بإمام في الفن، وإلى الساعة لم يسلم لهم حد، وكذلك حدود أهل الكلام.
/فإذا كان حذاق بني آدم في كل فن من العلم أحكموه بدون هذه الحدود المتكلفة، بطل دعوى توقف المعرفة عليها.
وأما علوم بني آدم الذين لا يصنفون الكتب، فهي مما لا يحصيه إلا الله، ولهم من البصائر والمكاشفات والتحقيق والمعارف ما ليس لأهل هذه الحدود المتكلفة، فكيف يجوز أن تكون معرفة الأشياء متوقفة عليها؟
الوجه الرابع:
أن الله جعل لابن آدم من الحس الظاهر والباطن ما يحس به الأشياء ويعرفها، فيعرف بسمعه وبصره وشمه وذوقه ولمسه الظاهر ما يعرف، ويعرف ـ أيضا ـ بما يشهده ويحسه بنفسه وقلبه ما هو أعظم من ذلك. فهذه هي الطرق التي تعرف بها الأشياء . فأما الكلام فلا يتصور أن يعرف بمجرده مفردات الأشياء إلا بقياس تمثيل أو تركيب ألفاظ، وليس شيء من ذلك يفيد تصور الحقيقة.
فالمقصود أن الحقيقة إن تصورها بباطنه أو ظاهره استغنى عن الحد القولي، وإن لم يتصورها بذلك امتنع أن يتصور حقيقتها بالحد القولي، وهذا أمر محسوس يجده الإنسان من نفسه، فإن من عرف المحسوسات المذوقة / ـ مثلًا - كالعسل، لم يفده الحد تصورها. ومن لم يذق ذلك، كمن أخبر عن السكرـ وهو لم يذقه ـ لم يمكن أن يتصور حقيقته بالكلام والحد، بل يمثل له ويقرب إليه، ويقال له: طعمه يشبه كذا، أو يشبه كذا وكذا، وهذا التشبيه والتمثيل ليس هو الحد الذي يدعونه.
وكذلك المحسوسات الباطنة، مثل الغضب والفرح والحزن والغم والعلم ونحو ذلك، من وجدها فقد تصورها، ومن لم يجدها لم يمكن أن يتصورها بالحد؛ ولهذا لا يتصور الأكمه الألوان بالحد، ولا العِنِّين الوقاع بالحد. فإذن القائل بأن الحدود هي التي تفيد تصور الحقائق، قائل للباطل المعلوم بالحس الباطن والظاهر.
الوجه الخامس:
أن الحدود إنما هي أقوال كلية، كقولنا: حيوان ناطق، ولفظ يدل على معنى ونحو ذلك، فتصور معناها لا يمنع من وقوع الشركة فيها، وإن كانت الشركة ممتنعة لسبب آخر، فهي إذن لا تدل على حقيقة معينة بخصوصها، وإنما تدل على معنى كلي. والمعاني الكلية وجودها في الذهن لا في الخارج، فما في الخارج لا يتعين، ولا يعرف بمجرد الحد، وما في الذهن ليس هو حقائق الأشياء، فالحد لا يفيد تصور حقيقة أصلا.
/الوجه السادس:
أن الحد من باب الألفاظ، واللفظ لا يدل المستمع على معناه إن لم يكن قد تصور مفردات اللفظ بغير اللفظ؛ لأن اللفظ المفرد لا يدل المستمع على معناه إن لم يعلم أن اللفظ موضوع للمعنى، ولا يعرف ذلك حتى يعرف المعنى. فتصور المعاني المفردة يجب أن يكون سابقًا على فهم المراد بالألفاظ، فلو استفيد تصورها من الألفاظ لزم الدور، وهذا أمر محسوس؛ فإن المتكلم باللفظ المفرد إن لم يبين للمستمع معناه حتى يدركه بحسه أو بنظره، وإلا لم يتصور إدراكه له بقول مؤلف من جنس وفصل.
الوجه السابع:
أن الحد هو الفصل والتمييز بين المحدود وغيره، يفيد ما تفيده الأسماء من التمييز والفصل بين المسمى وبين غيره، فهذا لا ريب في أنه يفيد التمييز. فأما تصور حقيقة فلا، لكنها قد تفصل ما دل عليه الاسم بالإجمال، وليس ذلك من إدراك الحقيقة في شيء. والشرط في ذلك: أن تكون الصفات ذاتية، بل هو بمنزلة التقسيم والتحديد للكل، كالتقسيم لجزئياته ويظهر ذلك بـ:
/الوجه الثامن:
وهو أن الحس الباطن والظاهر يفيد تصور الحقيقة تصورًا مطلقًا، أما عمومها وخصوصها فهو من حكم العقل؛ فإن القلب يعقل معنى من هذا المعين ومعنى يماثله من هذا المعين، فيصير في القلب معنى عامًا مشتركًا، وذلك هو عقله، أي عقله للمعاني الكلية.
فإذا عقل معنى الحيوانية الذي يكون في هذا الحيوان وهذا الحيوان، ومعنى الناطق الذي يكون في هذا الإنسان وهذا الإنسان، وهو مختص به، عقل أن في نوع الإنسان معنى يكون نظيره في الحيوان، ومعنى ليس له نظير في الحيوان.
فالأول هو الذي يقال له: الجنس . والثاني: الذي يقال له: الفصل . وهما موجودان في النوع.
فهذا حق، ولكن لم يستفد من هذا اللفظ ما لم يكن يعرفه بعقله من أن هذا المعنى عام للإنسان ولغيره من الحيوان، بمعنى أن ما في هذا نظير ما في هذا ؛ إذ ليس في الأعيان الخارجة عموم، وهذا المعنى يختص بالإنسان. فلا فرق بين قولك: الإنسان حيوان ناطق، وقولك: الإنسان هو الحيوان الناطق، إلا من جهة الإحاطة والحصر في الثاني، لا من جهة تصوير / حقيقته باللفظ والإحاطة. والحصر هو التمييز الحاصل بمجرد الاسم، وهو قولك: إنسان وبشر . فإن هذا الاسم إذا فهم مسماه، أفاد من التمييز ما أفاده الحيوان الناطق في سلامته عن المطاعن.
وأما تصور أن فيه معنى عامًا ومعنى خاصًا، فليس هذا من خصائص الحد، كما تقدم. والذي يختص بالحد ليس إلا مجرد التمييز الحاصل بالأسماء. وهذا بين لمن تأمله.
وأما إدراك صفات فيه، بعضها مشترك وبعضها مختص، فلا ريب أن هذا قد لا يتفطن له بمجرد الاسم، لكن هذا يتفطن له بالحد وبغير الحد. فليس في الحد إلا ما يوجد في الأسماء، أو في الصفات التي تذكر للمسمى. وهذان نوعان معروفان:
الأول: معنى الأسماء المفردة.
والثاني: معرفة الجمل المركبة الإسمية والفعلية التي يخبر بها عن الأشياء، وتوصف بها الأشياء.
وكلا هذين النوعين لا يفتقر إلى الحد المتكلف، فثبت أن الحد ليس فيه فائدة إلا وهي موجودة في الأسماء والكلام بلا تكلف، فسقطت فائدة خصوصية الحد.
/الوجه التاسع:
أن العلم بوجود صفات مشتركة ومختصة حق، لكن التمييز بين تلك الصفات بجعل بعضها ذاتيًا تتقوم منه حقيقة المحدود، وبعضها لازمًا لحقيقة المحدود، تفريق باطل، بل جميع الصفات الملازمة للمحدود ـ طردًا وعكسًا ـ هي جنس واحد، فلا فرق بين الفصل والخاصة، ولا بين الجنس والعرض العام.
وذلك أن الحقيقة المركبة من تلك الصفات: إما أن يعني بها الخارجة أو الذهنية أو شيء ثالث. فإن عنى بها الخارجة، فالنطق والضحك في الإنسان حقيقتان لازمتان يختصان به. وإن عنى الحقيقة التي في الذهن، فالذهن يعقل اختصاص هاتين الصفتين به دون غيره.
وإن قيل: بل إحدى الصفتين يتوقف عقل الحقيقة عليها، فلا يعقل الإنسان في الذهن حتى يفهم النطق، وأما الضحك فهو تابع لفهم الإنسان. وهذا معنى قولهم: [الذاتي ما لا يتصور فهم الحقيقة بدون فهمه، أو ما تقف الحقيقة في الذهن والخارج عليه].
/قيل: إدراك الذهن أمر نسبي إضافي، فإن كون الذهن لا يفهم هذا إلا بعد هذا، أمر يتعلق بنفس إدراك الذهن، ليس هو شيئًا ثابتًا للموصوف في نفسه، فلابد أن يكون الفرق بين الذاتي والعرضي بوصف ثابت في نفس الأمر، سواء حصل الإدراك له أو لم يحصل، إن كان أحدهما جزءًا للحقيقة دون الآخر وإلا فلا.
الوجه العاشر:
أن يقال: كون الذهن لا يعقل هذا إلا بعد هذا، إن كان إشارة إلى أذهان معينة، وهي التي تصورت هذا، لم يكن هذا حجة ؛ لأنهم هم وضعوها هكذا. فيكون التقدير: أن ما قدمناه في أذهاننا على الحقيقة فهو الذاتي، وما أخرناه فهو العرضي. ويعود الأمر إلى أنا تحكمنا بجعل بعض الصفات ذاتيًا وبعضها عرضيًا لازمًا وغير لازم، وإن كان الأمر كذلك، كان هذا الفرقان مجرد تحكم بلا سلطان. ولا يستنكر من هؤلاء أن يجمعوا بين المفترقين ويفرقوا بين المتماثلين. فما أكثر هذا في مقاييسهم التي ضلوا بها وأضلوا . وهم أول من أفسد دين المسلمين، وابتدع ما غير به الصابئة مذاهب أهل الإيمان المهتدين.
وإن قالوا: بل جميع أذهان بني آدم ـ والأذهان الصحيحة ـ لا تدرك الإنسان / إلا بعد خطور نطقه ببالها دون ضحكه.
قيل لهم: ليس هذا بصحيح، ولا يكاد يوجد هذا الترتيب إلا فيمن يقلد عنكم هذه الحدود من المقلدين لكم في الأمور التي جعلتموها ميزان المعقولات، وإلا فبنو آدم قد لا يخطر لأحدهم أحد الوصفين، وقد يخطر له هذا دون هذا وبالعكس، ولو خطر له الوصفان وعرف أن الإنسان حيوان ناطق ضاحك، لم يكن بمجرد معرفته هذه الصفات مدركًا لحقيقة الإنسان أصلًا، وكل هذا أمر محسوس معقول.
فلا يغالط العاقل نفسه في ذلك لهيبة التقليد لهؤلاء، الذين هم من أكثر الخلق ضلالًا مع دعوى التحقيق، فهم في الأوائل كمتكلمة الإسلام في الأواخر. ولما كان المسلمون خيرًا من أهل الكتابين والصابئين، كانوا خيرًا منهم وأعلم وأحكم، فتدبر هذا فإنه نافع جدًا.
ومن هنا يقولون: الحدود الذاتية عسرة، وإدراك الصفات الذاتية صعب، وغالب ما بأيدي الناس حدود رسمية؛ وذلك كله لأنهم وضعوا تفريقًا بين شيئين بمجرد التحكم الذي هم أدخلوه.
ومن المعلوم أن ما لا حقيقة له في الخارج ولا في المعقول، وإنما هو ابتداع مبتدع وضعه، وفرق به بين المتماثلين فيما تماثلا فيه ـ لا تعقله القلوب / الصحيحة ـ إذ ذاك من باب معرفة المذاهب الفاسدة التي لا ضابط لها، وأكثر ما تجد هؤلاء الأجناس يعظمونه من معارفهم ويدعون اختصاص فضلائهم به، هو من الباطل الذي لا حقيقة له، كما نبهنا على هذا فيما تقدم.
الوجه الحادي عشر:
قولهم: الحقيقة مركبة من الجنس والفصل، والجنس هو الجزء المشترك والفصل هو الجزء المميز.
يقال لهم: هذا التركيب، إما أن يكون في الخارج أو في الذهن. فإن كان في الخارج فليس في الخارج نوع كلي يكون محدودًا بهذا الحد إلا الأعيان المحسوسة، والأعيان في كل عين صفة يكون نظيرها لسائر الحيوانات كالحس والحركة الإرادية، وصفة ليس مثلها لسائر الحيوان وهي النطق. وفي كل عين يجتمع هذان الوصفان، كما يجتمع سائر الصفات والجواهر القائمة لأمور مركبة من الصفات المجعولة فيها.
وإن أردتم بالحيوانية والناطقية جوهرًا، فليس في الإنسان جوهران، أحدهما حي، والآخر ناطق، بل هو جوهر واحد له صفتان. فإن كان / الجوهر مركبًا من عرضين، لم يصح. وإن كان من جوهر عام وخاص فليس فيه ذلك، فبطل كون الحقيقة الخارجة مركبة.
وإن جعلوها تارة جوهرًا وتارة صفة، كان ذلك بمنزلة قول النصارى في الأقانيم، وهو من أعظم الأقوال تناقضًا باتفاق العلماء.
وإن قالوا: المركب الحقيقية الذهنية المعقولة، قيل ـ أولا: تلك ليست هي المقصودة بالحدود، إلا أن تكون مطابقة للخارج، فإن لم يكن هناك تركيب لم يصح أن يكون في هذه تركيب، وليس في الذهن إلا تصور الحي الناطق. وهو جوهر واحد له صفتان، كما قدمنا، فلا تركيب فيه بحال.
واعلم أنه لا نزاع أن صفات الأنواع والأجناس منها ما هو مشترك بينها وبين غيرها، كالجنس والعرض العام، ومنها ما هو لازم للحقيقة، ومنها ما هو عارض لها، وهو ما ثبت لها في وقت دون وقت كالبطىء الزوال وسريعه، وإنما الشأن في التفريق بين الذاتي والعرضي اللازم، فهذا هو الذي مداره على تحكم ذهن الحاد.
ولا تنازع في أن بعض الصفات قد يكون أظهر وأشرف، فإن النطق أشرف من الضحك، ولهذا ضرب اللّه به المثل في قوله: {إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ}[الذاريات: 23]، ولكن الشأن في جعل هذا ذاتيًا تتصور به الحقيقة دون الآخر.
/الوجه الثاني عشر:
أن هذه الصفات الذاتية قد تعلم ولا يتصور بها كنه المحدود، كما في هذا المثال وغيره، فعلم أن ذلك ليس بموجب لفهم الحقيقة.
الوجه الثالث عشر:
أن الحد إذا كان له جزءان، فلابد لجزأيه من تصور، كالحيوان والناطق، فإن احتاج كل جزء إلى حد، لزم التسلسل أو الدور.
فإن كانت الأجزاء متصورة بنفسها بلا حد ـ وهو تصور الحيوان، أو الحساس، أو المتحرك بالإرادة، أو النامي، أو الجسم ـ فمن المعلوم أن هذه أعم. وإذا كانت أعم لكون إدراك الحس لأفرادها أكثر، فإن كان إدراك الحس لأفرادها كافيًا في التصور فالحس قد أدرك أفراد النوع . وإن لم يكن كافيًا في ذلك لم تكن الأجزاء معروفة، فيحتاج المعرف إلى معرف، وأجزاء الحد إلى حد.
/الوجه الرابع عشر:
أن الحدود لابد فيها من التمييز، وكلما قلت الأفراد كان التمييز أيسر، وكلما كثرت كان أصعب، فضبط العقل الكلي تقل أفراده مع ضبط كونه كليًا أيسر عليه مما كثرت أفراده، وإن كان إدراك الكلى الكثير الأفراد أيسر عليه، فذاك إذا أدركه مطلقًا؛ لأن المطلق يحصل بحصول كل واحد من الأفراد.
وإذا كان ذلك كذلك، فأقل ما في أجزاء المحدود أن تكون متميزة تمييزًا كليًا ؛ ليعلم كونها صفة للمحدود أو محمولة عليه أم لا . فإذا كان ضبطها كلية أصعب وأتعب من ضبط أفراد المحدود، كان ذلك تعريفًا للأسهل معرفة بالأصعب مفردة، وهذا عكس الواجب.
الوجه الخامس عشر:
أن الله ـ سبحانه ـ علَّم آدم الأسماء كلها، وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك، ويخصه دون ما سواه، ويبين به ما يرسم معناه / في النفس. ومعرفة حدود الأسماء واجبة ؛ لأنه بها تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي جعله الله رحمة لهم، لاسيما حدود ما أنزل الله في كتبه من الأسماء كالخمر والربا.
فهذه الحدود هي الفاصلة المميزة بين ما يدخل في المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما دل عليه من الصفات، وبين ما ليس كذلك؛ ولهذا ذم الله من سمى الأشياء بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فإنه أثبت للشيء صفة باطلة كإلهية الأوثان.
فالأسماء النطقية سمعية، وأما نفس تصور المعاني ففطري، يحصل بالحس الباطن والظاهر، وبإدراك الحس وشهوده ببصر الإنسان بباطنه وبظاهره وبسمعه يعلم أسماءها، وبفؤاده يعقل الصفات المشتركة والمختصة.
والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة.
فأما الحدود المتكلفة فليس فيها فائدة، لا في العقل، ولا في الحس، ولا في السمع، إلا ما هو كالأسماء مع التطويل، أو ما هو كالتمييز كسائر الصفات.
ولهذا لما رأوا ذلك جعلوا الحد نوعين: نوعًا بحسب الاسم؛ وهو بيان ما يدخل فيه، ونوعا بحسب الصفة أو الحقيقة أو المسمى، وزعموا كشف / الحقيقة وتصويرها، والحقيقة المذكورة إن ذكرت بلفظ دخلت في القسم الأول، وإن لم تذكر بلفظ فلا تدرك بلفظ ولا تحد بمقال إلا كما تقدم.
وهذه نكت تنبه على جمل المقصود، وليس هذا موضع بسط ذلك.
الوجه السادس عشر:
أن في الصفات الذاتية المشتركة والمختصة ـ كالحيوانية والناطقية ـ إن أرادوا بالاشتراك: أن نفس الصفة الموجودة في الخارج مشتركة فهذا باطل؛ إذ لا اشتراك في المعينات التي يمنع تصورها من وقوع الشركة فيها.
وإن أرادوا بالاشتراك: أن مثل تلك الصفة حاصلة للنوع الآخر، قيل لهم: لا ريب أن بين حيوانية الإنسان وحيوانية الفرس قدرًا مشتركًا، وكذلك بين صوتيهما وتمييزهما قدرًا مشتركًا، فإن الإنسان له تمييز وللفرس تمييز، ولهذا صوت هو النطق، ولذاك صوت هو الصهيل، فقد خص كل صوت باسم يخصه. فإذا كان حقيقة أحد هذين يخالف الآخر ويختص بنوعه، فمن أين جعلتم حيوانية أحدهما مماثلة لحيوانية الآخر في الحد والحقيقة؟!
وهلاَّ قيل: إن بين حيوانيتهما قدرًا مشتركًا ومميزًا، كما أن بين صوتيهما / كذلك؟ وذلك أن الحس والحركة الإرادية إما أن توجد للجسم أو للنفس . فإن الجسم يحس ويتحرك بالإرادة ، والنفس تحس وتتحرك بالإرادة، وإن كان بين الوصفين من الفرق ما بين الحقيقتين.وكذلك النطق هو للنفس بالتمييز والمعرفة، والكلام النفساني، وهو للجسم ـ أيضًا ـ بتمييز القلب ومعرفته والكلام اللساني. فكل من جسمه ونفسه يوصف بهذين الوصفين، وليست حركة نفسه وإرادتها ومعرفتها ونطقها مثل ما للفرس، وإن كان بينهما قدر مشترك، وكذلك ما يقوم بجسمه من الحس والحركة الإرادية ليس مثل ما للفرس، وإن كان بينهما قدر مشترك، فإن الذي يلائم جسمه من مطعم ومشرب وملبس ومنكح ومشموم ومرئى ومسموع، بحيث يحسه ويتحرك إليه حركة إرادية ليس هو مثل ما للفرس.
فالحس والحركة الإرادية هي بالمعنى العام لجميع الحيوان، وبالمعنى الخاص ليس إلا للإنسان، وكذلك التمييز سواء؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أحب الأسماء إلى اللّه عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء: حارث وهمام ، وأقبحها: حرب ومرة). رواه مسلم.
فالحارث هو العامل الكاسب المتحرك، والهمام هو الدائم الهم الذي هو مقدم الإرادة، فكل إنسان حارث فاعل بإرادته، وكذلك مسبوق بإحساسه.
/فحيوانية الإنسان ونطقه، كل منهما فيه ما يشترك مع الحيوان فيه، وفيه ما يختص به عن سائر الحيوان، وكذلك بناء بنيته، فإن نموه واغتذاءه وإن كان بينه وبين النبات فيه قدر مشترك، فليس مثله هو؛ إذ هذا يغتذي بما يلذ به ويسر نفسه، وينمو بنمو حسه وحركته وهمه وحرثه، وليس النبات كذلك.
وكذلك أصناف النوع وأفراده. فنطق العرب بتمييز قلوبهم وبيان ألسنتهم أكمل من نطق غيرهم، حتى ليكون في بني آدم من هو دون البهائم في النطق والتمييز، ومنهم من لا تدرك نهايته.
وهذا كله يبين أن اشتراك أفراد الصنف، وأصناف النوع، وأنواع الجنس والأجناس السافلة في مسمى الجنس الأعلى، لا يقتضي أن يكون المعنى المشترك فيها بالسواء، كما أنه ليس بين الحقائق الخارجة شيء مشترك، ولكن الذهن فَهِمَ معنى يوجد في هذا ويوجد نظيره في هذا. وقد تبين أنه ليس نظيرًا له على وجه المماثلة، لكن على وجه المشابهة، وأن ذلك المعنى المشترك هو في أحدهما على حقيقة تخالف حقيقة ما في الآخر.
ومن هنا يغلط القياسيون الذين يلحظون المعنى المشترك الجامع دون الفارق المميز.
والعرب من أصناف الناس، والمسلمون من أهل الأديان، أعظم الناس / إدراكا للفروق، وتمييزًا للمشتركات. وذلك يوجد في عقولهم ولغاتهم وعلومهم وأحكامهم؛ ولهذا لما ناظر متكلمو الإسلام العرب هؤلاء المتكلمة الصابئة عجم الروم، وذكروا فضل منطقهم وكلامهم على منطق أولئك وكلامهم ـ ظهر رُجْحَان كلام الإسلاميين، كما فعله القاضي أبو بكر بن الباقلاني في كتاب [الدقائق] الذي رد فيه على الفلاسفة كثيرًا من مذاهبهم الفاسدة في الأفلاك والنجوم، والعقول والنفوس، وواجب الوجود وغير ذلك. وتكلم على منطقهم وتقسيمهم الموجودات، كتقسيمهم الموجود إلى الجوهر والعرض، ثم تقسيم الأعراض إلى المقولات التسعة، وذكر تقسيم متكلمة المسلمين الذي فيه من التمييز والجمع والفرق ما ليس في كلام أولئك.
وذلك أن الله علّم الإنسان البيان، كما قال تعالى: {الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ الْإِنسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} [الرحمن: 1-4]، وقال تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} [البقرة: 31]، وقال: {عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق: 5]، والبيان: بيان القلب واللسان، كما أن العمى والبكم يكون في القلب واللسان، كما قال تعالى: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} [البقرة: 18]، وقال: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [البقرة: 171]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا سألوا إذا لم يعلموا ؛ إنما شفاء العي السؤال)، وفي الأثر: العي عي القلب لا عي اللسان. أو قال: شر العي عي القلب، وكان ابن مسعود يقول: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه.
/وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهها عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: (الحلال بيِّن والحرام بَيِّن، وبينهما أمور مشتبهات) الحديث. وقد قرئ قوله تعالى: {وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} [الأنعام: 55] بالرفع والنصب، أي: ولتتبين أنت سبيلهم.
فالإنسان يستبين الأشياء . وهم يقولون: قد بان الشيء، وبينته، وتبين الشيء وتبينته، واستبان الشيء واستبنته، كل هذا يستعمل لازمًا ومتعديًا، ومنه قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، هو هنا متعد، ومنه قوله: {بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، أي: متبينة. فهنا هو لازم. والبيان كالكلام، يكون مصدر بان الشيء بيانا، ويكون اسم مصدر لبين، كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء، ويكون بمعنى بينت الشيء، أي: أوضحته. وهذا هو الغالب عليه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (إن من البيان لسحرًا).
والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع، حتى يتبين له الشيء ويستبين؛ كما قال تعالى: {هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ} الآية [آل عمران: 138]. ومع هذا، فالذي لا يستبين له كما قال تعالى: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى} [فصلت: 44]، وقال: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44]، وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4]، وقال: {وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [النور: 54]، وقال: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115] ، وقال: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176]، وقال: {قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي} الآية [الأنعام: 57]، وقال: {أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ} [هود: 17]، وقال: {وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ} [النور: 34]، وقال: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [النور: 61].
فأما الأشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق وتكبر، والإفصاح بذكر الأشياء التي يستقبح ذكرها، فهذا مما ينهي عنه، كما جاء في الحديث: (إن الله يَبْغِضُ البليغ من الرجال، الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها)، وفي الحديث: (الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق)؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنّة من فقهه).وفي حديث سعد لما سمع ابنه أو لما وجد ابنه يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، قال: يابني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (سيكون قوم يعْتَدُون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن عذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر).
وعامة الحدود المنطقية هي من هذا الباب ، حشو لكلام كثير، يبينون به الأشياء، وهي قبل بيانهم أبين منها بعد بيانهم. فهي مع كثرة ما فيها من تضييع الزمان وإتعاب الفكر واللسان لا توجب إلا العمى والضلال، وتفتح باب / المراء والجدال ؛ إذ كل منهم يورد على حد الآخر من الأسئلة ما يفسد به، ويزعم سلامة حده منه، وعند التحقيق تجدهم متكافئين أو متقاربين، ليس لأحدهم على الآخر رجحان مبين، فإما أن يقبل الجميع أو يرد الجميع، أو يقبل من وجه ويرد من وجه.
هذا في الحدود التي تشترك في تمييز المحدود وفصله عما سواه، وأما متى أدخل أحدهما في الحد ما أخرجه الآخر، أو بالعكس، فالكلام في هذا علم يستفاد به حد الاسم ومعرفة عمومه وخصوصه، مثل الكلام في حد الخمر: هل هي عصير العنب المشتد، أم هي كل مسكر؟ وحد الغيبة ونحو ذلك.
وهذا هو الذي يتكلم فيه العلماء، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ قال: (ذكرك أخاك بما يكره) الحديث، وكذلك قوله: (كل مسكر خمر)، وقول عمر على المنبر: الخمر ما خامر العقل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)، فقال له رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنًا وثوبه حسنًا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: (لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بَطْر الحق وغمط الناس) ومنه تفسير الكلام وشرحه وبيانه.
فكل من شرح كلام غيره وفسره وبين تأويله، فلابد له من معرفة حدود الأسماء التي فيه.
/فكل ما كان من حد بالقول فإنما هو حد للاسم، بمنزلة الترجمة والبيان. فتارة يكون لفظًا محضًا إن كان المخاطب يعرف المحدود، وتارة يحتاج إلى ترجمة المعنى وبيانه إذا كان المخاطب لم يعرف المسمى . وذلك يكون بضرب المثل، أو تركيب صفات، وذلك لا يفيد تصوير الحقيقة لمن لم يتصورها بغير الكلام فليعلم ذلك.
وأما ما يذكرونه من حد الشيء، أو الحد بحسب الحقيقة، أو حد الحقائق، فليس فيه من التمييز إلا ذكر بعض الصفات التي للمحدود، كما تقدم، وفيه من التخليط ما قد نبهنا على بعضه.
وهذا المقام لا أذكر فيه موارد النزاع، فيقال: هو الاستدلال على المختلف بالمختلف، لكن أنا أصف جنس كلامهم، فأقول:
لا ريب أن كلامهم كله منحصر في الحدود التي تفيد التصورات، سواء كانت الحدود حقيقية، أو رسمية أو لفظية، وفي الأقيسة التي تفيد التصديقات، سواء كانت أقيسة عموم وشمول، أو شبه وتمثيل، أو استقراء وتتبع.
وكلامهم غالبه لا يخلو من تكلف، إما في العلم وإما في القول، فإما / أن يتكلفوا علم ما لا يعلمونه، فيتكلمون بغير علم، أو يكون الشيء معلومًا لهم فيتكلفون من بيانه ما هو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق، وهذا من المنكر المذموم في الشرع والعقل، قال تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86]، وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: أيها الناس، من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: لا أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: لا أعلم.
وقد ذم الله القول بغير علم في كتابه، كقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36] لا سيما القول على الله، كقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33] ، وكذلك ذم الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه، وأمر بأن نقول القول السديد والقول البليغ.
وهؤلاء كلامهم في الحدود غالبه من الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه، بل قد يكثر كلامهم في الأقيسة والحجج، كثير منه كذلك، وكثير منه باطل، وهو قول بغير علم، وقول بخلاف الحق.
أما الأول، فإنهم يزعمون أن الحدود التي يذكرونها يفيدون بها تصور الحقائق، وأن ذلك إنما يتم بذكر الصفات الذاتية المشتركة والمميزة، حتى يركب الحد من الجنس المشترك، والفصل المميز. وقد يقولون: إن التصورات / لا تحصل إلا بالحدود، ويقولون: الحدود المركبة لا تكون إلا للأنواع المركبة من الجنس والفصل دون الأنواع البسيطة.
وقد ذكرت في غير هذا الموضع ملخص المنطق ومضمونه، وأشرت إلى بعض ما دخل به على كثير من الناس من الخطأ والضلال، وليس هذا موضع بسط ذلك، لكن نذكر هنا وجوها:
الوجه الأول:
قولهم: إن التصور الذي ليس ببديهي لا ينال إلا بالحد، باطل؛ لأن الحد هو قول الحاد. فإن الحد هنا هو القول الدال على ماهية المحدود. فالمعرفة بالحد لا تكون إلا بعد الحد؛ فإن الحاد الذي ذكر الحد إن كان عرف المحدود بغير حد بطل قولهم: لا يعرف إلا بالحد، وإن كان عرفه بحد آخر، فالقول فيه كالقول في الأول، فإن كان هذا الحاد عرفه بعد الحد الأول، لزم الدور، وإن كان تأخر لزم التسلسل.
/الوجه الثاني:
أنهم إلى الآن لم يسلم لهم حد لشيء من الأشياء إلا ما يدعيه بعضهم وينازعه فيه آخرون. فإن كانت الأصول لا تتصور إلا بالحدود، لزم ألا يكون إلى الآن أحد عرف شيئًا من الأمور، ولم يبق أحد ينتظر صحته؛ لأن الذي يذكره يحتاج إلى معرفة بغير حد وهي متعددة، فلا يكون لبني آدم شيء من المعرفة، وهذه سفسطة ومغالطة.
الوجه الثالث:
أن المتكلمين بالحدود طائفة قليلة في بني آدم، لاسيما الصناعة المنطقية، فإن واضعها هو أرسطو، وسلك خلفه فيها طائفة من بني آدم.
ومن المعلوم أن علوم بني آدم ـ عامتهم وخاصتهم ـ حاصلة بدون ذلك، فبطل قولهم: إن المعرفة متوقفة عليها، أما الأنبياء فلا ريب في استغنائهم عنها، وكذلك أتباع الأنبياء من العلماء والعامة. فإن القرون الثلاثة من هذه الأمة ـ الذين كانوا أعلم بني آدم علومًا ومعارف ـ لم يكن تكلف / هذه الحدود من عادتهم، فإنهم لم يبتدعوها، ولم تكن الكتب الأعجمية الرومية عربت لهم، وإنما حدثت بعدهم من مبتدعة المتكلمين والفلاسفة، ومن حين حدثت صار بينهم من الاختلاف والجهل مالا يعلمه إلا الله.
وكذلك علم [الطب] و [الحساب] وغير ذلك، لا تجد أئمة هذه العلوم يتكلفون هذه الحدود المركبة من الجنس والفصل إلا من خلط ذلك بصناعتهم من أهل المنطق.
وكذلك النحاة مثل سيبويه الذي ليس في العالم مثل كتابه، وفيه حكمة لسان العرب، لم يتكلف فيه حد الاسم والفاعل ونحو ذلك، كما فعل غيره. ولما تكلف النحاة حد الاسم ذكروا حدودًا كثيرة كلها مطعون فيها عندهم . وكذلك ما تكلف متأخروهم من حد الفاعل والمبتدأ والخبر ونحو ذلك، لم يدخل فيها عندهم من هو إمام في الصناعة ولا حاذق فيها.
وكذلك الحدود التي يتكلفها بعض الفقهاء للطهارة والنجاسة، وغير ذلك من معاني الأسماء المتداولة بينهم، وكذلك الحدود التي يتكلفها الناظرون في أصول الفقه لمثل الخبر والقياس والعلم وغير ذلك، لم يدخل فيها إلا من ليس بإمام في الفن، وإلى الساعة لم يسلم لهم حد، وكذلك حدود أهل الكلام.
/فإذا كان حذاق بني آدم في كل فن من العلم أحكموه بدون هذه الحدود المتكلفة، بطل دعوى توقف المعرفة عليها.
وأما علوم بني آدم الذين لا يصنفون الكتب، فهي مما لا يحصيه إلا الله، ولهم من البصائر والمكاشفات والتحقيق والمعارف ما ليس لأهل هذه الحدود المتكلفة، فكيف يجوز أن تكون معرفة الأشياء متوقفة عليها؟
الوجه الرابع:
أن الله جعل لابن آدم من الحس الظاهر والباطن ما يحس به الأشياء ويعرفها، فيعرف بسمعه وبصره وشمه وذوقه ولمسه الظاهر ما يعرف، ويعرف ـ أيضا ـ بما يشهده ويحسه بنفسه وقلبه ما هو أعظم من ذلك. فهذه هي الطرق التي تعرف بها الأشياء . فأما الكلام فلا يتصور أن يعرف بمجرده مفردات الأشياء إلا بقياس تمثيل أو تركيب ألفاظ، وليس شيء من ذلك يفيد تصور الحقيقة.
فالمقصود أن الحقيقة إن تصورها بباطنه أو ظاهره استغنى عن الحد القولي، وإن لم يتصورها بذلك امتنع أن يتصور حقيقتها بالحد القولي، وهذا أمر محسوس يجده الإنسان من نفسه، فإن من عرف المحسوسات المذوقة / ـ مثلًا - كالعسل، لم يفده الحد تصورها. ومن لم يذق ذلك، كمن أخبر عن السكرـ وهو لم يذقه ـ لم يمكن أن يتصور حقيقته بالكلام والحد، بل يمثل له ويقرب إليه، ويقال له: طعمه يشبه كذا، أو يشبه كذا وكذا، وهذا التشبيه والتمثيل ليس هو الحد الذي يدعونه.
وكذلك المحسوسات الباطنة، مثل الغضب والفرح والحزن والغم والعلم ونحو ذلك، من وجدها فقد تصورها، ومن لم يجدها لم يمكن أن يتصورها بالحد؛ ولهذا لا يتصور الأكمه الألوان بالحد، ولا العِنِّين الوقاع بالحد. فإذن القائل بأن الحدود هي التي تفيد تصور الحقائق، قائل للباطل المعلوم بالحس الباطن والظاهر.
الوجه الخامس:
أن الحدود إنما هي أقوال كلية، كقولنا: حيوان ناطق، ولفظ يدل على معنى ونحو ذلك، فتصور معناها لا يمنع من وقوع الشركة فيها، وإن كانت الشركة ممتنعة لسبب آخر، فهي إذن لا تدل على حقيقة معينة بخصوصها، وإنما تدل على معنى كلي. والمعاني الكلية وجودها في الذهن لا في الخارج، فما في الخارج لا يتعين، ولا يعرف بمجرد الحد، وما في الذهن ليس هو حقائق الأشياء، فالحد لا يفيد تصور حقيقة أصلا.
/الوجه السادس:
أن الحد من باب الألفاظ، واللفظ لا يدل المستمع على معناه إن لم يكن قد تصور مفردات اللفظ بغير اللفظ؛ لأن اللفظ المفرد لا يدل المستمع على معناه إن لم يعلم أن اللفظ موضوع للمعنى، ولا يعرف ذلك حتى يعرف المعنى. فتصور المعاني المفردة يجب أن يكون سابقًا على فهم المراد بالألفاظ، فلو استفيد تصورها من الألفاظ لزم الدور، وهذا أمر محسوس؛ فإن المتكلم باللفظ المفرد إن لم يبين للمستمع معناه حتى يدركه بحسه أو بنظره، وإلا لم يتصور إدراكه له بقول مؤلف من جنس وفصل.
الوجه السابع:
أن الحد هو الفصل والتمييز بين المحدود وغيره، يفيد ما تفيده الأسماء من التمييز والفصل بين المسمى وبين غيره، فهذا لا ريب في أنه يفيد التمييز. فأما تصور حقيقة فلا، لكنها قد تفصل ما دل عليه الاسم بالإجمال، وليس ذلك من إدراك الحقيقة في شيء. والشرط في ذلك: أن تكون الصفات ذاتية، بل هو بمنزلة التقسيم والتحديد للكل، كالتقسيم لجزئياته ويظهر ذلك بـ:
/الوجه الثامن:
وهو أن الحس الباطن والظاهر يفيد تصور الحقيقة تصورًا مطلقًا، أما عمومها وخصوصها فهو من حكم العقل؛ فإن القلب يعقل معنى من هذا المعين ومعنى يماثله من هذا المعين، فيصير في القلب معنى عامًا مشتركًا، وذلك هو عقله، أي عقله للمعاني الكلية.
فإذا عقل معنى الحيوانية الذي يكون في هذا الحيوان وهذا الحيوان، ومعنى الناطق الذي يكون في هذا الإنسان وهذا الإنسان، وهو مختص به، عقل أن في نوع الإنسان معنى يكون نظيره في الحيوان، ومعنى ليس له نظير في الحيوان.
فالأول هو الذي يقال له: الجنس . والثاني: الذي يقال له: الفصل . وهما موجودان في النوع.
فهذا حق، ولكن لم يستفد من هذا اللفظ ما لم يكن يعرفه بعقله من أن هذا المعنى عام للإنسان ولغيره من الحيوان، بمعنى أن ما في هذا نظير ما في هذا ؛ إذ ليس في الأعيان الخارجة عموم، وهذا المعنى يختص بالإنسان. فلا فرق بين قولك: الإنسان حيوان ناطق، وقولك: الإنسان هو الحيوان الناطق، إلا من جهة الإحاطة والحصر في الثاني، لا من جهة تصوير / حقيقته باللفظ والإحاطة. والحصر هو التمييز الحاصل بمجرد الاسم، وهو قولك: إنسان وبشر . فإن هذا الاسم إذا فهم مسماه، أفاد من التمييز ما أفاده الحيوان الناطق في سلامته عن المطاعن.
وأما تصور أن فيه معنى عامًا ومعنى خاصًا، فليس هذا من خصائص الحد، كما تقدم. والذي يختص بالحد ليس إلا مجرد التمييز الحاصل بالأسماء. وهذا بين لمن تأمله.
وأما إدراك صفات فيه، بعضها مشترك وبعضها مختص، فلا ريب أن هذا قد لا يتفطن له بمجرد الاسم، لكن هذا يتفطن له بالحد وبغير الحد. فليس في الحد إلا ما يوجد في الأسماء، أو في الصفات التي تذكر للمسمى. وهذان نوعان معروفان:
الأول: معنى الأسماء المفردة.
والثاني: معرفة الجمل المركبة الإسمية والفعلية التي يخبر بها عن الأشياء، وتوصف بها الأشياء.
وكلا هذين النوعين لا يفتقر إلى الحد المتكلف، فثبت أن الحد ليس فيه فائدة إلا وهي موجودة في الأسماء والكلام بلا تكلف، فسقطت فائدة خصوصية الحد.
/الوجه التاسع:
أن العلم بوجود صفات مشتركة ومختصة حق، لكن التمييز بين تلك الصفات بجعل بعضها ذاتيًا تتقوم منه حقيقة المحدود، وبعضها لازمًا لحقيقة المحدود، تفريق باطل، بل جميع الصفات الملازمة للمحدود ـ طردًا وعكسًا ـ هي جنس واحد، فلا فرق بين الفصل والخاصة، ولا بين الجنس والعرض العام.
وذلك أن الحقيقة المركبة من تلك الصفات: إما أن يعني بها الخارجة أو الذهنية أو شيء ثالث. فإن عنى بها الخارجة، فالنطق والضحك في الإنسان حقيقتان لازمتان يختصان به. وإن عنى الحقيقة التي في الذهن، فالذهن يعقل اختصاص هاتين الصفتين به دون غيره.
وإن قيل: بل إحدى الصفتين يتوقف عقل الحقيقة عليها، فلا يعقل الإنسان في الذهن حتى يفهم النطق، وأما الضحك فهو تابع لفهم الإنسان. وهذا معنى قولهم: [الذاتي ما لا يتصور فهم الحقيقة بدون فهمه، أو ما تقف الحقيقة في الذهن والخارج عليه].
/قيل: إدراك الذهن أمر نسبي إضافي، فإن كون الذهن لا يفهم هذا إلا بعد هذا، أمر يتعلق بنفس إدراك الذهن، ليس هو شيئًا ثابتًا للموصوف في نفسه، فلابد أن يكون الفرق بين الذاتي والعرضي بوصف ثابت في نفس الأمر، سواء حصل الإدراك له أو لم يحصل، إن كان أحدهما جزءًا للحقيقة دون الآخر وإلا فلا.
الوجه العاشر:
أن يقال: كون الذهن لا يعقل هذا إلا بعد هذا، إن كان إشارة إلى أذهان معينة، وهي التي تصورت هذا، لم يكن هذا حجة ؛ لأنهم هم وضعوها هكذا. فيكون التقدير: أن ما قدمناه في أذهاننا على الحقيقة فهو الذاتي، وما أخرناه فهو العرضي. ويعود الأمر إلى أنا تحكمنا بجعل بعض الصفات ذاتيًا وبعضها عرضيًا لازمًا وغير لازم، وإن كان الأمر كذلك، كان هذا الفرقان مجرد تحكم بلا سلطان. ولا يستنكر من هؤلاء أن يجمعوا بين المفترقين ويفرقوا بين المتماثلين. فما أكثر هذا في مقاييسهم التي ضلوا بها وأضلوا . وهم أول من أفسد دين المسلمين، وابتدع ما غير به الصابئة مذاهب أهل الإيمان المهتدين.
وإن قالوا: بل جميع أذهان بني آدم ـ والأذهان الصحيحة ـ لا تدرك الإنسان / إلا بعد خطور نطقه ببالها دون ضحكه.
قيل لهم: ليس هذا بصحيح، ولا يكاد يوجد هذا الترتيب إلا فيمن يقلد عنكم هذه الحدود من المقلدين لكم في الأمور التي جعلتموها ميزان المعقولات، وإلا فبنو آدم قد لا يخطر لأحدهم أحد الوصفين، وقد يخطر له هذا دون هذا وبالعكس، ولو خطر له الوصفان وعرف أن الإنسان حيوان ناطق ضاحك، لم يكن بمجرد معرفته هذه الصفات مدركًا لحقيقة الإنسان أصلًا، وكل هذا أمر محسوس معقول.
فلا يغالط العاقل نفسه في ذلك لهيبة التقليد لهؤلاء، الذين هم من أكثر الخلق ضلالًا مع دعوى التحقيق، فهم في الأوائل كمتكلمة الإسلام في الأواخر. ولما كان المسلمون خيرًا من أهل الكتابين والصابئين، كانوا خيرًا منهم وأعلم وأحكم، فتدبر هذا فإنه نافع جدًا.
ومن هنا يقولون: الحدود الذاتية عسرة، وإدراك الصفات الذاتية صعب، وغالب ما بأيدي الناس حدود رسمية؛ وذلك كله لأنهم وضعوا تفريقًا بين شيئين بمجرد التحكم الذي هم أدخلوه.
ومن المعلوم أن ما لا حقيقة له في الخارج ولا في المعقول، وإنما هو ابتداع مبتدع وضعه، وفرق به بين المتماثلين فيما تماثلا فيه ـ لا تعقله القلوب / الصحيحة ـ إذ ذاك من باب معرفة المذاهب الفاسدة التي لا ضابط لها، وأكثر ما تجد هؤلاء الأجناس يعظمونه من معارفهم ويدعون اختصاص فضلائهم به، هو من الباطل الذي لا حقيقة له، كما نبهنا على هذا فيما تقدم.
الوجه الحادي عشر:
قولهم: الحقيقة مركبة من الجنس والفصل، والجنس هو الجزء المشترك والفصل هو الجزء المميز.
يقال لهم: هذا التركيب، إما أن يكون في الخارج أو في الذهن. فإن كان في الخارج فليس في الخارج نوع كلي يكون محدودًا بهذا الحد إلا الأعيان المحسوسة، والأعيان في كل عين صفة يكون نظيرها لسائر الحيوانات كالحس والحركة الإرادية، وصفة ليس مثلها لسائر الحيوان وهي النطق. وفي كل عين يجتمع هذان الوصفان، كما يجتمع سائر الصفات والجواهر القائمة لأمور مركبة من الصفات المجعولة فيها.
وإن أردتم بالحيوانية والناطقية جوهرًا، فليس في الإنسان جوهران، أحدهما حي، والآخر ناطق، بل هو جوهر واحد له صفتان. فإن كان / الجوهر مركبًا من عرضين، لم يصح. وإن كان من جوهر عام وخاص فليس فيه ذلك، فبطل كون الحقيقة الخارجة مركبة.
وإن جعلوها تارة جوهرًا وتارة صفة، كان ذلك بمنزلة قول النصارى في الأقانيم، وهو من أعظم الأقوال تناقضًا باتفاق العلماء.
وإن قالوا: المركب الحقيقية الذهنية المعقولة، قيل ـ أولا: تلك ليست هي المقصودة بالحدود، إلا أن تكون مطابقة للخارج، فإن لم يكن هناك تركيب لم يصح أن يكون في هذه تركيب، وليس في الذهن إلا تصور الحي الناطق. وهو جوهر واحد له صفتان، كما قدمنا، فلا تركيب فيه بحال.
واعلم أنه لا نزاع أن صفات الأنواع والأجناس منها ما هو مشترك بينها وبين غيرها، كالجنس والعرض العام، ومنها ما هو لازم للحقيقة، ومنها ما هو عارض لها، وهو ما ثبت لها في وقت دون وقت كالبطىء الزوال وسريعه، وإنما الشأن في التفريق بين الذاتي والعرضي اللازم، فهذا هو الذي مداره على تحكم ذهن الحاد.
ولا تنازع في أن بعض الصفات قد يكون أظهر وأشرف، فإن النطق أشرف من الضحك، ولهذا ضرب اللّه به المثل في قوله: {إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ}[الذاريات: 23]، ولكن الشأن في جعل هذا ذاتيًا تتصور به الحقيقة دون الآخر.
/الوجه الثاني عشر:
أن هذه الصفات الذاتية قد تعلم ولا يتصور بها كنه المحدود، كما في هذا المثال وغيره، فعلم أن ذلك ليس بموجب لفهم الحقيقة.
الوجه الثالث عشر:
أن الحد إذا كان له جزءان، فلابد لجزأيه من تصور، كالحيوان والناطق، فإن احتاج كل جزء إلى حد، لزم التسلسل أو الدور.
فإن كانت الأجزاء متصورة بنفسها بلا حد ـ وهو تصور الحيوان، أو الحساس، أو المتحرك بالإرادة، أو النامي، أو الجسم ـ فمن المعلوم أن هذه أعم. وإذا كانت أعم لكون إدراك الحس لأفرادها أكثر، فإن كان إدراك الحس لأفرادها كافيًا في التصور فالحس قد أدرك أفراد النوع . وإن لم يكن كافيًا في ذلك لم تكن الأجزاء معروفة، فيحتاج المعرف إلى معرف، وأجزاء الحد إلى حد.
/الوجه الرابع عشر:
أن الحدود لابد فيها من التمييز، وكلما قلت الأفراد كان التمييز أيسر، وكلما كثرت كان أصعب، فضبط العقل الكلي تقل أفراده مع ضبط كونه كليًا أيسر عليه مما كثرت أفراده، وإن كان إدراك الكلى الكثير الأفراد أيسر عليه، فذاك إذا أدركه مطلقًا؛ لأن المطلق يحصل بحصول كل واحد من الأفراد.
وإذا كان ذلك كذلك، فأقل ما في أجزاء المحدود أن تكون متميزة تمييزًا كليًا ؛ ليعلم كونها صفة للمحدود أو محمولة عليه أم لا . فإذا كان ضبطها كلية أصعب وأتعب من ضبط أفراد المحدود، كان ذلك تعريفًا للأسهل معرفة بالأصعب مفردة، وهذا عكس الواجب.
الوجه الخامس عشر:
أن الله ـ سبحانه ـ علَّم آدم الأسماء كلها، وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك، ويخصه دون ما سواه، ويبين به ما يرسم معناه / في النفس. ومعرفة حدود الأسماء واجبة ؛ لأنه بها تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي جعله الله رحمة لهم، لاسيما حدود ما أنزل الله في كتبه من الأسماء كالخمر والربا.
فهذه الحدود هي الفاصلة المميزة بين ما يدخل في المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما دل عليه من الصفات، وبين ما ليس كذلك؛ ولهذا ذم الله من سمى الأشياء بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فإنه أثبت للشيء صفة باطلة كإلهية الأوثان.
فالأسماء النطقية سمعية، وأما نفس تصور المعاني ففطري، يحصل بالحس الباطن والظاهر، وبإدراك الحس وشهوده ببصر الإنسان بباطنه وبظاهره وبسمعه يعلم أسماءها، وبفؤاده يعقل الصفات المشتركة والمختصة.
والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة.
فأما الحدود المتكلفة فليس فيها فائدة، لا في العقل، ولا في الحس، ولا في السمع، إلا ما هو كالأسماء مع التطويل، أو ما هو كالتمييز كسائر الصفات.
ولهذا لما رأوا ذلك جعلوا الحد نوعين: نوعًا بحسب الاسم؛ وهو بيان ما يدخل فيه، ونوعا بحسب الصفة أو الحقيقة أو المسمى، وزعموا كشف / الحقيقة وتصويرها، والحقيقة المذكورة إن ذكرت بلفظ دخلت في القسم الأول، وإن لم تذكر بلفظ فلا تدرك بلفظ ولا تحد بمقال إلا كما تقدم.
وهذه نكت تنبه على جمل المقصود، وليس هذا موضع بسط ذلك.
الوجه السادس عشر:
أن في الصفات الذاتية المشتركة والمختصة ـ كالحيوانية والناطقية ـ إن أرادوا بالاشتراك: أن نفس الصفة الموجودة في الخارج مشتركة فهذا باطل؛ إذ لا اشتراك في المعينات التي يمنع تصورها من وقوع الشركة فيها.
وإن أرادوا بالاشتراك: أن مثل تلك الصفة حاصلة للنوع الآخر، قيل لهم: لا ريب أن بين حيوانية الإنسان وحيوانية الفرس قدرًا مشتركًا، وكذلك بين صوتيهما وتمييزهما قدرًا مشتركًا، فإن الإنسان له تمييز وللفرس تمييز، ولهذا صوت هو النطق، ولذاك صوت هو الصهيل، فقد خص كل صوت باسم يخصه. فإذا كان حقيقة أحد هذين يخالف الآخر ويختص بنوعه، فمن أين جعلتم حيوانية أحدهما مماثلة لحيوانية الآخر في الحد والحقيقة؟!
وهلاَّ قيل: إن بين حيوانيتهما قدرًا مشتركًا ومميزًا، كما أن بين صوتيهما / كذلك؟ وذلك أن الحس والحركة الإرادية إما أن توجد للجسم أو للنفس . فإن الجسم يحس ويتحرك بالإرادة ، والنفس تحس وتتحرك بالإرادة، وإن كان بين الوصفين من الفرق ما بين الحقيقتين.وكذلك النطق هو للنفس بالتمييز والمعرفة، والكلام النفساني، وهو للجسم ـ أيضًا ـ بتمييز القلب ومعرفته والكلام اللساني. فكل من جسمه ونفسه يوصف بهذين الوصفين، وليست حركة نفسه وإرادتها ومعرفتها ونطقها مثل ما للفرس، وإن كان بينهما قدر مشترك، وكذلك ما يقوم بجسمه من الحس والحركة الإرادية ليس مثل ما للفرس، وإن كان بينهما قدر مشترك، فإن الذي يلائم جسمه من مطعم ومشرب وملبس ومنكح ومشموم ومرئى ومسموع، بحيث يحسه ويتحرك إليه حركة إرادية ليس هو مثل ما للفرس.
فالحس والحركة الإرادية هي بالمعنى العام لجميع الحيوان، وبالمعنى الخاص ليس إلا للإنسان، وكذلك التمييز سواء؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أحب الأسماء إلى اللّه عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء: حارث وهمام ، وأقبحها: حرب ومرة). رواه مسلم.
فالحارث هو العامل الكاسب المتحرك، والهمام هو الدائم الهم الذي هو مقدم الإرادة، فكل إنسان حارث فاعل بإرادته، وكذلك مسبوق بإحساسه.
/فحيوانية الإنسان ونطقه، كل منهما فيه ما يشترك مع الحيوان فيه، وفيه ما يختص به عن سائر الحيوان، وكذلك بناء بنيته، فإن نموه واغتذاءه وإن كان بينه وبين النبات فيه قدر مشترك، فليس مثله هو؛ إذ هذا يغتذي بما يلذ به ويسر نفسه، وينمو بنمو حسه وحركته وهمه وحرثه، وليس النبات كذلك.
وكذلك أصناف النوع وأفراده. فنطق العرب بتمييز قلوبهم وبيان ألسنتهم أكمل من نطق غيرهم، حتى ليكون في بني آدم من هو دون البهائم في النطق والتمييز، ومنهم من لا تدرك نهايته.
وهذا كله يبين أن اشتراك أفراد الصنف، وأصناف النوع، وأنواع الجنس والأجناس السافلة في مسمى الجنس الأعلى، لا يقتضي أن يكون المعنى المشترك فيها بالسواء، كما أنه ليس بين الحقائق الخارجة شيء مشترك، ولكن الذهن فَهِمَ معنى يوجد في هذا ويوجد نظيره في هذا. وقد تبين أنه ليس نظيرًا له على وجه المماثلة، لكن على وجه المشابهة، وأن ذلك المعنى المشترك هو في أحدهما على حقيقة تخالف حقيقة ما في الآخر.
ومن هنا يغلط القياسيون الذين يلحظون المعنى المشترك الجامع دون الفارق المميز.
والعرب من أصناف الناس، والمسلمون من أهل الأديان، أعظم الناس / إدراكا للفروق، وتمييزًا للمشتركات. وذلك يوجد في عقولهم ولغاتهم وعلومهم وأحكامهم؛ ولهذا لما ناظر متكلمو الإسلام العرب هؤلاء المتكلمة الصابئة عجم الروم، وذكروا فضل منطقهم وكلامهم على منطق أولئك وكلامهم ـ ظهر رُجْحَان كلام الإسلاميين، كما فعله القاضي أبو بكر بن الباقلاني في كتاب [الدقائق] الذي رد فيه على الفلاسفة كثيرًا من مذاهبهم الفاسدة في الأفلاك والنجوم، والعقول والنفوس، وواجب الوجود وغير ذلك. وتكلم على منطقهم وتقسيمهم الموجودات، كتقسيمهم الموجود إلى الجوهر والعرض، ثم تقسيم الأعراض إلى المقولات التسعة، وذكر تقسيم متكلمة المسلمين الذي فيه من التمييز والجمع والفرق ما ليس في كلام أولئك.
وذلك أن الله علّم الإنسان البيان، كما قال تعالى: {الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ الْإِنسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} [الرحمن: 1-4]، وقال تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} [البقرة: 31]، وقال: {عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق: 5]، والبيان: بيان القلب واللسان، كما أن العمى والبكم يكون في القلب واللسان، كما قال تعالى: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} [البقرة: 18]، وقال: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [البقرة: 171]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا سألوا إذا لم يعلموا ؛ إنما شفاء العي السؤال)، وفي الأثر: العي عي القلب لا عي اللسان. أو قال: شر العي عي القلب، وكان ابن مسعود يقول: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه.
/وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهها عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: (الحلال بيِّن والحرام بَيِّن، وبينهما أمور مشتبهات) الحديث. وقد قرئ قوله تعالى: {وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} [الأنعام: 55] بالرفع والنصب، أي: ولتتبين أنت سبيلهم.
فالإنسان يستبين الأشياء . وهم يقولون: قد بان الشيء، وبينته، وتبين الشيء وتبينته، واستبان الشيء واستبنته، كل هذا يستعمل لازمًا ومتعديًا، ومنه قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، هو هنا متعد، ومنه قوله: {بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، أي: متبينة. فهنا هو لازم. والبيان كالكلام، يكون مصدر بان الشيء بيانا، ويكون اسم مصدر لبين، كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء، ويكون بمعنى بينت الشيء، أي: أوضحته. وهذا هو الغالب عليه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (إن من البيان لسحرًا).
والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع، حتى يتبين له الشيء ويستبين؛ كما قال تعالى: {هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ} الآية [آل عمران: 138]. ومع هذا، فالذي لا يستبين له كما قال تعالى: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى} [فصلت: 44]، وقال: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44]، وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4]، وقال: {وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [النور: 54]، وقال: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115] ، وقال: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176]، وقال: {قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي} الآية [الأنعام: 57]، وقال: {أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ} [هود: 17]، وقال: {وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ} [النور: 34]، وقال: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [النور: 61].
فأما الأشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق وتكبر، والإفصاح بذكر الأشياء التي يستقبح ذكرها، فهذا مما ينهي عنه، كما جاء في الحديث: (إن الله يَبْغِضُ البليغ من الرجال، الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها)، وفي الحديث: (الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق)؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنّة من فقهه).وفي حديث سعد لما سمع ابنه أو لما وجد ابنه يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، قال: يابني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (سيكون قوم يعْتَدُون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن عذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر).
وعامة الحدود المنطقية هي من هذا الباب ، حشو لكلام كثير، يبينون به الأشياء، وهي قبل بيانهم أبين منها بعد بيانهم. فهي مع كثرة ما فيها من تضييع الزمان وإتعاب الفكر واللسان لا توجب إلا العمى والضلال، وتفتح باب / المراء والجدال ؛ إذ كل منهم يورد على حد الآخر من الأسئلة ما يفسد به، ويزعم سلامة حده منه، وعند التحقيق تجدهم متكافئين أو متقاربين، ليس لأحدهم على الآخر رجحان مبين، فإما أن يقبل الجميع أو يرد الجميع، أو يقبل من وجه ويرد من وجه.
هذا في الحدود التي تشترك في تمييز المحدود وفصله عما سواه، وأما متى أدخل أحدهما في الحد ما أخرجه الآخر، أو بالعكس، فالكلام في هذا علم يستفاد به حد الاسم ومعرفة عمومه وخصوصه، مثل الكلام في حد الخمر: هل هي عصير العنب المشتد، أم هي كل مسكر؟ وحد الغيبة ونحو ذلك.
وهذا هو الذي يتكلم فيه العلماء، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ قال: (ذكرك أخاك بما يكره) الحديث، وكذلك قوله: (كل مسكر خمر)، وقول عمر على المنبر: الخمر ما خامر العقل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)، فقال له رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنًا وثوبه حسنًا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: (لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بَطْر الحق وغمط الناس) ومنه تفسير الكلام وشرحه وبيانه.
فكل من شرح كلام غيره وفسره وبين تأويله، فلابد له من معرفة حدود الأسماء التي فيه.
/فكل ما كان من حد بالقول فإنما هو حد للاسم، بمنزلة الترجمة والبيان. فتارة يكون لفظًا محضًا إن كان المخاطب يعرف المحدود، وتارة يحتاج إلى ترجمة المعنى وبيانه إذا كان المخاطب لم يعرف المسمى . وذلك يكون بضرب المثل، أو تركيب صفات، وذلك لا يفيد تصوير الحقيقة لمن لم يتصورها بغير الكلام فليعلم ذلك.
وأما ما يذكرونه من حد الشيء، أو الحد بحسب الحقيقة، أو حد الحقائق، فليس فيه من التمييز إلا ذكر بعض الصفات التي للمحدود، كما تقدم، وفيه من التخليط ما قد نبهنا على بعضه.
 عدد المشاهدات *:
عدد المشاهدات *:
706028
 عدد مرات التنزيل *:
عدد مرات التنزيل *:
301873
 حجم الخط :
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013