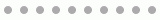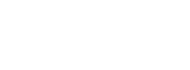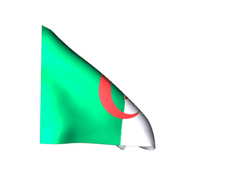/بسم الله الرحمن الرحيم
قَالَ الشيخ الإمام العَالم تقي الدين أوحد المجتهدين أحمد بن تيمية ـ قدس الله روحه ونور ضريحه:
الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا.
فَصْــل
في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيَّنَ جميع الدين؛ أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله، فإن هذا الأصل هو أصل/ أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصامًا بهذا الأصل كان أولى بالحق علمًا وعملًا، ومن كان أبعد عن الحق علمًا وعملًا: كالقرامطة والمتفلسفة الذين يظنون أن الرسل ما كانوا يعلمون حقائق العلوم الإلهية والكلية، وإنما يعرف ذلك بزعمهم من يعرفه من المتفلسفة، ويقولون: خاصة النبوة هي التخييل، ويجعلون النبوة أفضل من غيرها عند الجمهور لا عند أهل المعرفة، كما يقول هذا ونحوه الفارأبي وأمثاله، مثل مُبَشِّر بن فَاتِك وأمثاله من الإسماعيلية.
وآخرون يعترفون بأن الرسول علم الحقائق، لكن يقولون: لم يبينها، بل خاطب الجمهور بالتخييل، فيجعلون التخييل في خطابه لا في علمه، كما يقول ذلك ابن سينا وأمثاله.
وآخرون يعترفون بأن الرسل علموا الحق وبينوه، لكن يقولون: لا يمكن معرفته من كلامهم، بل يعرف بطريق آخر؛ إما المعقول عند طائفة، وإما المكاشفة عند طائفة، إما قياس فلسفي، وإما خيال صوفي. ثم بعد ذلك ينظر في كلام الرسول فما وافق ذلك قبل، وما خالفه؛ إما أن يفوض، وإما أن يؤول. وهذه طريقة كثير من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة، وهي طريقة خيار الباطنية والفلاسفة الذين يعظمون الرسول وينزهونه عن الجهل والكذب، لكن يدخلون في التأويل.
/وأبو حامد الغزالي لما ذكر في كتابه طرق الناس في التأويل، وأن الفلاسفة زادوا فيه حتى انحلوا، وأن الحق بين جمود الحنابلة، وبين انحلال الفلاسفة، وأن ذلك لا يعرف من جهة السمع، بل تعرف الحق بنور يقذف في قلبك، ثم ينظر في السمع، فما وافق ذلك قبلته وإلا فلا. وكان مقصوده بالفلاسفة المتأولين خيار الفلاسفة، وهم الذين يعظمون الرسول عن أن يكذب للمصلحة، ولكن هؤلاء وقعوا في نظير ما فروا منه، نسبوه إلى التلبيس والتعمية وإضلال الخلق، بل إلى أن يظهر الباطل ويكتم الحق.
وابن سينا وأمثاله، لما عرفوا أن كلام الرسول لا يحتمل هذه التأويلات الفلسفية، بل قد عرفوا أنه أراد مفهوم الخطاب ـ سلك مسلك التخييل، وقال: إنه خاطب الجمهور بما يخيل إليهم، ومع علمه أن الحق في نفس الأمر ليس كذلك. فهؤلاء يقولون: إن الرسل كذبوا للمصلحة.
وهذا طريق ابن رشد الحفيد [هو محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ولد سنة عشرين وخمسمائة. أخذ العلم عن أبي مروان بن مسرة وجماعة، وبرع في الفقه، وأخذ الطب عن أبي مروان بن حزبول، أثنى عليه علماء عصره، ومن أشهر تصانيفه: [بداية المجتهد]. مات محبوسًا بمراكش سنة خمس وتسعين وخمسمائة] وأمثاله من الباطنية، فالذين عظموا الرسل من هؤلاء عن الكذب نسبوهم إلى التلبيس والإضلال، والذين أقروا بأنهم بينوا الحق قالوا: إنهم كذبوا للمصلحة.
وأما أهل العلم والإيمان فمتفقون على أن الرسل لم يقولوا إلا / الحق، وأنهم بينوه، مع علمهم بأنهم أعلم الخلق بالحق، فهم الصادقون المصدوقون علموا الحق وبينوه، فمن قال: إنهم كذبوا للمصلحة فهو من إخوان المكذبين للرسل، لكن هذا لما رأى ما عملوا من الخير والعدل في العالم لم يمكنه أن يقول: كذبوا لطلب العلو والفساد، بل قال: كذبوا لمصلحة الخلق. كما يحكى عن ابن التَّومَرْت وأمثاله.
ولهذا كان هؤلاء لا يفرقون بين النبي والساحر إلا من جهة حُسْنِ القصد، فإن النبي يقصد الخير والساحر يقصد الشر، وإلا فلكل منهما خوارق هي عندهم قوى نفسانية، وكلاهما عندهم يكذب، لكن الساحر يكذب للعلو والفساد والنبي عندهم يكذب للمصلحة؛ إذ لم يمكنه إقامة العدل فيهم إلا بنوع من الكذب.
والذين علموا أن النبوة تناقض الكذب على الله، وأن النبي لا يكون إلا صادقًا من هؤلاء قالوا: إنهم لم يبينوا الحق، ولو أنهم قالوا: سكتوا عن بيانه لكان أقل إلحادًا، لكن قالوا: إنهم أخبروا بما يظهر منه للناس الباطل، ولم يبينوا لهم الحق، فعندهم أنهم جمعوا بين شيئين: بين كتمان حق لم يبينوه، وبين إظهار ما يدل على الباطل، وإن كانوا لم يقصدوا الباطل، فجعلوا كلامهم من جنس المعاريض التي يعني بها المتكلم معنى صحيحًا، لكن لا يفهم المستمع منها إلا الباطل. وإذا قالوا: قصدوا التعريض كان أقل إلحادًا ممن قال: إنهم قصدوا الكذب.
/ والتعريض نوع من الكذب؛ إذ كان كذبًا في الإفهام؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله)، وهي معاريض، كقوله عن سارة: إنها أختي؛ إذ كان ليس هناك مؤمن إلا هو وهي.
وهؤلاء يقولون: إن كلام إبراهيم وعامة الأنبياء مما أخبروا به عن الغيب كذب من المعاريض!!
وأما جمهور المتكلمين فلا يقولون بهذا، بل يقولون: قصدوا البيان دون التعريض، لكن مع هذا يقول الجهمية ونحوهم: إن بيان الحق ليس في خطابهم، بل إنما في خطابهم ما يدل على الباطل. والمتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية، ونحوهم ـ ممن سلك في إثبات الصانع طريق الإعراض ـ يقولون: إن الصحابة لم يبينوا أصول الدين، بل ولا الرسول؛ إما لشغلهم بالجهاد، أو لغير ذلك.
وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع، وبينا أن أصول الدين الحق الذي أنزل الله به كتابه، وأرسل به رسوله، وهي الأدلة والبراهين والآيات الدالة على ذلك ـ قد بينها الرسول أحسن بيان، وأنه دل الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية، وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته /وصفاته وصدق رسوله والمعاد، وغير ذلك مما يحتاج إلى معرفته بالأدلة العقلية، بل وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية، وإن كان لا يحتاج إليها؛ فإن كثيرًا من الأمور تعرف بالخبر الصادق، ومع هذا فالرسول بين الأدلة العقلية الدالة عليها، فجمع بين الطرفين: السمعي والعقلي.
وبينا أن دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين ليست بمجرد الخبر، كما تظنه طائفة من الغالطين من أهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم، بل الكتاب والسنة دلا الخلق وَهدَياهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين، وهؤلاء الغالطون الذين أعرضوا عما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية صاروا إذا صنفوا في أصول الدين أحزابًا:
حزب: يقدمون في كتبهم الكلام في النظر والدليل والعلم، وأن النظر يوجب العلم، وأنه واجب، ويتكلمون في جنس النظر وجنس الدليل وجنس العلم بكلام قد اختلط فيه الحق بالباطل، ثم إذا صاروا إلى ما هو الأصل والدليل للذين استدلوا بحدوث الأعراض على حدوث الأجسام، وهو دليل مبتدع في الشرع وباطل في العقل.
والحزب الثاني: عرفوا أن هذا الكلام مبتدع، وهو مستلزم مخالفة الكتاب والسنة، وعنه ينشأ القول بأن القرآن مخلوق، وأن / الله لا يرَي في الآخرة وليس فوق العرش، ونحو ذلك من بدع الجهمية، فصنفوا كتبًا قدموا فيها ما يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة من القرآن والحديث وكلام السلف، وذكروا أشياء صحيحة لكنهم قد يخلطون الآثار صحيحها بضعيفها، وقد يستدلون بما لا يدل على المطلوب.
وأيضًا، فهم إنما يستدلون بالقرآن من جهة أخباره لا من جهة دلالته، فلا يذكرون ما فيه من الأدلة على إثبات الربوبية والوحدانية والنبوة والمعاد، وأنه قد بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك؛ ولهذا سموا كتبهم أصول السنة والشريعة، ونحو ذلك، وجعلوا الإيمان بالرسول قد استقر، فلا يحتاج أن يبين الأدلة الدالة عليه، فذمهم أولئك ونسبوهم إلى الجهل؛ إذ لم يذكروا الأصول الدالة على صدق الرسول، وهؤلاء ينسبون أولئك إلى البدعة، بل إلى الكفر؛ لكونهم أصلوا أصولاً تخالف ما قاله الرسول.
والطائفتان يلحقهما الملام؛ لكونهمـا أعرضتا عن الأصــول التي بينها الله بكتابه، فإنهـــا أصول الدين وأدلته وآياته، فلما أعرض عنها الطائفتــان وقع بينها العداوة؛ كمــا قال الله تعالى: {فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: 14].
/ وحزب ثالث: قد عرف تفريط هؤلاء، وتعدِّي أولئك وبدعتهم، فذمهم وذم طالب العلم الذكي الذي اشتاقت نفسه إلى معرفة الأدلة، والخروج عن التقليد إذا سلك طريقهم، وقال: إن طريقهم ضارة، وإن السلف لم يسلكوها، ونحو ذلك مما يقتضي ذمها، وهو كلام صحيح، لكنه إنما يدل على أمر مجمل لا تتبين دلالته على المطلوب، بل قد يعتقد طريق المتكلمين مع قوله: إنه بدعة، ولا يفتح أبواب الأدلة التي ذكرها الله في القرآن التي تبين أن ما جاء به الرسول حق، ويخرج الذكي بمعرفتها عن التقليد وعن الضلال والبدعة والجهل.
فهؤلاء أضل بفرقهم؛ لأنهم لم يتدبروا القرآن، وأعرضوا عن آيات الله التي بينها بكتابه، كما يعرض من يعرض عن آيات الله المخلوقة، قال الله تعالى:{وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ} [يوسف: 105]، وقال تعالى: {وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ} [يونس: 101]، وقال تعالى: {إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} [يونس: 7، 8]، وقال تعالى: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} [ص: 29]، وقال تعالى: {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ} [الروم: 58]، وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ} الآية [النحل: 43، 44]، وقال/ تعالى: {وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ} [فاطر: 4]، وقال تعالى: {وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ} [فاطر: 25]، ومثل هذا كثير، لبسطه مواضع أُخر.
والمقصود أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا عما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية لا يذكرون النظر والدليل والعلم الذي جاء به الرسول، والقرآن مملوء من ذلك. والمتكلمون يعترفون بأن في القرآن من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين ما فيه، لكنهم يسلكون طرقًا أخر كطريق الأعراض.
ومنهم من يظن أن هذه طريق إبراهيم الخليل، وهو غالط.
والمتفلسفة يقولون: القرآن جاء بالطريق الخطابية والمقدمات الإقناعية التي تقنع الجمهور، ويقولون: إن المتكلمين جاؤوا بالطرق الجدلية، ويدعون أنهم هم أهل البرهان إلىقيني. وهم أبعد عن البرهان في الإلهيات من المتكلمين، والمتكلمون أعلم منهم بالعلميات البرهانية في الإلهيات والكليات، ولكن للمتفلسفة في الطبيعيات خوض وتفصيل تميزوا به، بخلاف الإلهيات فإنهم من أجهل الناس بها، وأبعدهم عن معرفة الحق فيها، وكلام أرسطو معلمهم فيها قليل كثير الخطأ، فهو لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقي ولا سمين فينتقي. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.
/ والقرآن جاء بالبينات والهدي؛ بالآيات البينات وهي الدلائل إلىقينيات، وقد قال الله تعالى لرسوله: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل:125]، والمتفلسفة يفسرون ذلك بطرقهم المنطقية في البرهان والخطابة والجدل، وهو ضلال من وجوه قد بسطت في غير هذا الموضع، بل الحكمة هي معرفة الحق والعمل به، فالقلوب التي لها فهم وقصد تدعي بالحكمة، فيبين لها الحق علمًا وعملاً فتقبله وتعمل به.
وآخرون يعترفون بالحق لكن لهم أهواء تصدهم عن اتباعه، فهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب في الحق والترهيب من الباطل. والوعظ أمر ونهي بترغيب وترهيب، كما قال تعالى:{وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ} [النساء: 66]، وقال تعالى: {يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا} [النور: 17]، فالدعوة بهذين الطريقين لمن قبل الحق، ومن لم يقبله فإنه يجادل بالتي هي أحسن.
والقرآن مشتمل على هذا وهذا؛ ولهذا إذا جادل يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية التي لا يمكن أحد أن يجحدها؛ لتقرير المخاطب بالحق ولاعترافه بإنكار الباطل، كما في مثل قوله: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ} [الطور: 35]، وقوله: {أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ} [ق: 15]، وقوله: {أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم} [يس: 81]، وقوله: {أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: 36 ـ 40]، وقوله: {أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ} [الواقعة: 58، 59]، وقوله: {وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى} [طه: 133]، وقوله: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ} [العنكبوت: 51]، وقوله: {أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ} [الشعراء: 197]، وقوله: {أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ} [البلد: 8 ـ10]، إلى أمثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام التقرير، المتضمن إقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهانية التي تدل على المطلوب، فهو من أحسن جدل بالبرهان؛ فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يسلم الخصم المقدمات وإن لم تكن بَيِّنَةٌ معروفة، فإذا كانت بينة معروفة كانت برهانية.
والقرآن لا يحتج في مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بها، كما هي الطريقة الجدلية عند أهل المنطق وغيرهم، بل بالقضايا والمقدمات التي تسلمها الناس، وهي برهانية، وإن كان بعضهم يسلمها، وبعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتها، كقوله: {وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ} [الأنعام: 91]، فإن الخطاب لما كان مع من يقر بنبوة موسى من أهل الكتاب، ومع من ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله:}قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى}، وقد بين البراهين الدالة على صدق موسى في غير موضع.
وعلى قراءة من قرأ: [يبدونها]؛ كابن كثير وأبي عمرو جعلوا الخطاب مع المشركين وجعلوا قوله:{وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ} احتجاجًا على المشركين بما جاء به محمد؛ فالحجة على أولئك نبوة موسى، وعلى هؤلاء نبوة محمد، ولكل منهما من البراهين ما قد بين بعضه في غير موضع.
وعلى قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب لأهل الكتاب، وقوله: {وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ} بيان لما جاءت به الأنبياء مما أنكروه، فعلمهم الأنبياء ما لم يقبلوه ولم يعلموه، فاستدل بما عرفوه من أخبار الأنبياء، وما لم يعرفوه.
وقد قص ـ سبحانه ـ قصة موسى، وأظهر براهين موسى وآياته التي هي من أظهر البراهين والأدلة، حتي اعترف بها السحرة الذين جمعهم فرعون، وناهيك بذلك، فلما أظهر الله حق موسى، وأتي بالآيات التي علم بالاضطرار أنها من الله، وابتلعت عصاه الحبال والعصي التي أتي / بها السحرة بعد أن جاؤوا بسحر عظيم، وسحروا أعين الناس واسترهبوا الناس، ثم لما ظهر الحق وانقلبوا صاغرين قالوا:{قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ} [الأعراف: 121، 122]، فقال لهم فرعون: {قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ}[طه: 71، 72]، من الدلائل البينات اليقينية القطعية، وعلى الذي فطـرنا؛ وهـو خالقنا وربنا الذي لابـد لنا منه، لن نؤثرك على هذه الدلائل اليقينية، وعلى خالق البرية {قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى}[طه: 72، 73].
وقد ذكر الله هذه القصة في عدة مواضع من القرآن، يبين في كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعًا غير النوع الآخر، كما يسمي الله ورسوله وكتابه بأسماء متعددة، كل اسم يدل على معني لم يدل عليه الاسم الآخر، وليس في هذا تكرار، بل فيه تنويع الآيات، مثل: أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل: محمد، وأحمد، والحاشِرُ، والعاقب، والمقفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة، في كل اسم دلالة على معني ليس في الاسم الآخر، وإن كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة.
/وكذلك القرآن إذا قيل فيه: قرآن، وفرقان، وبيان؛ وهدي، وبصائر، وشفاء، ونور، ورحمة، وروح، فكل اسم يدل على معني ليس هو المعني الآخر.
وكذلك أسماء الرب ـ تعالى ـ إذا قيل: الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، فكل اسم يدل على معني ليس هو المعني الذي في الاسم الآخر، فالذات واحدة والصفات متعددة، فهذا في الأسماء المفردة.
وكذلك في الجمل التامة، يعبر عن القصة بجمل تدل على معان فيها، ثم يعبر عنها بجمل أخري تدل على معان أخر، وإن كانت القصة المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها متعددة، ففي كل جملة من الجمل معني ليس في الجمل الأخر.
وليس في القرآن تكرار أصلاً، وأما ما ذكره بعض الناس من أنه كرر القصص مع إمكان الاكتفاء بالواحدة، وكان الحكمة فيه: أن وفود العرب كانت ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرئهم المسلمون شيئًا من القرآن، فيكون ذلك كافيا، وكان يبعث إلى القبائل / المتفرقة بالسور المختلفة، فلو لم تكن الآيات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم، وقصة عيسي إلى قوم، وقصة نوح إلى قوم، فأراد الله أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض، وأن يلقيها إلى كل سمع. فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره. وأبو الفرج اقتصر على هذا الجواب في قوله: {مَّثَانِيَ} [الزمر: 23] لما قيل: لم ثنيت؟ وبسط هذا له موضع آخر، فإن التثنية هي التنويع والتجنيس، وهي استيفاء الأقسام؛ ولهذا يقول من يقول من السلف: الأقسام والأمثال.
والمقصود هنا التنبيه على أن القرآن اشتمل على أصول الدين التي تستحق هذا الاسم، وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقينية، بخلاف ما أحدثه المبتدعون والملحدون، كما قال الرازي ـ مع خبرته بطرق هؤلاء ـ: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا، ولا تروي غليلاً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات:{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10]، [الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه:5]، واقرأ في النفي:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الشورى: 11]،{وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} [طه: 110]، قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
والخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر في نوعين: في العلم النافع، والعمل الصالح. وقد بعث الله محمدًا بأفضل ذلك وهو الهدي /ودين الحق، كما قال:{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} [الفتح: 28]، وقد قال تعالى:}وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ} [ص: 45]، فذكر النوعين. قال الوَالِبي عن ابن عباس يقول: أولو القوة في العبادة، قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير وعطاء الخراساني والحسن والضحاك والسدي وقتادة وأبي سنان ومبشر بن عبيد نحو ذلك. و{وَالْأَبْصَارِ} قال: الأبصار: الفقه في الدين. وقال مجاهد:{وَالْأَبْصَارِ} الصواب في الحكم. وعن سعيد بن جبير قال: البصيرة بدين الله وكتابه. وعن عطاء الخراساني:{أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ} قال: أولو القوة في العبادة والبصر والعلم بأمر الله. وعن مجاهد، وروي عن قتادة قال: أعطوا قوة في العبادة وبصرًا في الدين.
وجميع حكماء الأمم يفضلون هذين النوعين، مثل حكماء إلىونان والهند والعرب، قال ابن قُتَيبة: الحكمة عند العرب العلم والعمل، فالعمل الصالح هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو الدين دين الإسلام، والعلم والهدي هو تصديق الرسول فيما أخبر به عن الله وملائكته وكتبه ورسله وإلىوم الآخر، وغير ذلك، فالعلم النافع هو الإيمان، والعمل الصالح هـو الإسـلام، العلم النافع مـن علم الله، والعمـل الصالح هـو العمل بأمـر الله، هـذا تصـديق الرسول فيما أخبر، وهذا / طاعته فيما أمر. وضد الأول أن يقول على الله ما لا يعلم، وضد الثاني أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانًا، والأول أشرف، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات:14]، وجميع الطوائف تفضل هذين النوعين، لكن الذي جاء به الرسول هو أفضل ما فيهما، كما قال:{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء: 9].
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر تارة [سورة الإخلاص] و [قل يا أيها الكفرون] ، ففي [قل يا أيها الكافرون] عبادة الله وحده وهو دين الإسلام، وفي [قل هو الله أحد] صفة الرحمن، وأن يقال فيه ويخبر عنه بما يستحقه وهو الإيمان، هذا هو التوحيد القولي، وذلك هو التوحيد العملي.
وكان تارة يقرأ فيهما في الأولي بقوله في البقرة:{قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 136]، وفي الثانية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} إلى قوله:{فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64].
/قال أبو العالية في قوله: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الحجر: 92، 93]، قال: خلتان يسئل عنهما كل أحد: ماذا كنت تعبد؟ وماذا أجبت المرسلين؟ فالأولي تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثانية تحقيق الشهادة بأن محمدًا رسول الله.
والصوفية بنوا أمرهم على الإرادة ولابد منها، لكن بشرط أن تكون إرادة عبادة الله وحده بما أمر.
والمتكلمون بنـوا أمـرهم على النظـر المقتضي للعلم ولابد منه، لكن بشرط أن يكون علمًا بمـا أخـبر بـه الرسول صلى الله عليه وسلم، والنـظر في الأدلـة التي دل بها الرسـول وهي آيــات الله، ولابد من هذا وهذا.
ومن طلب علمًا بلا إرادة، أو إرادة بلا علم فهو ضال، ومن طلب هذا وهذا بدون اتباع الرسول فيهما فهو ضال، بل كما قال من قال من السلف: الدين والإيمان قول وعمل واتباع السنة. وأهل الفقه في الأعمال الظاهرة يتكلمون في العبادات الظاهرة، وأهل التصوف والزهد يتكلمون في قصد الإنسان وإرادته، وأهل النظر والكلام وأهل العقائد من أهل الحديث وغيرهم يتكلمون في العلم والمعرفة والتصديق الذي هو أصل الإرادة، ويقولون: العبادة لابد فيها من القصد، والقصد لا يصح إلا بعد العلم بالمقصود المعبود، وهذا صحيح،/ فلابد من معرفة المعبود وما يعبد به، فالضالون من المشركين والنصارى وأشباههم لهم عبادات وزهادات لكن لغير الله أو بغير أمر الله، وإنما القصد والإرادة النافعة هو إرادة عبادة الله وحده، وهو إنما يعبد بما شرع لا بالبدع.
وعلى هذين الأصلين يدور دين الإسلام: على أن يعبد الله وحده، وأن يعبد بما شرع، ولا يعبد بالبدع، وأما العلم والمعرفة والتصوف فمدارها على أن يعرف ما أخبر به الرسول، ويعرف أن ما أخبر به حق؛ إما لعلمنا بأنه لا يقول إلا حقًا، وهذا تصديق عام، وإما لعلمنا بأن ذلك الخبر حق بما أظهر الله من آيات صدقه، فإنه أنزل الكتاب والميزان، وأري الناس آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم أن القرآن حق.
 عدد المشاهدات *:
عدد المشاهدات *:
624457
 عدد مرات التنزيل *:
عدد مرات التنزيل *:
284028
 حجم الخط :
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013