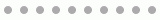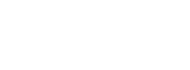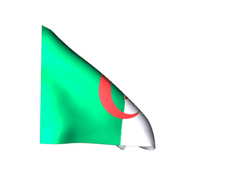وقَالَ ـ رحمَهُ الله:
أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين، والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرًا وتقريرًا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام في شرح القول في حكم منى الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة، وفي أرواث البهائم المباحة: أهى طاهرة أم نجسة؟ على وجه أحب أصحابنا تقييده، وما يقاربه من زيادة ونقصان، فكتبت لهم في ذلك، فأقول ولا حول ولا قوة إلا باللَّه.
هذا مبنى على أصل، وفصلين. أما الأصل:
فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة ـ على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها ـ أن تكون حلالا مطلقًا للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها، ومماستها، وهذه كلمة جامعة، ومقالة عامة، وقضية فاضلة عظيمة المنفعة، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة، فيما لا يحصى من الأعمال. وحوادث الناس، وقد دل عليها أدلة عشرة ـ مما حضرنى ذكره من الشريعة ـ وهى: كتاب الله، وسنة رسوله، واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء:59]، وقوله: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ} [المائدة: 55]. ثم مسالك القياس، والاعتبار، ومناهج الرأي، والاستبصار.
الصنف الأول: الكتاب، وهو عدة آيات.
الآية الأولى قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [البقرة: 29]، والخطاب لجميع الناس. لافتتاح الكلام بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ} [البقرة: 21]، ووجه الدلالة أنه أخبر، أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافًا إليهم باللام، واللام حرف الإضافة، وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه، واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له، وهذا المعنى يعم موارد استعمالها. كقولهم: المال لزيد، والسرج للدابة، وما أشبه ذلك فيجب إذًا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلاً من الله ونعمة، وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث؛ لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم، أو معادهم، فيبقى الباقي مباحًا بموجب الآية.
الآية الثانية: قوله تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، دلت الآية من وجهين:
أحدهما: أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاص، فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ؛ إذ لو كان حكمها مجهولا، أو كانت محظورة لم يكن ذلك.
الوجه الثاني: أنه قال: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119]، والتفصيل التبيين، فبين أنه بين المحرمات، فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم. وما ليس بمحرم فهو حلال؛ إذ ليس إلا حلال أو حرام.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ} [الجاثية:13]، وإذا كان ما في الأرض مسخرًا لنا، جاز استمتاعنا به كما تقدم.
الآية الرابعة: قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} الآية [الأنعام: 145]، فما لم يجد تحريمه، ليس بمحرم. وما لم يحرم، فهو حل، ومثل هذه الآية قوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ} الآية [البقرة: 173]؛ لأن حرف: [إنما] يوجب حصر الأول في الثاني، فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر. وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط في مواضع أخر.
الصنف الثاني: السنة والذي حضرني منها حديثان:
الحديث الأول: في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أعظم المسلمين جرمًا من يسأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته). دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص، لقوله: لم يحرم، ودل أن التحريم قد يكون لأجل المسألة، فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة، وهو المقصود.
الثاني: روى أبو داود في سننه عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه). فمنه دليلان:
أحدهما: أنه أفتى بالإطلاق فيه.
الثاني: قوله: (وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)، نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه فيه، وتسميته هذا عفوًا كأنه ـ والله أعلم ـ لأن التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص، والتحـريم المنع من التناول كذلك، والسكـوت عنه لم يؤذن بخطاب يخصه، ولم يمنع منه، فيرجع إلى الأصل، وهو ألا عقاب إلا بعد الإرسال، وإذا لم يكن فيه عقاب، لم يكن محرما وفي السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل.
الصنف الثالث: اتباع سبيل المؤمنين، وشهادة شهداء الله في أرضه الذين هم عدول الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المعصومين من اجتماعهم على ضلالة، المفروض اتباعهم، وذلك أنى لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين: في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور. وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين.
فإن قيل: كيف يكون في ذلك إجماع، وقد علمت اختلاف الناس في الأعيان قبل مجيء الرسل، وإنزال الكتب، هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة؟ أو لا يدرى ما الحكم فيها؟ أو أنه لا حكم لها أصلا؟ واستصحاب الحال دليل متبع، وأنه قد ذهب بعض من صنف في أصول الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب بعد الشرع، وأن من قال: بأن الأصل في الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل.
فأقول: هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين. ممن له قدم، وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجىء الرسل على الإطلاق، وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها، ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام، ولم يؤت تمييزًا في مظان الاشتباه، ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده. إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك حريم الإجماع، ولا يثلم سنن الاتباع.
ولقد اختلف الناس في تلك المسألة: هل هي جائزة أم ممتنعة؟ لأن الأرض لم تخل من نبى مرسل؛ إذ كان آدم نبيًا مكلمًا حسب اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن حكم مشروع، وإن كان الصواب عندنا جوازه.
ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة، إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك ألا عمل بها، وأنها نظر محض ليس فيه عمل. كالكلام في مبدأ اللغات وشبه ذلك، على أن الحق الذي لا راد له أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فإذًا لا تحريم يستصحب ويستدام، فيبقى الآن كذلك، والمقصود خلوها عن المآثم والعقوبات.
وأما مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر واجتهاد الرأى في الأصول الجوامع، فمن وجوه كثيرة ننبه على بعضها.
أحدها: أن الله ـ سبحانه ـ خلق هذه الأشياء وجعل فيها للإنسان متاعا ومنفعة. ومنها ما قد يضطر إليه وهو ـ سبحانه ـ جواد ماجد كريم رحيم غنى صمد، والعلم بذلك يدل على العلم بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على مجرد استمتاعه بهذه الأشياء وهو المطلوب.
وثانيها: أنها منفعة خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائر ما نص على تحليله، وهذا الوصف قد دل على تعلق الحكم به النص وهو قوله: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [الأعراف: 157]، فكل ما نفع فهو طيب، وكل ما ضر فهو خبيث. والمناسبة الواضحة لكل ذي لب، أن النفع يناسب التحليل، والضرر يناسب التحريم والدوران، فإن التحريم يدور مع المضار وجودًا: في الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات الأنياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر بأنفس الناس،وعدما:في الأنعام والألبان وغيرها.
وثالثها: أن هذه الأشياء إما أن يكون لها حكم أولا يكون، والأول صواب، والثاني باطل بالاتفاق، وإذا كان لها حكم، فالوجوب والكراهة والاستحباب معلومة البطلان بالكلية؛ لم يبق إلا الحل. والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصًا واستنباطًا، لم يبق إلا الحل وهو المطلوب.
إذا ثبت هذا الأصل فنقول: الأصل في الأعيان الطهارة لثلاثة أوجه:
أحدها: أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة. والنجس بخلافه، وأكثر الأدلة السالفة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء: أكلا وشربًا ولبسًا ومسًا وغير ذلك، فثبت دخول الطهارة في الحل، وهو المطلوب، والوجهان الآخران نافلة.
الثاني: أنه إذا ثبت أن الأصل جوازا أكلها وشربها فلأن يكون الأصل ملابستها ومخالطتها الخلق أولى وأحرى، وذلك لأن الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصرًا له، فإذا كان خبيثًا صار البدن خبيثًا فيستوجب النار؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به). والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. وأما ما يماس البدن ويباشره فيؤثر ـ أىضًا ـ في البدن من ظاهر كتأثير الأخباث في أبداننا وفي ثيابنا المتصلة بأبداننا، لكن تأثيرها دون تأثير المخالط الممازج. فإذا حل مخالطة الشيء وممازجته، فحل ملابسته ومباشرته أولى. وهذا قاطع لا شبهة فيه. وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته وملابسته، حرم مخالطته وممازجته، ولا ينعكس. فكل نجس محرم الأكل، وليس كل محرم الأكل نجسًا. وهذا في غاية التحقيق.
الوجه الثالث: أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك. فإنه غاية المتقابلات. تجد أحد الجانبين فيها محصورًا مضبوطًا والجانب الآخر مطلق مرسل والله ـ تعالى ـ الهادي للصواب.
أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين، والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرًا وتقريرًا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام في شرح القول في حكم منى الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة، وفي أرواث البهائم المباحة: أهى طاهرة أم نجسة؟ على وجه أحب أصحابنا تقييده، وما يقاربه من زيادة ونقصان، فكتبت لهم في ذلك، فأقول ولا حول ولا قوة إلا باللَّه.
هذا مبنى على أصل، وفصلين. أما الأصل:
فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة ـ على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها ـ أن تكون حلالا مطلقًا للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها، ومماستها، وهذه كلمة جامعة، ومقالة عامة، وقضية فاضلة عظيمة المنفعة، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة، فيما لا يحصى من الأعمال. وحوادث الناس، وقد دل عليها أدلة عشرة ـ مما حضرنى ذكره من الشريعة ـ وهى: كتاب الله، وسنة رسوله، واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء:59]، وقوله: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ} [المائدة: 55]. ثم مسالك القياس، والاعتبار، ومناهج الرأي، والاستبصار.
الصنف الأول: الكتاب، وهو عدة آيات.
الآية الأولى قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [البقرة: 29]، والخطاب لجميع الناس. لافتتاح الكلام بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ} [البقرة: 21]، ووجه الدلالة أنه أخبر، أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافًا إليهم باللام، واللام حرف الإضافة، وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه، واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له، وهذا المعنى يعم موارد استعمالها. كقولهم: المال لزيد، والسرج للدابة، وما أشبه ذلك فيجب إذًا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلاً من الله ونعمة، وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث؛ لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم، أو معادهم، فيبقى الباقي مباحًا بموجب الآية.
الآية الثانية: قوله تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، دلت الآية من وجهين:
أحدهما: أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاص، فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ؛ إذ لو كان حكمها مجهولا، أو كانت محظورة لم يكن ذلك.
الوجه الثاني: أنه قال: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119]، والتفصيل التبيين، فبين أنه بين المحرمات، فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم. وما ليس بمحرم فهو حلال؛ إذ ليس إلا حلال أو حرام.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ} [الجاثية:13]، وإذا كان ما في الأرض مسخرًا لنا، جاز استمتاعنا به كما تقدم.
الآية الرابعة: قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} الآية [الأنعام: 145]، فما لم يجد تحريمه، ليس بمحرم. وما لم يحرم، فهو حل، ومثل هذه الآية قوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ} الآية [البقرة: 173]؛ لأن حرف: [إنما] يوجب حصر الأول في الثاني، فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر. وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط في مواضع أخر.
الصنف الثاني: السنة والذي حضرني منها حديثان:
الحديث الأول: في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أعظم المسلمين جرمًا من يسأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته). دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص، لقوله: لم يحرم، ودل أن التحريم قد يكون لأجل المسألة، فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة، وهو المقصود.
الثاني: روى أبو داود في سننه عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه). فمنه دليلان:
أحدهما: أنه أفتى بالإطلاق فيه.
الثاني: قوله: (وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)، نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه فيه، وتسميته هذا عفوًا كأنه ـ والله أعلم ـ لأن التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص، والتحـريم المنع من التناول كذلك، والسكـوت عنه لم يؤذن بخطاب يخصه، ولم يمنع منه، فيرجع إلى الأصل، وهو ألا عقاب إلا بعد الإرسال، وإذا لم يكن فيه عقاب، لم يكن محرما وفي السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل.
الصنف الثالث: اتباع سبيل المؤمنين، وشهادة شهداء الله في أرضه الذين هم عدول الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المعصومين من اجتماعهم على ضلالة، المفروض اتباعهم، وذلك أنى لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين: في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور. وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين.
فإن قيل: كيف يكون في ذلك إجماع، وقد علمت اختلاف الناس في الأعيان قبل مجيء الرسل، وإنزال الكتب، هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة؟ أو لا يدرى ما الحكم فيها؟ أو أنه لا حكم لها أصلا؟ واستصحاب الحال دليل متبع، وأنه قد ذهب بعض من صنف في أصول الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب بعد الشرع، وأن من قال: بأن الأصل في الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل.
فأقول: هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين. ممن له قدم، وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجىء الرسل على الإطلاق، وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها، ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام، ولم يؤت تمييزًا في مظان الاشتباه، ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده. إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك حريم الإجماع، ولا يثلم سنن الاتباع.
ولقد اختلف الناس في تلك المسألة: هل هي جائزة أم ممتنعة؟ لأن الأرض لم تخل من نبى مرسل؛ إذ كان آدم نبيًا مكلمًا حسب اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن حكم مشروع، وإن كان الصواب عندنا جوازه.
ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة، إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك ألا عمل بها، وأنها نظر محض ليس فيه عمل. كالكلام في مبدأ اللغات وشبه ذلك، على أن الحق الذي لا راد له أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فإذًا لا تحريم يستصحب ويستدام، فيبقى الآن كذلك، والمقصود خلوها عن المآثم والعقوبات.
وأما مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر واجتهاد الرأى في الأصول الجوامع، فمن وجوه كثيرة ننبه على بعضها.
أحدها: أن الله ـ سبحانه ـ خلق هذه الأشياء وجعل فيها للإنسان متاعا ومنفعة. ومنها ما قد يضطر إليه وهو ـ سبحانه ـ جواد ماجد كريم رحيم غنى صمد، والعلم بذلك يدل على العلم بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على مجرد استمتاعه بهذه الأشياء وهو المطلوب.
وثانيها: أنها منفعة خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائر ما نص على تحليله، وهذا الوصف قد دل على تعلق الحكم به النص وهو قوله: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [الأعراف: 157]، فكل ما نفع فهو طيب، وكل ما ضر فهو خبيث. والمناسبة الواضحة لكل ذي لب، أن النفع يناسب التحليل، والضرر يناسب التحريم والدوران، فإن التحريم يدور مع المضار وجودًا: في الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات الأنياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر بأنفس الناس،وعدما:في الأنعام والألبان وغيرها.
وثالثها: أن هذه الأشياء إما أن يكون لها حكم أولا يكون، والأول صواب، والثاني باطل بالاتفاق، وإذا كان لها حكم، فالوجوب والكراهة والاستحباب معلومة البطلان بالكلية؛ لم يبق إلا الحل. والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصًا واستنباطًا، لم يبق إلا الحل وهو المطلوب.
إذا ثبت هذا الأصل فنقول: الأصل في الأعيان الطهارة لثلاثة أوجه:
أحدها: أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة. والنجس بخلافه، وأكثر الأدلة السالفة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء: أكلا وشربًا ولبسًا ومسًا وغير ذلك، فثبت دخول الطهارة في الحل، وهو المطلوب، والوجهان الآخران نافلة.
الثاني: أنه إذا ثبت أن الأصل جوازا أكلها وشربها فلأن يكون الأصل ملابستها ومخالطتها الخلق أولى وأحرى، وذلك لأن الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصرًا له، فإذا كان خبيثًا صار البدن خبيثًا فيستوجب النار؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به). والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. وأما ما يماس البدن ويباشره فيؤثر ـ أىضًا ـ في البدن من ظاهر كتأثير الأخباث في أبداننا وفي ثيابنا المتصلة بأبداننا، لكن تأثيرها دون تأثير المخالط الممازج. فإذا حل مخالطة الشيء وممازجته، فحل ملابسته ومباشرته أولى. وهذا قاطع لا شبهة فيه. وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته وملابسته، حرم مخالطته وممازجته، ولا ينعكس. فكل نجس محرم الأكل، وليس كل محرم الأكل نجسًا. وهذا في غاية التحقيق.
الوجه الثالث: أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك. فإنه غاية المتقابلات. تجد أحد الجانبين فيها محصورًا مضبوطًا والجانب الآخر مطلق مرسل والله ـ تعالى ـ الهادي للصواب.
 عدد المشاهدات *:
عدد المشاهدات *:
362139
 عدد مرات التنزيل *:
عدد مرات التنزيل *:
250976
 حجم الخط :
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013