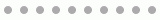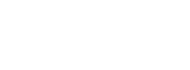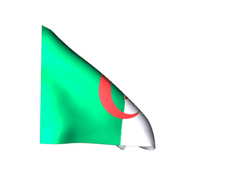البهيمة، أو متولد منها، فيلحق سائرها قياسًا لبعض الشيء على جملته.
فإن قيل: هذا منقوض بالإنسان فإنه طاهر ولبنه طاهر، وكذلك سائر أمواهه وفضلاته، ومع هذا فروثه وبوله من أخبث الأخباث، فحصل الفرق فيه بين البول وغيره.
فنقول: اعلم أن الإنسان فارق غيره من الحيوان في هذا الباب طردًا وعكسًا، فقياس البهائم بعضها ببعض وجعلها في حيز يباين حيز الإنسان، وجعل الإنسان في حيز هو الواجب، ألا ترى أنه لا ينجس بالموت على المختار، وهي تنجس بالموت، ثم بوله أشد من بولها؟
ألا ترى أن تحريمه مفارق لتحريم غيره من الحيوان، لكرم نوعه وحرمته، حتى يحرم الكافر وغيره، وحتى لا يحل أن يدبغ جلده، مع أن بوله أشد وأغلظ، فهذا وغيره يدل على أن بول الإنسان فـارق سائر فضـلاته، أشـد من مفارقة بول البهائم فضلاتها، إما لعمـوم مـلابسته حتى لا يستخف بـه، أو لغـير ذلك مما الله أعلم به، على أنه يقال: في عـذرة الإنسان وبولـه من الخبث والنتن والقذر ما ليس في عامة الأبوال والأرواث. وفي الجملـة، فإلحـاق الأبوال باللحـوم في الطهارة والنجاسـة أحسـن طردًا من غيره. والله أعلم.
وأما الوجه الثاني: فنقول: ذلك الأصل في الآدميين مسلم، والذي جاء عن السلف إنما جاء فيهم من الاستحالة في أبدانهم، وخروجه من الشق الأعلى أو الأسفل. فمن أين يقال: كذلك سائر الحيوان، وقد مضت الإشارة إلى الفرق؟! ثم مخالفوهم يمنعونهم أكثر الأحكام في البهائم، فيقولون: قد ثبت أن ما خبث لحمه، خبث لبنه ومنيه، بخلاف الآدمى، فبطلت هذه القاعدة في الاستحالة، بل قد يقولون: إن جميع الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواء، فما طاب لحمه طاب لبنه وبوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه ودمعه. وما خبث لحمه، خبث لبنه وريقه وبوله وروثه ومنيه وعرقه ودمعه، وهذا قول يقوله أحمد في المشهور عنه، وقد قاله غيره.
وبالجملة، فاللبن والمني يشهد لهم بالفرق بين الإنسان والحيوان شهادة قاطعة، وباستواء الفضلات من الحيوان ضربا من الشهادة، فعلى هذا، يقال للإنسان: يفرق بين ما يخرج من أعلاه وأسفله لما الله أعلم به، فإنه منتصب القامة نجاسته كلها في أعاليه، ومعدته التي هي محل استحالة الطعام والشراب في الشق الأسفل.وأما الثدى ونحوه فهو في الشق الأعلى، وليس كذلك البهيمة. فإن ضرعها في الجانب المؤخر منها، وفيه اللبن الطيب، ولا مطمع في إثبات الأحكام بمثل هذه الحزورات.
وأما الوجه الثالث: فمداره على الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات فإن فصل بنوع الاستقذار، بطل بجميع المستقذرات التي ربما كانت أشد استقذارا منه، وإن فصل بقدر خاص، فلابد من توقيته، وقد مضى تقرير هذا.
وأما الجواب العام، فمن أوجه ثلاثة:
أحدها: أن هذا قياس في مقابلة الآثار المنصوصة، وهو قياس فاسد الوضع، ومن جمع بين ما فرقت السنة بينه، فقد ضاهي قول الذين قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، ولذلك طهرت السنة هذا ونجست هذا.
الثاني: أن هذا قياس في باب لم تظهر أسبابه وأنواطه، ولم يتبين مأخذه وما...، بل الناس فيه على قسمين: إما قائل يقول هذا استبعاد محض، وابتلاء صرف، فلا قياس ولا إلحاق ولا اجتماع ولا افتراق. وإما قائل يقول: دقت علينا علله وأسبابه، وخفيت علينا مسالكه ومذاهبه، وقد بعث الله إلينا رسولا يزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، بعثه إلينا ونحن لا نعلم شيئًا، فإنما نصنع ما رأيناه يصنع، والسنة لا تضرب لها الأمثال، ولا تعارض بآراء الرجال، والدين ليس بالرأى ويجب أن يتهم الرأى على الدين، والقياس في مثل هذا الباب ممتنع باتفاق أولى الألباب.
الثالث: أن يقال: هذا كله مداره على التسوية بين بول ما يؤكل لحمه، وبول ما لا يؤكل لحمه، وهو جمع بين شيئين مفترقين، فإن ريح المحرم خبيثة، وأما ريح المباح فمنه ما قد يستطاب: مثل أرواث الظباء، وغيرها. وما لم يستطب منه فليس ريحه كريح غيره، وكذلك خلقه غالبًا. فإنه يشتمل على أشياء من المباح، وهذا لأن الكلام في حقيقة المسألة، وسنعود إليه إن شاء الله في آخرها.
الدليل الثاني: الحديث المستفيض، أخرجه أصحاب الصحيح وغيرهم من حديث أنس ابن مالك: أن ناسًا من عُكْل أو عُرَينة قدموا المدينة فاجتووها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحُّوا قتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود . وذكر الحديث. فوجه الحجة أنه أذن لهم في شرب الأبوال، ولابد أن يصيب أفواههم وأيديهم وثيابهم وآنيتهم، فإذا كانت نجسة وجب تطهير أفواههم وأيديهم وثيابهم للصلاة، وتطهير آنيتهم، فيجب بيان ذلك لهم؛ لأن تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوز، ولم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليهم إماطة ما أصابهم منه، فدل على أنه غير نجس، ومن البين أن لو كانت أبوال الإبل كأبوال الناس، لأوشك أن يشتد تغليظه في ذلك.
ومن قال: إنهم كانوا يعلمون أنها نجسة، وأنهم كانوا يعلمون وجوب التطهير من النجاسات، فقد أبعد غاية الإبعاد، وأتى بشيء قد يستيقن بطلانه لوجوه:
أحدها: أن الشريعة أول ما شرعت كانت أخفي، وبعد انتشار الإسلام وتناقل العلم وإفشائه، صارت أبدى وأظهر، وإذا كنا إلى اليوم لم يستبن لنا نجاستها، بل أكثر الناس على طهارتها، وعامة التابعين عليه، بل قد قال أبو طالب وغيره: إن السلف ما كانوا ينجسونها. ولا يتقونها. وقال أبو بكر ابن المنذر: وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف، وقد ذكر طهارة الأبوال عن عامة السلف. ثم قال: قال الشافعي: الأبوال كلها نجس. قال: ولا نعلم أحدًا قال قبل الشافعي أن أبوال الأنعام وأبعارها نجس.
قلت: وقد نقل عن ابن عمر أنه سئل عن بول الناقة، فقال: اغسل ما أصابك منه. وعن الزهري فيما يصيب الراعي من أبوال الإبل قال: ينضح. وعن حماد بن أبي سليمان في بول الشاه والبعير: يغسل. ومذهب أبي حنيفة نجاسة ذلك على تفصيل لهم فيه. فلعل الذي أراده ابن المنذر، القول بوجوب اجتناب قليل البول والروث وكثيره، فإن هذا لم يبلغنا عن أحد من السلف، ولعل ابن عمر أمر بغسله كما يغسل الثوب من المخاط والبصاق والمني ونحو ذلك. وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري أنه صلى على مكان فيه روث الدواب والصحراء أمامه. وقال ههنا وههنا سواء. وعن أنس بن مالك لا بأس ببول كل ذي كرش.
ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستها، بل القول بطهارتها، إلا ما ذكر عن ابن عمر إن كان أراد النجاسة فمن أين يكون ذلك معلوم لأولئك؟!
وثانيها: أنه لو كان نجسًا فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الأمور البينة، قد أنكره في الثياب طائفة من التابعين وغيرهم. فمن أين يعلمه أولئك؟
وثالثها: أن هذا لو كان مستفيضًا بين ظهرانى الصحابة، لم يجب أن يعلمه أولئك؛ لأنهم حديثو العهد بالجاهلية والكفر، فقد كانوا يجهلون أصناف الصلوات وأعدادها وأوقاتها، وكذلك غيرها من الشرائع الظاهرة، فجهلهم بشرط خفي في أمر خفي أولى وأحرى، لاسيما والقوم لم يتفقهوا في الدين أدنى تفقه، ولذلك ارتدوا ولم يخالطوا أهل العلم والحكمة، بل حين أسلموا وأصابهم الاستيخام، أمرهم بالبداوة فيا ليت شعري، من أين لهم العلم بهذا الأمر الخفي؟!
ورابعها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في تعليمه وإرشاده واكلاً للتعليم إلى غيره، بل يبين لكل واحد ما يحتاج إليه، وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة بالسنن الماضية.
وخامسها: أنه ليس العلم بنجاسة هذه الأرواث أبين من العلم بنجاسة بول الإنسان الذي قد علمه العذارى في حجالهن وخدورهن، ثم قد حذر منه للمهاجرين والأنصار الذين أوتوا العلم والإيمان، فصار الأعراب الجفاة أعلم بالأمور الخفية من المهاجرين والأنصار بالأمور الظاهرة، فهذا كما ترى.
وسادسها: أنه فرق بين الأبوال والألبان وأخرجهما مخرجًا واحدًا. والقران بين الشيئين ـ إن لم يوجب استواءهما ـ فلابد أن يورث شبهة، فلو لم يكن البيان واجبًا، لكانت المقارنة بينه وبين الطاهر موجبة للتمييز بينهما إن كان التمييز حقًا.
وفي الحديث دلالة أخرى فيها تنازع، وهو أنه أباح لهم شربها، ولو كانت محرمة نجسة لم يبح لهم شربها، ولست أعلم مخالفًا في جواز التداوي بأبوال الإبل. كما جاءت السنة؛ لكن اختلفوا في تخريج مناطه فقيل: هو أنها مباحة على الإطلاق، للتداوى وغير التداوي. وقيل: بل هي محرمة، وإنما أباحها للتداوي. وقيل: هي مع ذلك نجسة، والاستدلال بهذا الوجه يحتاج إلى ركن آخر، وهو أن التداوي بالمحرمات النجسة محرم، والدليل عليه من وجوه:
أحدها: أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]، و(كل ذي ناب من السباع حرام). و{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ} [المائدة: 90]، عامة في حال التداوي وغير التداوي، فمن فرق بينهما، فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم، وذلك غير جائز.
فإن قيل: فقد أباحها للضرورة، والمتداوي مضطر فتباح له، أو أنا نقيس إباحتها للمريض على إباحتها للجائع بجامع الحاجة إليها.
يؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام في الصلاة والصيام في شهر رمضان، والانتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد. فكذلك يبيح المحارم؛ لأن الفرائض والمحارم من واد واحد.
يؤيد ذلك أن المحرمات من الحلية واللباس مثل الذهب والحرير قد جاءت السنة بإباحة اتخاذ الأنف من الذهب. وربط الأسنان به، ورخص للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة كانت بهما، فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات حين الاحتياج. والافتقار إليها.
قلت: أما إباحتها للضرورة فحق، وليس التداوي بضرورة لوجوه:
أحدها: أن كثيرًا من المرضى أو أكثر المرضى يشفون بلا تداوٍ، لاسيما في أهل الوبر والقرى. والساكنين في نواحي الأرض يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل، أو دعوة مستجابة، أو رقية نافعة، أو قوة للقلب، وحسن التوكل، إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء. وأما الأكل فهو ضروري، ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاء، فلو لم يكن يأكل لمات. فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء.
وثانيها: أن الأكل عند الضرورة واجب. قال مسروق: من اضطر إلى الميتة، فلم يأكل فمات، دخل النار، والتداوي غير واجب ومن نازع فيه: خصمته السنة في المرأة السوداء التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على البلاء ودخول الجنة، وبين الدعاء بالعافية. فاختارت البلاء والجنة. ولو كان رفع المرض واجبًا، لم يكن للتخيير موضع، كدفع الجوع، وفي دعائه لأبي بالحمى، وفي اختياره الحمى لأهل قباء، وفي دعائه بفناء أمته بالطعن والطاعون، وفي نهيه عن الفرار من الطاعون.
وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء، حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له مثل أيوب ـ عليه السلام ـ وغيره.
وخصمه حال السلف الصالح، فإن أبا بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ حين قالوا له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إني فعال لما أريد. ومثل هذا ونحوه يروي عن الربيع بن خيثم المخبت المنيب الذي هو أفضل الكوفيين، أو كأفضلهم وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الهادي المهدي، وخلق كثير لا يحصون عددًا.
ولست أعلم سالفًا أوجب التداوي، وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلاً واختيارًا لما اختار الله ورضى به، وتسليمًا له. وهذا المنصوص عن أحمد وإن كان من أصحابه من يوجبه، ومنهم من يستحبه، ويرجحه. كطريقة كثير من السلف استمساكًا لما خلقه الله من الأسباب، وجعله من سنته في عباده.
وثالثها: أن الدواء لا يستيقن، بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض؛ إذ لو اطرد ذلك لم يمت أحد، بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة، فإنه مستيقن بحكم سنة الله في عباده وخلقه.
ورابعها: أن المرض يكون له أدوية شتى، فإذا لم يندفع بالمحرم، انتقل إلى المحلل، ومحال ألا يكون له في الحلال شفاء أو دواء، والذي أنزل الداء، أنزل لكل داء دواء إلا الموت، ولا يجوز أن يكون أدوية الأدواء في القسم المحرم، وهو سبحانه الرؤوف الرحيم. وإلى هذا، الإشارة بالحديث المروي: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)، بخلاف المسغبة فإنها ـ وإن اندفعت بأي طعام ـ اتفق، إلا أن الخبيث إنما يباح عند فقد غيره، فإن صورت مثل هذا في الدواء فتلك صورة نادرة؛ لأن المرض أندر من الجوع بكثير، وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر، فلا ينتقض هذا . على أن في الأوجه السالفة غنى.
وخامسها: ـ وفيه فقه الباب ـ: أن الله ـ تعالى ـ جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام والغذاء، لا تندفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة. وأما المرض، فإنه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب: ظاهرة وباطنة، روحانية وجسمانية، فلم يتعين الدواء مزيلاً، ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من أنواع الأجسام في إزالة الداء المعين. ثم ذلك النوع المعين يخفي على أكثر الناس، بل على عامتهم دركه ومعرفته الخاصة، المزاولون منهم هذا الفن، أولو الأفهام والعقول، يكون الرجل منهم قـد أفنى كثيرًا مـن عمره في معرفته ذلك، ثم يخفي عليه نوع المرض وحقيقته، ويخفي عليه دواؤه وشفاؤه، ففارقت الأسباب المزيلة للمرض، الأسباب المزيلة للمخمصة في هذه الحقائق البينة وغيرها. فكذلك افترقت أحكامها كما ذكرنا. وبهذا ظهر الجواب عن الأقيسة المذكورة، والقول الجامع فيما يسقط ويباح للحاجة والضرورة ما حضرني الآن.
أما سقوط ما يسقط من القيام والصيام، والاغتسال؛ فلأن منفعة ذلك مستيقنة بخلاف التداوي.
وأيضًا، فإن ترك المأمور به أيسر من فعل المنهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا نهيتكم عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم) فانظر كيف أوجب الاجتناب عن كل منهي عنه، وفرق في المأمور به بين المستطاع وغيره، وهذا يكاد يكون دليلاً مستقلاً في المسألة.
وأيضًا، فإن الواجبات من القيام والجمعة والحج، تسقط بأنواع من المشقة التي لا تصلح لاستباحة شيء من المحظورات، وهذا بين بالتأمل.
وأما الحلية، فإنما أبيح الذهب للأنف، وربط الأسنان؛ لأنه اضطرار، وهو يسد الحاجة يقينًا كالأكل في المخمصة.
وأما لبس الحرير للحكة والجرب إن سلم ذلك. فإن الحرير والذهب ليسا محرمين على الإطلاق، فإنهما قد أبيحا لأحد صنفي المكلفين، وأبيح للصنف الآخر بعضهما، وأبيح التجارة فيهما، وإهداؤهما للمشركين. فعُلم أنهما أبيحا لمطلق الحاجة، والحاجة إلى التداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساء، بخلاف المحرمات من النجاسات. وأبيح ـ أيضا ـ لحصول المصلحة في غالب الأمر.
ثم الفرق بين الحرير والطعام: أن باب الطعام يخالف باب اللباس؛ لأن تأثير الطعام في الأبدان، أشد من تأثير اللباس، على ما قد مضي. فالمحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة التي هي المسغبة والمخمصة والمحرم من اللباس، يباح للضرورة وللحاجة -أيضا. هكذا جاءت السنة، ولا جمع بين ما فرق الله بينه. والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم في كثير من الشرعيات، وقد حصل الجواب عن كل ما يعارض به في هذه المسألة.
الوجه الثاني: أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أيتداوي بها؟ فقال: (إنها داء، وليست بدواء).
فهذا نص في المنع من التداوي بالخمر، ردًا على من أباحه، وسائر المحرمات مثلها قياسًا، خلافًا لمن فرق بينهما، فإن قياس المحرم من الطعام أشبه من الغراب بالغراب، بل الخمر قد كانت مباحة في بعض أيام الإسلام، وقد أباح بعض المسلمين من نوعها الشرب دون الإسكار والميتة والدم بخلاف ذلك.
فإن قيل: الخمر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست بدواء، فلا يجوز أن يقال: هي دواء بخلاف غيرها. وأيضا، ففي إباحة التداوي بها إجازة اصطناعها واعتصارها، وذلك داع إلى شربها. ولذلك اختصت بالحد بها دون غيرها من المطاعم الخبيثة لقوة محبة الأنفس لها.
فأقول: أما قولك: لا يجوز أن يقال: هي دواء، فهو حق، وكذلك القول في سائر المحرمات على ما دل عليه الحديث الصحيح (إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام) ثم ماذا تريد بهذا؟ أتريد أن الله لم يخلق فيها قوة طبيعية من السخونة وغيرها؟ جرت العادة في الكفار والفساق أنه يندفع بها بعض الأدواء الباردة، كسائر القوي والطبائع التي أودعها جميع الأدوية من الأجسام، أم تريد شيئًا آخر؟ فإن أردت الأول، فهو باطل بالقضايا المجربة التي تواطأت عليها الأمم، وجرت عند كثير من الناس مجري الضروريات، بل هو رد لما يشاهد ويعاين. بل قد قيل: إنه رد للقرآن؛ لقوله تعالى: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ } [البقرة:219]، ولعل هذا في الخمر أظهر من جميع المقالات المعلومة من طيب الأبدان.
وإن أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها داء للنفوس والقلوب والعقول -وهي أم الخبائث- والنفس والقلب هو الملك المطلوب صلاحه وكماله، وإنما البدن آلة له، وهو تابع له مطيع له طاعة الملائكة ربها، فإذا صلح القلب صلح البدن كله، وإذا فسد القلب فسد البدن كله فالخمر هي داء ومرض للقلب مفسد له، مضعضع لأفضل خواصه الذي هو العقل والعلم، وإذا فسد القلب، فسد البدن كله، كما جاءت به السنة، فتصير داء للبدن من هذا الوجه بواسطة كونها داء للقلب. وكذلك جميع الأموال المغصوبة والمسروقة فإنه ربما صلح عليها البدن ونبت وسمن لكن يفسد عليها القلب فيفسد البدن بفساده.
وأما المصلحة التي فيها، فإنها منفعة للبدن فقط، ونفعها متاع قليل فهي ـ وإن أصلحت شيئا يسيرًا ـ فهي في جنب ما تفسده كَلاَ إصلاح وهذا بعينه معني قوله تعالى: {فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا } [البقرة: 219]، فهذا لعمري شأن جميع المحرمات. فإن فيها من القوة الخبيثة التي تؤثر في القلب، ثم البدن في الدنيا والآخرة ما يربي على ما فيها من منفعة قليلة تكون في البدن وحده في الدنيا خاصة.
على أنا ـ وإن لم نعلم جهة المفسدة في المحرمات- فإنا نقطع أن فيها من المفاسد ما يربي على ما نظنه من المصالح. فافهم هذا فإن به يظهر فقه المسألة وسرها.
وأما إفضاؤه إلى اعتصارها، فليس بشيء؛ لأنه يمكن أخذها من أهل الكتاب على أنه يحرم اعتصارها، وإنما القول إذا كانت موجودة أن هذا منتقض بإطفاء الحرق بها، ودفع الغصة إذا لم يوجد غيرها.
وأما اختصاصها بالحد، فإن الحسن البصري يوجب الحد في الميتة ـ أيضًا ـ والدم ولحم الخنزير، لكن الفرق أن في النفوس داعيًا طبيعيًا وباعثًا إراديًا إلى الخمر، فنصب رادع شرعي وزاجر دنيوي ـ أيضا ـ ليتقابلا، ويكون مدعاة إلى قلة شربها، وليس كذلك غيرها مما ليس في النفوس إليه كثير ميل، ولا عظيم طلب.
الوجه الثالث: ما روي حسان بن مخارق قال: قالت أم سلمة: اشتكت بنت لي فنبذت لها في كوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، فقال: (ما هذا؟) فقلت: إن بنتي اشتكت فنبذنا لها هذا، فقال: (إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام). رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه ـ وفي رواية: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وصححه بعض الحفاظ وهذا الحديث نص في المسألة.
الوجه الرابع: ما رواه أبو داود في السنن: أن رجلاً وصف له ضفدع يجعلها في دواء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال: (إن نقنقتها تسبيح)، فهذا حيوان محرم ولم يبح للتداوي.
وهو نص في المسألة. ولعل تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث وغيرها، فإنه أكثر ما قيل فيها: أن نقنقتها تسبيح، فما ظنك بالخنزير والميتة وغير ذلك؟ وهذا كله بين لك استخفافه بطلب الطب واقتضائه وإجرائه مجري الرفق بالمريض وتطييب قلبه، ولهذا قال الصادق المصدوق لرجل: قال له: أنا طبيب، قال: (أنت رفيق والله الطبيب).
الوجه الخامس: ما روي ـ أيضًا ـ في سننه ـ يعني: أبا داود ـ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، وهو نص جامع مانع، وهو صورة الفتوي في المسألة.
الوجه السادس: الحديث المرفوع: (ما أبالى ما أتيت ـ أو ما ركبت ـ إذا شربت ترياقا، أو تعلقت تميمة، أو قلت الشعر من نفسي)، مع ما روي من كراهة من كره الترياق من السلف على أنه لم يقابل ذلك نص عام، ولا خاص يبلغ ذروة المطلب، وسنام المقصد في هذا الموضع ولولا أني كتبت هذا من حفظي لاستقصيت القول على وجه يحيط بما دق وجل، والله الهادي إلى سواء السبيل.
الدليل الثالث- وهو في الحقيقة رابع: الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: (صلوا فيها فإنها بركة). وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؛ فقال: (لا تصلوا فيها فإنها خلقت من الشياطين). ووجه الحجة من وجهين:
أحدهما: أنه أطلق الإذن بالصلاة، ولم يشترط حائلاً يقي من ملامستها والموضع موضع حاجة إلى البيان، فلو احتاج لبينه، وقد مضي تقرير هذا. وهذا شبيه بقول الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقام. فإنه ترك استفصال السائل: أهناك حائل يحول بينك وبين أبعارها؟ مع ظهور الاحتمال، ليس مع قيامه فقط، وأطلق الإذن، بل هذا أوكد من ذلك؛ لأن الحاجة هنا إلى البيان أمس وأوكد.
والوجه الثاني: أنها لو كانت نجسة كأرواث الآدميين لكانت الصلاة فيها إما محرمة كالحشوش، والكنف، أو مكروهة كراهية شديدة؛ لأنها مظنة الأخباث والأنجاس. فأما أن يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة ويكون شأنها شأن الحشوش أو قريبًا من ذلك فهو جمع بين المتنافيين المتضادين، وحاشًا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك.
ويؤيد هذا ما روي أن أبا موسي صلي في مبارك الغنم، وأشار إلى البرية وقال: ههنا وثَمَّ سواء. وهو الصاحب الفقيه العالم بالتنزيل، الفاهم للتأويل، سوي بين محل الأبعار وبين ما خلا عنها، فكيف يجامع هذا القول بنجاستها؟!
وأما نهيه عن الصلاة في مبارك الإبل، فليست اختصت به دون البقر والغنم والظباء والخيل، إذ لو كان السبب نجاسة البول، لكان تفريقًا بين المتماثلين، وهو ممتنع يقينا.
الدليل الرابع- وهو في الحقيقة سابع: ما ثبت واستفاض من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته، وأدخلها المسجد الحرام الذي فضله الله على جميع بقاع الأرض، وبركها حتي طاف أسبوعًا. وكذلك إذنه لأم سلمة أن تطوف راكبة، ومعلوم أنه ليس مع الدواب من العقل ما تمتنع به من تلويث المسجد المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، فلو كانت أبوالها نجسة، لكان فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس، مع أن الضرورة ما دعت إلى ذلك، وإنما الحاجة دعت إليه، ولهذا استنكر بعض من يري تنجيسها إدخال الدواب المسجد الحرام، وحسبك بقول بطلانًا، رده في وجه السنة التي لا ريب فيها.
الدليل الخامس- وهو الثامن: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فأما ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله ) وهذا ترجمة المسألة. إلا أن الحديث قد اختلف فيه قبولاً و ردًا، فقال أبو بكر عبد العزيز: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غيره: هو موقوف على جابر.
فإن كان الأول، فلا ريب فيه، وإن كان الثاني، فهو قول صاحب، وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة ـ أبي موسي الأشعري وغيره ـ فينبني على أن قول الصحابة أولي من قول من بعدهم، وأحق أن يتبع. وإن علم أنه انتشر في سائرهم، ولم ينكروه، فصار إجماعًا سكوتيًا.
الدليل السادس ـ وهو التاسع: الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساجدًا عند الكعبة، فأرسلت قريش عقبة بن أبي معيط إلى قوم قد نحروا جزورًا لهم، فجاء بفرثها وسلاها فوضعهما على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو ساجد ـ ولم ينصرف حتي قضي صلاته. فهذا ـ أيضًا ـ بين في أن ذلك الفرث والسلي لم يقطع الصلاة، ولا يمكن حمله فيما أري إلا على أحد وجوه ثلاثة: إما أن يقال: هو منسوخ ـ وأعني بالنسخ أن هذا الحكم مرتفع ـ وإن لم يكن قد ثبت ـ لأنه بخطاب كان بمكة. وهذا ضعيف جدًا؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا بيقين، وأما بالظن، فلا يثبت النسخ. وأيضًا ـ فإنا ما علمنا أن اجتناب النجاسة كان غير واجب ثم صار واجبًا، لاسيما من يحتج على اجتناب النجاسة بقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}[المدثر: 4]، وسورة المدثر في أول المنزل، فيكون فرض التطهير من النجاسات على قول هؤلاء من أول الفرائض. فهذا هذا وإما أن يقال: هذا دليل على جواز حمل النجاسة في الصلاة وعامة من يخالف في هذه المسألة، لا يقول بهذا القول، فيلزمهم ترك الحديث. ثم هذا قول ضعيف لخلافه الأحاديث الصحاح في دم الحيض وغيره من الأحاديث. ثم إني لا أعلمهم يختلفون أنه مكروه، وإن إعادة الصلاة منه أولي، فهذا هذا. لم يبق إلا أن يقال: الفرث والسلي ليس بنجس وإنما هو طاهر؛ لأنه فرث ما يؤكل لحمه، وهذا هو الواجب ـ إن شاء الله تعالى ـ لكثرة القائلين به وظهور الدلائل عليه. وبطول الوجهين الأولين يوجب تعين هذا.
فإن قيل: ففيه السلي وقد يكون فيه دم قلنا: يجوز أن يكون دمًا يسيرًا، بل الظاهر أنه يسير. والدم اليسير معفو عن حمله في الصلاة.
فإن قيل: فالسلي لحم من ذبيحة المشركين، وذلك نجس، وذلك باتفاق. قلنا: لا نسلم أنه قد كان حرم ـ حينئذ ـ ذبائح المشركين، بل المظنون أو المقطوع به أنها لم تكن حرمت حينئذ، فإن الصحابة الذين أسلموا لم ينقل أنهم كانوا ينجسون ذبائح قومهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يجتنب إلا ما ذبح للأصنام. أما ما ذبحه قومه في دورهم لم يكن يتجنبه، ولو كان تحريم ذبائح المشركين قد وقع في صدر الإسلام، لكان في ذلك من المشقة على النفر القليل الذين أسلموا ما لا قبل لهم به، فإن عامة أهل البلد مشركون. وهم لا يمكنهم أن يأكلوا ويشربوا إلا من طعامهم وخبزهم. وفي أوانيهم، لقلتهم وضعفهم وفقرهم. ثم الأصل عدم التحريم ـ حينئذ ـ فمن ادعاه احتاج إلى دليل.
الدليل السابع ـ وهو العاشر: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستجمار بالعظم، والبعر، وقال: (إنه زاد إخوانكم من الجن). وفي لفظ قال: (فسألوني الطعام لهم ولدوابهم، فقلت: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فلا تستنجوا بهما، فإنهما زاد إخوانكم من الجن).
فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنج بالعظم والبعر ـ الذي هو زاد إخواننا من الجن، وعلف دوابهم ـ ومعلوم أنه إنما نهى عن ذلك؛ لئلا ننجسه عليهم، ولهذا استنبط الفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الإنس. ثم إنه قد استفاض النهى في ذلك. والتغليظ حتي قال: (من تقلد وترًا، أو استنجي بعظم، أو رجيع، فإن محمدًا منه بريء).
ومعلوم أنه لو كان البعر في نفسه نجسًا، لم يكن الاستنجاء به ينجسه، ولم يكن فرق بين البعر المستنجي به والبعر الذي لا يستنجي به، وهذا جمع بين ما فرقت السنة بينه. ثم إن البعر لو كان نجسًا، لم يصلح أن يكون علفًا لقوم مؤمنين، فإنها تصير بذلك جلالة. ولو جاز أن تصير جلالة، لجاز أن تعلف رجيع الإنس، ورجيع الدواب، فلا فرق ـ حينئذ. ولأنه لما جعل الزاد لهم ما فضل عن الإنس، ولدوابهم ما فضل عن دواب الإنس من البعر، شرط في طعامهم كل عظم ذكر اسم الله عليه، فلابد أن يشرط في علف دوابهم نحو ذلك، وهو الطهارة.
وهذا يبين لك أن قوله في حديث ابن مسعود لما أتاه بحجرين وروثة فقال: (إنها ركس)، إنما كان لكونها روثة آدمي، ونحوه، على أنها قضية عين، فيحتمل أن تكون روثة ما يؤكل لحمه، وروثة ما لا يؤكل لحمه، فلا يعم الصنفين، ولا يجوز القطع بأنها مما يؤكل لحمه، مع أن لفظ الركس لا يدل على النجاسة، لأن الركس هو المركوس أي المردود، وهو معني الرجيع، ومعلوم أن الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال، إما لنجاسته وإما لكونه علف دواب إخواننا من الجن.
الوجه الثامن ـ وهو الحادي عشر ـ: أن هذه الأعيان، لو كانت نجسة، لبينه صلى الله عليه وسلم. ولم يبينه، فليست نجسة؛ وذلك لأن هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس لها ومباشرتهم لكثير منها خصوصًا الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإبل والغنم غالب أموالهم، ولا يزالون يباشرونها ويباشرون أماكنها في مقامهم وسفرهم ـ مع كثرة الاحتفاء فيهم ـ حتي أن عمر ـ رضي الله عنه ـ كان يأمر بذلك: تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وانتعلوا. ومحالب الألبان كثيرًا ما يقع فيها من أبوالها وليس ابتلاؤهم بها، بأقل من ولوغ الكلب في أوانيهم، فلو كانت نجسة يجب غسل الثياب والأبدان والأواني منها، وعدم مخالطته، ويمنع من الصلاة مع ذلك، ويجب تطهير الأرض مما فيه ذلك، إذا صلي فيها. والصلاة فيها تكثر في أسفارهم، وفي مراح أغنامهم، ويحرم شرب اللبن الذي يقع فيه بعرها وتغسل اليد إذا أصابها البول، أو رطوبة البعر ـ إلى غير ذلك من أحكام النجاسة ـ لوجب أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا تحصل به معرفة الحكم، ولو بين ذلك لنقل جميعه أو بعضه، فإن الشريعة وعادة القوم توجب مثل ذلك، فلما لم ينقل ذلك علم أنه لم يبين لهم نجاستها.
وعدم ذكر نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتها، وعدم النهى عنه، والتقرير دليل الإباحة، ومن وجه أن مثل هذا يجب بيانه بالخطاب، ولا تحال الأمة فيه على الرأي؛ لأنه من الأصول لا من الفروع. ومن جهة أن ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه، لاسيما إذا وصل بهذا الوجه.
الوجه التاسع ـ وهو الثاني عشر: وهو أن الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلي الناس في أزمانهم بأضعاف ما ابتلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك عاقل في كثرة وقوع الحوادث المتعلقة بهذه المسألة. ثم المنقول عنهم أحد الشيئين: إما القول بالطهارة، أو عدم الحكم بالنجاسة، مثل ما ذكرناه عن أبي موسي وأنس وعبد الله بن مغفل أنه كان يصلي وعلى رجليه أثر السرقين. وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالعراق، وعن عبيد بن عمير قال: إن لي غنمًا تبعر في مسجدي،وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالحجاز،وعن إبراهيم النخعي أنه سئل فيمن يصلي وقد أصابه السرقين، قال: لا بأس، وعن أبي جعفر الباقر ونافع مولي ابن عمر أنه أصابت عمامته بول بعير فقالا جميعًا: لا بأس. وسألهما جعفر الصادق وهو أشبه بالدليل على أن ما روي عن ابن عمر في ذلك من الغسل، إما ضعيف، أو على سبيل الاستحباب والتنظيف، فإن نافعًا لا يكاد يخفي عليه طريقة ابن عمر في ذلك، ولا يكاد يخالفه، والمأثور عن السلف في ذلك كثير.
وقد نقل عن بعضهم ألفاظ إن ثبتت فليست صريحة بنجاسة محل النزاع، مثل ما روي عـن الحسن أنـه قال: البـول كله يغسـل، وقـد روي عنه أنه قال: لا بأس بأبوال الغنم، فعلم أنه أراد بول الإنســان الذكر والأنثي، والكبير والصغير. وكذلك ما روي عن أبي الشعثاء أنه قال: الأبوال كلهـــا أنجـــاس. فلعله أراد ذلك إن ثبت عنه. وقـد ذكرنا عن ابن المنذر وغـيره، أنه لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن هـذا إجماع على عـدم النجاسة، بل مقتضاه أن التنجيس مـن الأقوال المحـدثة فيكون مـردودًا بالأدلة الدالة على إبطال الحـوادث، لاسيما مقالة محـدثـة مخالفة، لما عليه الصدر الأول. ومن المعلوم أن الأعيان الموجودة في زمانهم ومكانهم إذا أمسكوا عن تحريمها وتنجيسها مع الحاجة إلى بيان ذلك،كان تحريمها وتنجيسها ممن بعدهم بمنزلة أن يمسكـوا عـن بيان أفعال يحتاج إلى بيان وجـوبها لو كـان ثابتًا،فيجيء من بعدهم فيوجبها.
ومتى قام المقتضي للتحريم أو الوجوب ولم يذكروا وجوبًا ولا تحريمًا، كان إجماعًا منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم ـ وهو المطلوب ـ وهذه الطريقة معتمدة في كثير من الأحكام، وهي أصل عظيم ينبغي للفقيه أن يتأملها، ولا يغفل عن غورها، لكن لا يسلم إلا بعدم ظهور الخلاف في الصدر الأول، فإن كان فيه خلاف محقق بطلت هذه الطريقة والحق أحق أن يتبع.
الوجه العاشر ـ وهو الثالث عشر في الحقيقة: أنَّا نعلم يقينًا أن الحبوب من الشعير والبيضاء والذرة ونحوها، كانت تزرع في مزارع المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ونعلم أن الدواب إذا داست، فلابد أن تروث وتبول، ولو كان ذلك ينجس الحبوب، لحرمت مطلقًا، أو لوجب تنجيسها.
وقد أسلمت الحجاز واليمن ونجد وسائر جزائر العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث إليهم سعاته وعماله يأخذون عشور حبوبهم من الحنطة وغيرها، وكانت سمراء الشام تجلب إلى المدينة، فيأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على عهده، وعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. وكان يعطي المرأة من نسائه ثمانين وسق شعير من غلة خيبر، وكل هذه تداس بالدواب التي تروث وتبول عليها. فلو كانت تنجس بذلك لكان الواجب على أقل الأحوال تطهير الحب وغسله، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا فعل على عهده، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم بنجاستها.
ولا يقال: هـو لم يتيقن أن ذلك الحب الذي أكله مما أصابه البول، والأصل الطهارة؛ لأنا نقـول فصاحب الحب قد تيقن نجاسة بعض حبه واشتبه عليه الطاهر بالنجس، فلا يحل له استعمال الجميع، بل الواجب تطهير الجميع، كما إذا علم نجاسة بعض البدن أو الثوب أو الأرض وخفي عليه مكان النجاسة، غسل ما يتيقن به غسلها، وهو لم يأمر بذلك.
ثم اشتباه الطاهر بالنجس نوع من اشتباه الطعام الحلال بالحرام، فكيف يباح أحدهما من غير تحرٍ؟ فإن القائل إما أن يقول يحرم الجميع. وإما أن يقول بالتحري. فأما الأكل من أحدهما بلا تحرٍ، فلا أعرف أحدًا جوزه. وإنما يستمسك بالأصل مع تيقن النجاسة ولا محيص عن هذا الدليل، إلا إلى أحد الأمرين: إما أن يقال بطهارة هذه الأبوال والأرواث، أو أن يقال: عفي عنها في هذا الموضع للحاجة. كما يعفي عن ريق الكلب في بدن الصيد على أحد الوجهين، وكما يطهر محل الاستنجاء بالحجر في أحد الوجهين إلى غير ذلك من مواضع الحاجات.
فيقال: الأصل فيها استحل جريانه على وفاق الأصل، فمن ادعي أن استحلال هذا مخالف للدليل لأجل الحاجة، فقد ادعي ما يخالف الأصل، فلا يقبل منه إلا بحجة قوية، وليس معه من الحجة ما يوجب أن يجعل هذا مخالفًا للأصل.
ولا شك أنـه لو قام دليل يوجب الحظر، لأمكن أن يستثني هذا الموضع، فأما ما ذكر مـن العموم الضعيف والقياس الضعيف، فدلالة هذا الموضع على الطهارة المطلقة أقوي من دلالـة تلك على النجاسـة المطلقة، على مـا تبين عنـد التأمل. على أن ثبوت طهارتها والعفـو عنها في هذا الموضع أحد موارد الخلاف، فيبقي إلحاق الباقي به بعدم القائل بالفرق.
ومن جنس هذا: الوجه الحادي عشر ـ وهو الرابع عشر: إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم في كل عصر ومصر على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوها، مع القطع ببولها وروثها على الحنطة، ولم ينكر ذلك منكر، ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أحد، ولا احترز عن شيء مما في البيادر لوصول البول إليه. والعلم بهذا كله علم اضطراري ما أعلم عليه سؤالاً، ولا أعلم لمن يخالف هذا شبهة.
وهذا العمل إلى زماننا متصل في جميع البلاد، لكن لم نحتج بإجماع الأعصار التي ظهر فيها هذا الخلاف؛ لئلا يقول المخالف أنا أخالف في هذا. وإنما احتججنا بالإجماع قبل ظهور الخلاف.
وهذا الإجماع من جنس الإجماع على كونهم كانوا يأكلون الحنطة ويلبسون الثياب ويسكنون البناء، فإنا نتيقن أن الأرض كانت تزرع ونتيقن أنهم كانوا يأكلون ذلك الحب ويقرون على أكله، ونتيقن أن الحب لا يداس إلا بالدواب ونتيقن أن لابد أن تبول على البيدر الذي يبقي أيامًا ويطول دياسها له، وهذه كلها مقدمات يقينية.
الوجـه الثاني عشرـ وهو الخامس عشر ـ: أن الله تعالى قال: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}[الحج: 26]، فأمر بتطهير بيته الذي هو المسجد الحرام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمـر بتنظيف المساجد، وقال: (جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا)، وقال: (الطواف بالبيت صلاة). ومعلوم قطعًا أن الحمام لم يزل ملازمًا للمسجد الحرام لأمنه، وعبادة بيت الله، وأنه لا يزال ذرقه ينزل في المسجد، وفي المطاف والمصلي. فلو كان نجسًا لتنجس المسجد بذلك، ولوجب تطهير المسجد منه: إما بإبعاد الحمام، أو بتطهير المسجد، أو بتسقيف المسجد، ولم تصح الصلاة في أفضل المساجد، وأمها وسيدها، لنجاسة أرضه، وهذا كله مما يعلم فساده يقينًا.
ولابد من أحد قولين: إما طهارته مطلقًا، أو العفو عنه. كما في الدليل قبله، وقد بينا رجحان القول بالطهارة المطلقة.
الدليل الثالث عشر ـ وهو في الحقيقة السادس عشر: مسلك التشبيه والتوجيه فنقول ـ والله الهادي ـ: اعلم أن الفرق بين الحيوان المأكول وغير المأكول إنما فرق بينهما لافتراق حقيقتهما، وقد سمي الله هذا طيبًا، وهذا خبيثًا.
وأسباب التحريم: إما القوة السبعية التي تكون في نفس البهيمة، فأكلها يورث نبات أبداننا منها فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع، أو لما الله أعلم به، وإما خبث مطعمها كما يأكل الجيف من الطير، أو لأنها في نفسها مستخبئة كالحشرات، فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل، وخبثه يؤثر في الحرمة، كما جاءت به السنة في لحوم الجلالة ولبنها وبيضها، فإنه حرم الطيب لاغتذائه بالخبيث، وكذلك النبات المسقي بالماء النجس، والمسمد بالسرقين عند من يقول به. وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول، أو خفة نجاسته، مثل الصبي الذي لم يأكل الطعام. فهذا كله يبين أشياء:
منها: أن الأبوال قد يخفف شأنها بحسب المطعم كالصبي، وقد ثبت أن المباحات لا تكون مطاعمها إلا طيبة، فغير مستنكر أن تكون أبوالها طاهرة لذلك.
ومنها: أن المطعم إذا خبث وفسد، حرم ما نبت منه من لحم ولبن وبيض، كالجلالة والزرع المسمد، وكالطير الذي يأكل الجيف. فإذا كان فساده يـؤثر في تنجيس ما توجبه الطهارة والحل، فغير مستنكر أن يكون طيبه وحله يؤثر في تطهير ما يكون في محل آخر نجسًا محرمًا. فإن الأرواث والأبوال مستحيلة مخلوقة في باطن البهيمة، كغيرها من اللبن وغيره.
يبين هذا ما يوجد في هذه الأرواث من مخالفتها غيرها من الأرواث في الخلق والريح واللون، وغير ذلك من الصفات، فيكون فرق ما بينها فرق ما بين اللبنين والمنبتين، وبهذا يظهر خلافها للإنسان.
يؤكد ذلك ما قد بيناه من أن المسلمين من الزمن المتقدم ـ وإلى اليوم في كل عصر ومصر ـ مازالوا يدوسون الزروع المأكولة بالبقر، ويصيب الحب من أرواث البقر وأبوالها، وما سمعنا أحدًا من المسلمين غسل حبًا،ولو كان ذلك منجسًا أو متقذرًا، لأوشك أن ينهوا عنها وأن تنفر عنه نفوسهم نفورها عن بول الإنسان.
ولو قيل: هذا إجماع عملي لكان حقًا، وكذلك مازال يسقط في المحالب من أبعار الأنعام، ولا يكاد أحد يحترز من ذلك؛ ولذلك عفا عن ذلك بعض من يقول بالتنجيس، على أن ضبط قانون كلي في الطاهر والنجس مطرد منعكس لم يتيسر، وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة، فهذه إشارة لطيفة إلى مسالك الرأي في هذه المسألة، وتمامه ما حضرني كتابه في هذا المجلس، {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } [الأحزاب: 4].
فإن قيل: هذا منقوض بالإنسان فإنه طاهر ولبنه طاهر، وكذلك سائر أمواهه وفضلاته، ومع هذا فروثه وبوله من أخبث الأخباث، فحصل الفرق فيه بين البول وغيره.
فنقول: اعلم أن الإنسان فارق غيره من الحيوان في هذا الباب طردًا وعكسًا، فقياس البهائم بعضها ببعض وجعلها في حيز يباين حيز الإنسان، وجعل الإنسان في حيز هو الواجب، ألا ترى أنه لا ينجس بالموت على المختار، وهي تنجس بالموت، ثم بوله أشد من بولها؟
ألا ترى أن تحريمه مفارق لتحريم غيره من الحيوان، لكرم نوعه وحرمته، حتى يحرم الكافر وغيره، وحتى لا يحل أن يدبغ جلده، مع أن بوله أشد وأغلظ، فهذا وغيره يدل على أن بول الإنسان فـارق سائر فضـلاته، أشـد من مفارقة بول البهائم فضلاتها، إما لعمـوم مـلابسته حتى لا يستخف بـه، أو لغـير ذلك مما الله أعلم به، على أنه يقال: في عـذرة الإنسان وبولـه من الخبث والنتن والقذر ما ليس في عامة الأبوال والأرواث. وفي الجملـة، فإلحـاق الأبوال باللحـوم في الطهارة والنجاسـة أحسـن طردًا من غيره. والله أعلم.
وأما الوجه الثاني: فنقول: ذلك الأصل في الآدميين مسلم، والذي جاء عن السلف إنما جاء فيهم من الاستحالة في أبدانهم، وخروجه من الشق الأعلى أو الأسفل. فمن أين يقال: كذلك سائر الحيوان، وقد مضت الإشارة إلى الفرق؟! ثم مخالفوهم يمنعونهم أكثر الأحكام في البهائم، فيقولون: قد ثبت أن ما خبث لحمه، خبث لبنه ومنيه، بخلاف الآدمى، فبطلت هذه القاعدة في الاستحالة، بل قد يقولون: إن جميع الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواء، فما طاب لحمه طاب لبنه وبوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه ودمعه. وما خبث لحمه، خبث لبنه وريقه وبوله وروثه ومنيه وعرقه ودمعه، وهذا قول يقوله أحمد في المشهور عنه، وقد قاله غيره.
وبالجملة، فاللبن والمني يشهد لهم بالفرق بين الإنسان والحيوان شهادة قاطعة، وباستواء الفضلات من الحيوان ضربا من الشهادة، فعلى هذا، يقال للإنسان: يفرق بين ما يخرج من أعلاه وأسفله لما الله أعلم به، فإنه منتصب القامة نجاسته كلها في أعاليه، ومعدته التي هي محل استحالة الطعام والشراب في الشق الأسفل.وأما الثدى ونحوه فهو في الشق الأعلى، وليس كذلك البهيمة. فإن ضرعها في الجانب المؤخر منها، وفيه اللبن الطيب، ولا مطمع في إثبات الأحكام بمثل هذه الحزورات.
وأما الوجه الثالث: فمداره على الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات فإن فصل بنوع الاستقذار، بطل بجميع المستقذرات التي ربما كانت أشد استقذارا منه، وإن فصل بقدر خاص، فلابد من توقيته، وقد مضى تقرير هذا.
وأما الجواب العام، فمن أوجه ثلاثة:
أحدها: أن هذا قياس في مقابلة الآثار المنصوصة، وهو قياس فاسد الوضع، ومن جمع بين ما فرقت السنة بينه، فقد ضاهي قول الذين قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، ولذلك طهرت السنة هذا ونجست هذا.
الثاني: أن هذا قياس في باب لم تظهر أسبابه وأنواطه، ولم يتبين مأخذه وما...، بل الناس فيه على قسمين: إما قائل يقول هذا استبعاد محض، وابتلاء صرف، فلا قياس ولا إلحاق ولا اجتماع ولا افتراق. وإما قائل يقول: دقت علينا علله وأسبابه، وخفيت علينا مسالكه ومذاهبه، وقد بعث الله إلينا رسولا يزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، بعثه إلينا ونحن لا نعلم شيئًا، فإنما نصنع ما رأيناه يصنع، والسنة لا تضرب لها الأمثال، ولا تعارض بآراء الرجال، والدين ليس بالرأى ويجب أن يتهم الرأى على الدين، والقياس في مثل هذا الباب ممتنع باتفاق أولى الألباب.
الثالث: أن يقال: هذا كله مداره على التسوية بين بول ما يؤكل لحمه، وبول ما لا يؤكل لحمه، وهو جمع بين شيئين مفترقين، فإن ريح المحرم خبيثة، وأما ريح المباح فمنه ما قد يستطاب: مثل أرواث الظباء، وغيرها. وما لم يستطب منه فليس ريحه كريح غيره، وكذلك خلقه غالبًا. فإنه يشتمل على أشياء من المباح، وهذا لأن الكلام في حقيقة المسألة، وسنعود إليه إن شاء الله في آخرها.
الدليل الثاني: الحديث المستفيض، أخرجه أصحاب الصحيح وغيرهم من حديث أنس ابن مالك: أن ناسًا من عُكْل أو عُرَينة قدموا المدينة فاجتووها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحُّوا قتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود . وذكر الحديث. فوجه الحجة أنه أذن لهم في شرب الأبوال، ولابد أن يصيب أفواههم وأيديهم وثيابهم وآنيتهم، فإذا كانت نجسة وجب تطهير أفواههم وأيديهم وثيابهم للصلاة، وتطهير آنيتهم، فيجب بيان ذلك لهم؛ لأن تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوز، ولم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليهم إماطة ما أصابهم منه، فدل على أنه غير نجس، ومن البين أن لو كانت أبوال الإبل كأبوال الناس، لأوشك أن يشتد تغليظه في ذلك.
ومن قال: إنهم كانوا يعلمون أنها نجسة، وأنهم كانوا يعلمون وجوب التطهير من النجاسات، فقد أبعد غاية الإبعاد، وأتى بشيء قد يستيقن بطلانه لوجوه:
أحدها: أن الشريعة أول ما شرعت كانت أخفي، وبعد انتشار الإسلام وتناقل العلم وإفشائه، صارت أبدى وأظهر، وإذا كنا إلى اليوم لم يستبن لنا نجاستها، بل أكثر الناس على طهارتها، وعامة التابعين عليه، بل قد قال أبو طالب وغيره: إن السلف ما كانوا ينجسونها. ولا يتقونها. وقال أبو بكر ابن المنذر: وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف، وقد ذكر طهارة الأبوال عن عامة السلف. ثم قال: قال الشافعي: الأبوال كلها نجس. قال: ولا نعلم أحدًا قال قبل الشافعي أن أبوال الأنعام وأبعارها نجس.
قلت: وقد نقل عن ابن عمر أنه سئل عن بول الناقة، فقال: اغسل ما أصابك منه. وعن الزهري فيما يصيب الراعي من أبوال الإبل قال: ينضح. وعن حماد بن أبي سليمان في بول الشاه والبعير: يغسل. ومذهب أبي حنيفة نجاسة ذلك على تفصيل لهم فيه. فلعل الذي أراده ابن المنذر، القول بوجوب اجتناب قليل البول والروث وكثيره، فإن هذا لم يبلغنا عن أحد من السلف، ولعل ابن عمر أمر بغسله كما يغسل الثوب من المخاط والبصاق والمني ونحو ذلك. وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري أنه صلى على مكان فيه روث الدواب والصحراء أمامه. وقال ههنا وههنا سواء. وعن أنس بن مالك لا بأس ببول كل ذي كرش.
ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستها، بل القول بطهارتها، إلا ما ذكر عن ابن عمر إن كان أراد النجاسة فمن أين يكون ذلك معلوم لأولئك؟!
وثانيها: أنه لو كان نجسًا فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الأمور البينة، قد أنكره في الثياب طائفة من التابعين وغيرهم. فمن أين يعلمه أولئك؟
وثالثها: أن هذا لو كان مستفيضًا بين ظهرانى الصحابة، لم يجب أن يعلمه أولئك؛ لأنهم حديثو العهد بالجاهلية والكفر، فقد كانوا يجهلون أصناف الصلوات وأعدادها وأوقاتها، وكذلك غيرها من الشرائع الظاهرة، فجهلهم بشرط خفي في أمر خفي أولى وأحرى، لاسيما والقوم لم يتفقهوا في الدين أدنى تفقه، ولذلك ارتدوا ولم يخالطوا أهل العلم والحكمة، بل حين أسلموا وأصابهم الاستيخام، أمرهم بالبداوة فيا ليت شعري، من أين لهم العلم بهذا الأمر الخفي؟!
ورابعها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في تعليمه وإرشاده واكلاً للتعليم إلى غيره، بل يبين لكل واحد ما يحتاج إليه، وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة بالسنن الماضية.
وخامسها: أنه ليس العلم بنجاسة هذه الأرواث أبين من العلم بنجاسة بول الإنسان الذي قد علمه العذارى في حجالهن وخدورهن، ثم قد حذر منه للمهاجرين والأنصار الذين أوتوا العلم والإيمان، فصار الأعراب الجفاة أعلم بالأمور الخفية من المهاجرين والأنصار بالأمور الظاهرة، فهذا كما ترى.
وسادسها: أنه فرق بين الأبوال والألبان وأخرجهما مخرجًا واحدًا. والقران بين الشيئين ـ إن لم يوجب استواءهما ـ فلابد أن يورث شبهة، فلو لم يكن البيان واجبًا، لكانت المقارنة بينه وبين الطاهر موجبة للتمييز بينهما إن كان التمييز حقًا.
وفي الحديث دلالة أخرى فيها تنازع، وهو أنه أباح لهم شربها، ولو كانت محرمة نجسة لم يبح لهم شربها، ولست أعلم مخالفًا في جواز التداوي بأبوال الإبل. كما جاءت السنة؛ لكن اختلفوا في تخريج مناطه فقيل: هو أنها مباحة على الإطلاق، للتداوى وغير التداوي. وقيل: بل هي محرمة، وإنما أباحها للتداوي. وقيل: هي مع ذلك نجسة، والاستدلال بهذا الوجه يحتاج إلى ركن آخر، وهو أن التداوي بالمحرمات النجسة محرم، والدليل عليه من وجوه:
أحدها: أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]، و(كل ذي ناب من السباع حرام). و{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ} [المائدة: 90]، عامة في حال التداوي وغير التداوي، فمن فرق بينهما، فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم، وذلك غير جائز.
فإن قيل: فقد أباحها للضرورة، والمتداوي مضطر فتباح له، أو أنا نقيس إباحتها للمريض على إباحتها للجائع بجامع الحاجة إليها.
يؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام في الصلاة والصيام في شهر رمضان، والانتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد. فكذلك يبيح المحارم؛ لأن الفرائض والمحارم من واد واحد.
يؤيد ذلك أن المحرمات من الحلية واللباس مثل الذهب والحرير قد جاءت السنة بإباحة اتخاذ الأنف من الذهب. وربط الأسنان به، ورخص للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة كانت بهما، فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات حين الاحتياج. والافتقار إليها.
قلت: أما إباحتها للضرورة فحق، وليس التداوي بضرورة لوجوه:
أحدها: أن كثيرًا من المرضى أو أكثر المرضى يشفون بلا تداوٍ، لاسيما في أهل الوبر والقرى. والساكنين في نواحي الأرض يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل، أو دعوة مستجابة، أو رقية نافعة، أو قوة للقلب، وحسن التوكل، إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء. وأما الأكل فهو ضروري، ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاء، فلو لم يكن يأكل لمات. فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء.
وثانيها: أن الأكل عند الضرورة واجب. قال مسروق: من اضطر إلى الميتة، فلم يأكل فمات، دخل النار، والتداوي غير واجب ومن نازع فيه: خصمته السنة في المرأة السوداء التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على البلاء ودخول الجنة، وبين الدعاء بالعافية. فاختارت البلاء والجنة. ولو كان رفع المرض واجبًا، لم يكن للتخيير موضع، كدفع الجوع، وفي دعائه لأبي بالحمى، وفي اختياره الحمى لأهل قباء، وفي دعائه بفناء أمته بالطعن والطاعون، وفي نهيه عن الفرار من الطاعون.
وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء، حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له مثل أيوب ـ عليه السلام ـ وغيره.
وخصمه حال السلف الصالح، فإن أبا بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ حين قالوا له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إني فعال لما أريد. ومثل هذا ونحوه يروي عن الربيع بن خيثم المخبت المنيب الذي هو أفضل الكوفيين، أو كأفضلهم وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الهادي المهدي، وخلق كثير لا يحصون عددًا.
ولست أعلم سالفًا أوجب التداوي، وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلاً واختيارًا لما اختار الله ورضى به، وتسليمًا له. وهذا المنصوص عن أحمد وإن كان من أصحابه من يوجبه، ومنهم من يستحبه، ويرجحه. كطريقة كثير من السلف استمساكًا لما خلقه الله من الأسباب، وجعله من سنته في عباده.
وثالثها: أن الدواء لا يستيقن، بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض؛ إذ لو اطرد ذلك لم يمت أحد، بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة، فإنه مستيقن بحكم سنة الله في عباده وخلقه.
ورابعها: أن المرض يكون له أدوية شتى، فإذا لم يندفع بالمحرم، انتقل إلى المحلل، ومحال ألا يكون له في الحلال شفاء أو دواء، والذي أنزل الداء، أنزل لكل داء دواء إلا الموت، ولا يجوز أن يكون أدوية الأدواء في القسم المحرم، وهو سبحانه الرؤوف الرحيم. وإلى هذا، الإشارة بالحديث المروي: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)، بخلاف المسغبة فإنها ـ وإن اندفعت بأي طعام ـ اتفق، إلا أن الخبيث إنما يباح عند فقد غيره، فإن صورت مثل هذا في الدواء فتلك صورة نادرة؛ لأن المرض أندر من الجوع بكثير، وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر، فلا ينتقض هذا . على أن في الأوجه السالفة غنى.
وخامسها: ـ وفيه فقه الباب ـ: أن الله ـ تعالى ـ جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام والغذاء، لا تندفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة. وأما المرض، فإنه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب: ظاهرة وباطنة، روحانية وجسمانية، فلم يتعين الدواء مزيلاً، ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من أنواع الأجسام في إزالة الداء المعين. ثم ذلك النوع المعين يخفي على أكثر الناس، بل على عامتهم دركه ومعرفته الخاصة، المزاولون منهم هذا الفن، أولو الأفهام والعقول، يكون الرجل منهم قـد أفنى كثيرًا مـن عمره في معرفته ذلك، ثم يخفي عليه نوع المرض وحقيقته، ويخفي عليه دواؤه وشفاؤه، ففارقت الأسباب المزيلة للمرض، الأسباب المزيلة للمخمصة في هذه الحقائق البينة وغيرها. فكذلك افترقت أحكامها كما ذكرنا. وبهذا ظهر الجواب عن الأقيسة المذكورة، والقول الجامع فيما يسقط ويباح للحاجة والضرورة ما حضرني الآن.
أما سقوط ما يسقط من القيام والصيام، والاغتسال؛ فلأن منفعة ذلك مستيقنة بخلاف التداوي.
وأيضًا، فإن ترك المأمور به أيسر من فعل المنهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا نهيتكم عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم) فانظر كيف أوجب الاجتناب عن كل منهي عنه، وفرق في المأمور به بين المستطاع وغيره، وهذا يكاد يكون دليلاً مستقلاً في المسألة.
وأيضًا، فإن الواجبات من القيام والجمعة والحج، تسقط بأنواع من المشقة التي لا تصلح لاستباحة شيء من المحظورات، وهذا بين بالتأمل.
وأما الحلية، فإنما أبيح الذهب للأنف، وربط الأسنان؛ لأنه اضطرار، وهو يسد الحاجة يقينًا كالأكل في المخمصة.
وأما لبس الحرير للحكة والجرب إن سلم ذلك. فإن الحرير والذهب ليسا محرمين على الإطلاق، فإنهما قد أبيحا لأحد صنفي المكلفين، وأبيح للصنف الآخر بعضهما، وأبيح التجارة فيهما، وإهداؤهما للمشركين. فعُلم أنهما أبيحا لمطلق الحاجة، والحاجة إلى التداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساء، بخلاف المحرمات من النجاسات. وأبيح ـ أيضا ـ لحصول المصلحة في غالب الأمر.
ثم الفرق بين الحرير والطعام: أن باب الطعام يخالف باب اللباس؛ لأن تأثير الطعام في الأبدان، أشد من تأثير اللباس، على ما قد مضي. فالمحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة التي هي المسغبة والمخمصة والمحرم من اللباس، يباح للضرورة وللحاجة -أيضا. هكذا جاءت السنة، ولا جمع بين ما فرق الله بينه. والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم في كثير من الشرعيات، وقد حصل الجواب عن كل ما يعارض به في هذه المسألة.
الوجه الثاني: أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أيتداوي بها؟ فقال: (إنها داء، وليست بدواء).
فهذا نص في المنع من التداوي بالخمر، ردًا على من أباحه، وسائر المحرمات مثلها قياسًا، خلافًا لمن فرق بينهما، فإن قياس المحرم من الطعام أشبه من الغراب بالغراب، بل الخمر قد كانت مباحة في بعض أيام الإسلام، وقد أباح بعض المسلمين من نوعها الشرب دون الإسكار والميتة والدم بخلاف ذلك.
فإن قيل: الخمر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست بدواء، فلا يجوز أن يقال: هي دواء بخلاف غيرها. وأيضا، ففي إباحة التداوي بها إجازة اصطناعها واعتصارها، وذلك داع إلى شربها. ولذلك اختصت بالحد بها دون غيرها من المطاعم الخبيثة لقوة محبة الأنفس لها.
فأقول: أما قولك: لا يجوز أن يقال: هي دواء، فهو حق، وكذلك القول في سائر المحرمات على ما دل عليه الحديث الصحيح (إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام) ثم ماذا تريد بهذا؟ أتريد أن الله لم يخلق فيها قوة طبيعية من السخونة وغيرها؟ جرت العادة في الكفار والفساق أنه يندفع بها بعض الأدواء الباردة، كسائر القوي والطبائع التي أودعها جميع الأدوية من الأجسام، أم تريد شيئًا آخر؟ فإن أردت الأول، فهو باطل بالقضايا المجربة التي تواطأت عليها الأمم، وجرت عند كثير من الناس مجري الضروريات، بل هو رد لما يشاهد ويعاين. بل قد قيل: إنه رد للقرآن؛ لقوله تعالى: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ } [البقرة:219]، ولعل هذا في الخمر أظهر من جميع المقالات المعلومة من طيب الأبدان.
وإن أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها داء للنفوس والقلوب والعقول -وهي أم الخبائث- والنفس والقلب هو الملك المطلوب صلاحه وكماله، وإنما البدن آلة له، وهو تابع له مطيع له طاعة الملائكة ربها، فإذا صلح القلب صلح البدن كله، وإذا فسد القلب فسد البدن كله فالخمر هي داء ومرض للقلب مفسد له، مضعضع لأفضل خواصه الذي هو العقل والعلم، وإذا فسد القلب، فسد البدن كله، كما جاءت به السنة، فتصير داء للبدن من هذا الوجه بواسطة كونها داء للقلب. وكذلك جميع الأموال المغصوبة والمسروقة فإنه ربما صلح عليها البدن ونبت وسمن لكن يفسد عليها القلب فيفسد البدن بفساده.
وأما المصلحة التي فيها، فإنها منفعة للبدن فقط، ونفعها متاع قليل فهي ـ وإن أصلحت شيئا يسيرًا ـ فهي في جنب ما تفسده كَلاَ إصلاح وهذا بعينه معني قوله تعالى: {فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا } [البقرة: 219]، فهذا لعمري شأن جميع المحرمات. فإن فيها من القوة الخبيثة التي تؤثر في القلب، ثم البدن في الدنيا والآخرة ما يربي على ما فيها من منفعة قليلة تكون في البدن وحده في الدنيا خاصة.
على أنا ـ وإن لم نعلم جهة المفسدة في المحرمات- فإنا نقطع أن فيها من المفاسد ما يربي على ما نظنه من المصالح. فافهم هذا فإن به يظهر فقه المسألة وسرها.
وأما إفضاؤه إلى اعتصارها، فليس بشيء؛ لأنه يمكن أخذها من أهل الكتاب على أنه يحرم اعتصارها، وإنما القول إذا كانت موجودة أن هذا منتقض بإطفاء الحرق بها، ودفع الغصة إذا لم يوجد غيرها.
وأما اختصاصها بالحد، فإن الحسن البصري يوجب الحد في الميتة ـ أيضًا ـ والدم ولحم الخنزير، لكن الفرق أن في النفوس داعيًا طبيعيًا وباعثًا إراديًا إلى الخمر، فنصب رادع شرعي وزاجر دنيوي ـ أيضا ـ ليتقابلا، ويكون مدعاة إلى قلة شربها، وليس كذلك غيرها مما ليس في النفوس إليه كثير ميل، ولا عظيم طلب.
الوجه الثالث: ما روي حسان بن مخارق قال: قالت أم سلمة: اشتكت بنت لي فنبذت لها في كوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، فقال: (ما هذا؟) فقلت: إن بنتي اشتكت فنبذنا لها هذا، فقال: (إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام). رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه ـ وفي رواية: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وصححه بعض الحفاظ وهذا الحديث نص في المسألة.
الوجه الرابع: ما رواه أبو داود في السنن: أن رجلاً وصف له ضفدع يجعلها في دواء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال: (إن نقنقتها تسبيح)، فهذا حيوان محرم ولم يبح للتداوي.
وهو نص في المسألة. ولعل تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث وغيرها، فإنه أكثر ما قيل فيها: أن نقنقتها تسبيح، فما ظنك بالخنزير والميتة وغير ذلك؟ وهذا كله بين لك استخفافه بطلب الطب واقتضائه وإجرائه مجري الرفق بالمريض وتطييب قلبه، ولهذا قال الصادق المصدوق لرجل: قال له: أنا طبيب، قال: (أنت رفيق والله الطبيب).
الوجه الخامس: ما روي ـ أيضًا ـ في سننه ـ يعني: أبا داود ـ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، وهو نص جامع مانع، وهو صورة الفتوي في المسألة.
الوجه السادس: الحديث المرفوع: (ما أبالى ما أتيت ـ أو ما ركبت ـ إذا شربت ترياقا، أو تعلقت تميمة، أو قلت الشعر من نفسي)، مع ما روي من كراهة من كره الترياق من السلف على أنه لم يقابل ذلك نص عام، ولا خاص يبلغ ذروة المطلب، وسنام المقصد في هذا الموضع ولولا أني كتبت هذا من حفظي لاستقصيت القول على وجه يحيط بما دق وجل، والله الهادي إلى سواء السبيل.
الدليل الثالث- وهو في الحقيقة رابع: الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: (صلوا فيها فإنها بركة). وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؛ فقال: (لا تصلوا فيها فإنها خلقت من الشياطين). ووجه الحجة من وجهين:
أحدهما: أنه أطلق الإذن بالصلاة، ولم يشترط حائلاً يقي من ملامستها والموضع موضع حاجة إلى البيان، فلو احتاج لبينه، وقد مضي تقرير هذا. وهذا شبيه بقول الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقام. فإنه ترك استفصال السائل: أهناك حائل يحول بينك وبين أبعارها؟ مع ظهور الاحتمال، ليس مع قيامه فقط، وأطلق الإذن، بل هذا أوكد من ذلك؛ لأن الحاجة هنا إلى البيان أمس وأوكد.
والوجه الثاني: أنها لو كانت نجسة كأرواث الآدميين لكانت الصلاة فيها إما محرمة كالحشوش، والكنف، أو مكروهة كراهية شديدة؛ لأنها مظنة الأخباث والأنجاس. فأما أن يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة ويكون شأنها شأن الحشوش أو قريبًا من ذلك فهو جمع بين المتنافيين المتضادين، وحاشًا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك.
ويؤيد هذا ما روي أن أبا موسي صلي في مبارك الغنم، وأشار إلى البرية وقال: ههنا وثَمَّ سواء. وهو الصاحب الفقيه العالم بالتنزيل، الفاهم للتأويل، سوي بين محل الأبعار وبين ما خلا عنها، فكيف يجامع هذا القول بنجاستها؟!
وأما نهيه عن الصلاة في مبارك الإبل، فليست اختصت به دون البقر والغنم والظباء والخيل، إذ لو كان السبب نجاسة البول، لكان تفريقًا بين المتماثلين، وهو ممتنع يقينا.
الدليل الرابع- وهو في الحقيقة سابع: ما ثبت واستفاض من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته، وأدخلها المسجد الحرام الذي فضله الله على جميع بقاع الأرض، وبركها حتي طاف أسبوعًا. وكذلك إذنه لأم سلمة أن تطوف راكبة، ومعلوم أنه ليس مع الدواب من العقل ما تمتنع به من تلويث المسجد المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، فلو كانت أبوالها نجسة، لكان فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس، مع أن الضرورة ما دعت إلى ذلك، وإنما الحاجة دعت إليه، ولهذا استنكر بعض من يري تنجيسها إدخال الدواب المسجد الحرام، وحسبك بقول بطلانًا، رده في وجه السنة التي لا ريب فيها.
الدليل الخامس- وهو الثامن: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فأما ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله ) وهذا ترجمة المسألة. إلا أن الحديث قد اختلف فيه قبولاً و ردًا، فقال أبو بكر عبد العزيز: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غيره: هو موقوف على جابر.
فإن كان الأول، فلا ريب فيه، وإن كان الثاني، فهو قول صاحب، وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة ـ أبي موسي الأشعري وغيره ـ فينبني على أن قول الصحابة أولي من قول من بعدهم، وأحق أن يتبع. وإن علم أنه انتشر في سائرهم، ولم ينكروه، فصار إجماعًا سكوتيًا.
الدليل السادس ـ وهو التاسع: الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساجدًا عند الكعبة، فأرسلت قريش عقبة بن أبي معيط إلى قوم قد نحروا جزورًا لهم، فجاء بفرثها وسلاها فوضعهما على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو ساجد ـ ولم ينصرف حتي قضي صلاته. فهذا ـ أيضًا ـ بين في أن ذلك الفرث والسلي لم يقطع الصلاة، ولا يمكن حمله فيما أري إلا على أحد وجوه ثلاثة: إما أن يقال: هو منسوخ ـ وأعني بالنسخ أن هذا الحكم مرتفع ـ وإن لم يكن قد ثبت ـ لأنه بخطاب كان بمكة. وهذا ضعيف جدًا؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا بيقين، وأما بالظن، فلا يثبت النسخ. وأيضًا ـ فإنا ما علمنا أن اجتناب النجاسة كان غير واجب ثم صار واجبًا، لاسيما من يحتج على اجتناب النجاسة بقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}[المدثر: 4]، وسورة المدثر في أول المنزل، فيكون فرض التطهير من النجاسات على قول هؤلاء من أول الفرائض. فهذا هذا وإما أن يقال: هذا دليل على جواز حمل النجاسة في الصلاة وعامة من يخالف في هذه المسألة، لا يقول بهذا القول، فيلزمهم ترك الحديث. ثم هذا قول ضعيف لخلافه الأحاديث الصحاح في دم الحيض وغيره من الأحاديث. ثم إني لا أعلمهم يختلفون أنه مكروه، وإن إعادة الصلاة منه أولي، فهذا هذا. لم يبق إلا أن يقال: الفرث والسلي ليس بنجس وإنما هو طاهر؛ لأنه فرث ما يؤكل لحمه، وهذا هو الواجب ـ إن شاء الله تعالى ـ لكثرة القائلين به وظهور الدلائل عليه. وبطول الوجهين الأولين يوجب تعين هذا.
فإن قيل: ففيه السلي وقد يكون فيه دم قلنا: يجوز أن يكون دمًا يسيرًا، بل الظاهر أنه يسير. والدم اليسير معفو عن حمله في الصلاة.
فإن قيل: فالسلي لحم من ذبيحة المشركين، وذلك نجس، وذلك باتفاق. قلنا: لا نسلم أنه قد كان حرم ـ حينئذ ـ ذبائح المشركين، بل المظنون أو المقطوع به أنها لم تكن حرمت حينئذ، فإن الصحابة الذين أسلموا لم ينقل أنهم كانوا ينجسون ذبائح قومهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يجتنب إلا ما ذبح للأصنام. أما ما ذبحه قومه في دورهم لم يكن يتجنبه، ولو كان تحريم ذبائح المشركين قد وقع في صدر الإسلام، لكان في ذلك من المشقة على النفر القليل الذين أسلموا ما لا قبل لهم به، فإن عامة أهل البلد مشركون. وهم لا يمكنهم أن يأكلوا ويشربوا إلا من طعامهم وخبزهم. وفي أوانيهم، لقلتهم وضعفهم وفقرهم. ثم الأصل عدم التحريم ـ حينئذ ـ فمن ادعاه احتاج إلى دليل.
الدليل السابع ـ وهو العاشر: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستجمار بالعظم، والبعر، وقال: (إنه زاد إخوانكم من الجن). وفي لفظ قال: (فسألوني الطعام لهم ولدوابهم، فقلت: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فلا تستنجوا بهما، فإنهما زاد إخوانكم من الجن).
فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنج بالعظم والبعر ـ الذي هو زاد إخواننا من الجن، وعلف دوابهم ـ ومعلوم أنه إنما نهى عن ذلك؛ لئلا ننجسه عليهم، ولهذا استنبط الفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الإنس. ثم إنه قد استفاض النهى في ذلك. والتغليظ حتي قال: (من تقلد وترًا، أو استنجي بعظم، أو رجيع، فإن محمدًا منه بريء).
ومعلوم أنه لو كان البعر في نفسه نجسًا، لم يكن الاستنجاء به ينجسه، ولم يكن فرق بين البعر المستنجي به والبعر الذي لا يستنجي به، وهذا جمع بين ما فرقت السنة بينه. ثم إن البعر لو كان نجسًا، لم يصلح أن يكون علفًا لقوم مؤمنين، فإنها تصير بذلك جلالة. ولو جاز أن تصير جلالة، لجاز أن تعلف رجيع الإنس، ورجيع الدواب، فلا فرق ـ حينئذ. ولأنه لما جعل الزاد لهم ما فضل عن الإنس، ولدوابهم ما فضل عن دواب الإنس من البعر، شرط في طعامهم كل عظم ذكر اسم الله عليه، فلابد أن يشرط في علف دوابهم نحو ذلك، وهو الطهارة.
وهذا يبين لك أن قوله في حديث ابن مسعود لما أتاه بحجرين وروثة فقال: (إنها ركس)، إنما كان لكونها روثة آدمي، ونحوه، على أنها قضية عين، فيحتمل أن تكون روثة ما يؤكل لحمه، وروثة ما لا يؤكل لحمه، فلا يعم الصنفين، ولا يجوز القطع بأنها مما يؤكل لحمه، مع أن لفظ الركس لا يدل على النجاسة، لأن الركس هو المركوس أي المردود، وهو معني الرجيع، ومعلوم أن الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال، إما لنجاسته وإما لكونه علف دواب إخواننا من الجن.
الوجه الثامن ـ وهو الحادي عشر ـ: أن هذه الأعيان، لو كانت نجسة، لبينه صلى الله عليه وسلم. ولم يبينه، فليست نجسة؛ وذلك لأن هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس لها ومباشرتهم لكثير منها خصوصًا الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإبل والغنم غالب أموالهم، ولا يزالون يباشرونها ويباشرون أماكنها في مقامهم وسفرهم ـ مع كثرة الاحتفاء فيهم ـ حتي أن عمر ـ رضي الله عنه ـ كان يأمر بذلك: تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وانتعلوا. ومحالب الألبان كثيرًا ما يقع فيها من أبوالها وليس ابتلاؤهم بها، بأقل من ولوغ الكلب في أوانيهم، فلو كانت نجسة يجب غسل الثياب والأبدان والأواني منها، وعدم مخالطته، ويمنع من الصلاة مع ذلك، ويجب تطهير الأرض مما فيه ذلك، إذا صلي فيها. والصلاة فيها تكثر في أسفارهم، وفي مراح أغنامهم، ويحرم شرب اللبن الذي يقع فيه بعرها وتغسل اليد إذا أصابها البول، أو رطوبة البعر ـ إلى غير ذلك من أحكام النجاسة ـ لوجب أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا تحصل به معرفة الحكم، ولو بين ذلك لنقل جميعه أو بعضه، فإن الشريعة وعادة القوم توجب مثل ذلك، فلما لم ينقل ذلك علم أنه لم يبين لهم نجاستها.
وعدم ذكر نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتها، وعدم النهى عنه، والتقرير دليل الإباحة، ومن وجه أن مثل هذا يجب بيانه بالخطاب، ولا تحال الأمة فيه على الرأي؛ لأنه من الأصول لا من الفروع. ومن جهة أن ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه، لاسيما إذا وصل بهذا الوجه.
الوجه التاسع ـ وهو الثاني عشر: وهو أن الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلي الناس في أزمانهم بأضعاف ما ابتلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك عاقل في كثرة وقوع الحوادث المتعلقة بهذه المسألة. ثم المنقول عنهم أحد الشيئين: إما القول بالطهارة، أو عدم الحكم بالنجاسة، مثل ما ذكرناه عن أبي موسي وأنس وعبد الله بن مغفل أنه كان يصلي وعلى رجليه أثر السرقين. وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالعراق، وعن عبيد بن عمير قال: إن لي غنمًا تبعر في مسجدي،وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالحجاز،وعن إبراهيم النخعي أنه سئل فيمن يصلي وقد أصابه السرقين، قال: لا بأس، وعن أبي جعفر الباقر ونافع مولي ابن عمر أنه أصابت عمامته بول بعير فقالا جميعًا: لا بأس. وسألهما جعفر الصادق وهو أشبه بالدليل على أن ما روي عن ابن عمر في ذلك من الغسل، إما ضعيف، أو على سبيل الاستحباب والتنظيف، فإن نافعًا لا يكاد يخفي عليه طريقة ابن عمر في ذلك، ولا يكاد يخالفه، والمأثور عن السلف في ذلك كثير.
وقد نقل عن بعضهم ألفاظ إن ثبتت فليست صريحة بنجاسة محل النزاع، مثل ما روي عـن الحسن أنـه قال: البـول كله يغسـل، وقـد روي عنه أنه قال: لا بأس بأبوال الغنم، فعلم أنه أراد بول الإنســان الذكر والأنثي، والكبير والصغير. وكذلك ما روي عن أبي الشعثاء أنه قال: الأبوال كلهـــا أنجـــاس. فلعله أراد ذلك إن ثبت عنه. وقـد ذكرنا عن ابن المنذر وغـيره، أنه لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن هـذا إجماع على عـدم النجاسة، بل مقتضاه أن التنجيس مـن الأقوال المحـدثة فيكون مـردودًا بالأدلة الدالة على إبطال الحـوادث، لاسيما مقالة محـدثـة مخالفة، لما عليه الصدر الأول. ومن المعلوم أن الأعيان الموجودة في زمانهم ومكانهم إذا أمسكوا عن تحريمها وتنجيسها مع الحاجة إلى بيان ذلك،كان تحريمها وتنجيسها ممن بعدهم بمنزلة أن يمسكـوا عـن بيان أفعال يحتاج إلى بيان وجـوبها لو كـان ثابتًا،فيجيء من بعدهم فيوجبها.
ومتى قام المقتضي للتحريم أو الوجوب ولم يذكروا وجوبًا ولا تحريمًا، كان إجماعًا منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم ـ وهو المطلوب ـ وهذه الطريقة معتمدة في كثير من الأحكام، وهي أصل عظيم ينبغي للفقيه أن يتأملها، ولا يغفل عن غورها، لكن لا يسلم إلا بعدم ظهور الخلاف في الصدر الأول، فإن كان فيه خلاف محقق بطلت هذه الطريقة والحق أحق أن يتبع.
الوجه العاشر ـ وهو الثالث عشر في الحقيقة: أنَّا نعلم يقينًا أن الحبوب من الشعير والبيضاء والذرة ونحوها، كانت تزرع في مزارع المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ونعلم أن الدواب إذا داست، فلابد أن تروث وتبول، ولو كان ذلك ينجس الحبوب، لحرمت مطلقًا، أو لوجب تنجيسها.
وقد أسلمت الحجاز واليمن ونجد وسائر جزائر العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث إليهم سعاته وعماله يأخذون عشور حبوبهم من الحنطة وغيرها، وكانت سمراء الشام تجلب إلى المدينة، فيأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على عهده، وعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. وكان يعطي المرأة من نسائه ثمانين وسق شعير من غلة خيبر، وكل هذه تداس بالدواب التي تروث وتبول عليها. فلو كانت تنجس بذلك لكان الواجب على أقل الأحوال تطهير الحب وغسله، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا فعل على عهده، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم بنجاستها.
ولا يقال: هـو لم يتيقن أن ذلك الحب الذي أكله مما أصابه البول، والأصل الطهارة؛ لأنا نقـول فصاحب الحب قد تيقن نجاسة بعض حبه واشتبه عليه الطاهر بالنجس، فلا يحل له استعمال الجميع، بل الواجب تطهير الجميع، كما إذا علم نجاسة بعض البدن أو الثوب أو الأرض وخفي عليه مكان النجاسة، غسل ما يتيقن به غسلها، وهو لم يأمر بذلك.
ثم اشتباه الطاهر بالنجس نوع من اشتباه الطعام الحلال بالحرام، فكيف يباح أحدهما من غير تحرٍ؟ فإن القائل إما أن يقول يحرم الجميع. وإما أن يقول بالتحري. فأما الأكل من أحدهما بلا تحرٍ، فلا أعرف أحدًا جوزه. وإنما يستمسك بالأصل مع تيقن النجاسة ولا محيص عن هذا الدليل، إلا إلى أحد الأمرين: إما أن يقال بطهارة هذه الأبوال والأرواث، أو أن يقال: عفي عنها في هذا الموضع للحاجة. كما يعفي عن ريق الكلب في بدن الصيد على أحد الوجهين، وكما يطهر محل الاستنجاء بالحجر في أحد الوجهين إلى غير ذلك من مواضع الحاجات.
فيقال: الأصل فيها استحل جريانه على وفاق الأصل، فمن ادعي أن استحلال هذا مخالف للدليل لأجل الحاجة، فقد ادعي ما يخالف الأصل، فلا يقبل منه إلا بحجة قوية، وليس معه من الحجة ما يوجب أن يجعل هذا مخالفًا للأصل.
ولا شك أنـه لو قام دليل يوجب الحظر، لأمكن أن يستثني هذا الموضع، فأما ما ذكر مـن العموم الضعيف والقياس الضعيف، فدلالة هذا الموضع على الطهارة المطلقة أقوي من دلالـة تلك على النجاسـة المطلقة، على مـا تبين عنـد التأمل. على أن ثبوت طهارتها والعفـو عنها في هذا الموضع أحد موارد الخلاف، فيبقي إلحاق الباقي به بعدم القائل بالفرق.
ومن جنس هذا: الوجه الحادي عشر ـ وهو الرابع عشر: إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم في كل عصر ومصر على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوها، مع القطع ببولها وروثها على الحنطة، ولم ينكر ذلك منكر، ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أحد، ولا احترز عن شيء مما في البيادر لوصول البول إليه. والعلم بهذا كله علم اضطراري ما أعلم عليه سؤالاً، ولا أعلم لمن يخالف هذا شبهة.
وهذا العمل إلى زماننا متصل في جميع البلاد، لكن لم نحتج بإجماع الأعصار التي ظهر فيها هذا الخلاف؛ لئلا يقول المخالف أنا أخالف في هذا. وإنما احتججنا بالإجماع قبل ظهور الخلاف.
وهذا الإجماع من جنس الإجماع على كونهم كانوا يأكلون الحنطة ويلبسون الثياب ويسكنون البناء، فإنا نتيقن أن الأرض كانت تزرع ونتيقن أنهم كانوا يأكلون ذلك الحب ويقرون على أكله، ونتيقن أن الحب لا يداس إلا بالدواب ونتيقن أن لابد أن تبول على البيدر الذي يبقي أيامًا ويطول دياسها له، وهذه كلها مقدمات يقينية.
الوجـه الثاني عشرـ وهو الخامس عشر ـ: أن الله تعالى قال: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}[الحج: 26]، فأمر بتطهير بيته الذي هو المسجد الحرام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمـر بتنظيف المساجد، وقال: (جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا)، وقال: (الطواف بالبيت صلاة). ومعلوم قطعًا أن الحمام لم يزل ملازمًا للمسجد الحرام لأمنه، وعبادة بيت الله، وأنه لا يزال ذرقه ينزل في المسجد، وفي المطاف والمصلي. فلو كان نجسًا لتنجس المسجد بذلك، ولوجب تطهير المسجد منه: إما بإبعاد الحمام، أو بتطهير المسجد، أو بتسقيف المسجد، ولم تصح الصلاة في أفضل المساجد، وأمها وسيدها، لنجاسة أرضه، وهذا كله مما يعلم فساده يقينًا.
ولابد من أحد قولين: إما طهارته مطلقًا، أو العفو عنه. كما في الدليل قبله، وقد بينا رجحان القول بالطهارة المطلقة.
الدليل الثالث عشر ـ وهو في الحقيقة السادس عشر: مسلك التشبيه والتوجيه فنقول ـ والله الهادي ـ: اعلم أن الفرق بين الحيوان المأكول وغير المأكول إنما فرق بينهما لافتراق حقيقتهما، وقد سمي الله هذا طيبًا، وهذا خبيثًا.
وأسباب التحريم: إما القوة السبعية التي تكون في نفس البهيمة، فأكلها يورث نبات أبداننا منها فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع، أو لما الله أعلم به، وإما خبث مطعمها كما يأكل الجيف من الطير، أو لأنها في نفسها مستخبئة كالحشرات، فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل، وخبثه يؤثر في الحرمة، كما جاءت به السنة في لحوم الجلالة ولبنها وبيضها، فإنه حرم الطيب لاغتذائه بالخبيث، وكذلك النبات المسقي بالماء النجس، والمسمد بالسرقين عند من يقول به. وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول، أو خفة نجاسته، مثل الصبي الذي لم يأكل الطعام. فهذا كله يبين أشياء:
منها: أن الأبوال قد يخفف شأنها بحسب المطعم كالصبي، وقد ثبت أن المباحات لا تكون مطاعمها إلا طيبة، فغير مستنكر أن تكون أبوالها طاهرة لذلك.
ومنها: أن المطعم إذا خبث وفسد، حرم ما نبت منه من لحم ولبن وبيض، كالجلالة والزرع المسمد، وكالطير الذي يأكل الجيف. فإذا كان فساده يـؤثر في تنجيس ما توجبه الطهارة والحل، فغير مستنكر أن يكون طيبه وحله يؤثر في تطهير ما يكون في محل آخر نجسًا محرمًا. فإن الأرواث والأبوال مستحيلة مخلوقة في باطن البهيمة، كغيرها من اللبن وغيره.
يبين هذا ما يوجد في هذه الأرواث من مخالفتها غيرها من الأرواث في الخلق والريح واللون، وغير ذلك من الصفات، فيكون فرق ما بينها فرق ما بين اللبنين والمنبتين، وبهذا يظهر خلافها للإنسان.
يؤكد ذلك ما قد بيناه من أن المسلمين من الزمن المتقدم ـ وإلى اليوم في كل عصر ومصر ـ مازالوا يدوسون الزروع المأكولة بالبقر، ويصيب الحب من أرواث البقر وأبوالها، وما سمعنا أحدًا من المسلمين غسل حبًا،ولو كان ذلك منجسًا أو متقذرًا، لأوشك أن ينهوا عنها وأن تنفر عنه نفوسهم نفورها عن بول الإنسان.
ولو قيل: هذا إجماع عملي لكان حقًا، وكذلك مازال يسقط في المحالب من أبعار الأنعام، ولا يكاد أحد يحترز من ذلك؛ ولذلك عفا عن ذلك بعض من يقول بالتنجيس، على أن ضبط قانون كلي في الطاهر والنجس مطرد منعكس لم يتيسر، وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة، فهذه إشارة لطيفة إلى مسالك الرأي في هذه المسألة، وتمامه ما حضرني كتابه في هذا المجلس، {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } [الأحزاب: 4].
 عدد المشاهدات *:
عدد المشاهدات *:
625267
 عدد مرات التنزيل *:
عدد مرات التنزيل *:
284222
 حجم الخط :
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013