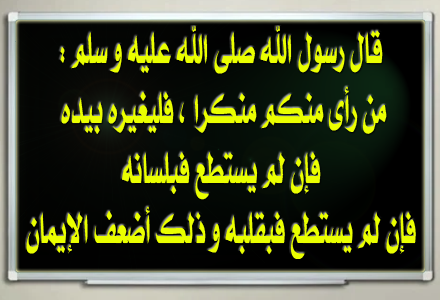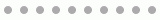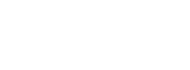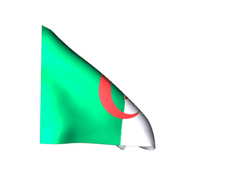فصل:
فأما الأصلان: فأحدهما أن يقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقول: بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره، إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت: أن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه. وهذا هو التمثيل وإن قلت: أن له إرادة تليق به، كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به وإن قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فيقال له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة فإن قلت: هذه إرادة المخلوق قيل لك: وهذا غضب المخلوق وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفي عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات وإن قال: أنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين، فيجب نفيه عنه قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض، يقال له: فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته، فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم، ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا، ونحو ذلك، فإن قال: تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص، دل على الإرادة والإحكام، دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع، والبصر والكلام، أو ضد ذلك قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان: أحدهما أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل، كما على المثبت والسمع، قد دل عليه ولم يعارض، ذلك معارض عقلي، ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض.
المقام الثاني أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات، بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم، دل على الرحمة، كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب الكافرين، يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشهادة والخبر: من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة - تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة، وأولى لقوة العلة الغائية، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم، أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة، وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول: إنه حي عليم قدير، وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء، وإثبات الصفات فإنك إن قلت: إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهًا أو تجسيمًا، لأنا لا نجد في الشاهد متصفًا بالصفات إلا ما هو جسم قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانف الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم، فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابًا لذلك كان جوابًا لمثبتي الصفات، وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول: هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم، قيل له: كذلك إذا قلت: ليس بموجود، ولا حي، ولا عليم، ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات، فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودًا معدومًا أو لا موجودًا ولا معدومًا، ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم، أو الحياة والموت، أو العلم والجهل أو يوصف بنفي الوجود والعدم، ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل، فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلاً لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة، لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما، قيل لك: أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر، وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل: فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاءون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شيئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} [النحل: 20، 21].
فسمى الجماد ميتًا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم، وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر، ونحو ذلك من المتقابلات، أنقص مما يقبل ذلك -، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر، أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدًا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال، ووصفته بصفات الجامدات التي لا تقبل ذلك.
وأيضًا فما لا يقبل الوجود والعدم، أعظم امتناعًا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم، ونفيهما جميعًا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم. كان أعظم امتناعًا، مما نفيت عنه الوجود والعدم، وإذا كان هذا ممتنعًا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم، هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد، وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين: الوجود والعدم، ورفعهما كجمعهما.
ومن يقول لا أثبت واحدًا منهما، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر؛ لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل، وسكوت الساكت، الذي لا يعبر عن الحقائق، وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم، أعظم امتناعًا مما يقدر قبوله لهما، مع نفيهما عنه فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت، ولا العلم ولا الجهل، ولا القدرة ولا العجز، ولا الكلام ولا الخرس، ولا العمى ولا البصر، ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم الممتنع، مما يقدر قابلًا لهما، مع نفيهما عنه، وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلًا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود، قابلًا وجب له، لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
وقيل له أيضًا: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات؛ وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه، سبحانه وتعالى.
وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيهًا وتجسيمًا، تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل، وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم، حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة.
وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة؛ مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع، قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب، وعقل وعاقل ومعقول، وعاشق ومعشوق، ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة، في العقل وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدًا، فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة، وليس هذا تركيبًا ممتنعًا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة، وليس هو تركيبًا ممتنعًا وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول، أنه ليس معنى كون الشيء عالمًا، هو معنى كونه قادرًا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالمًا قادرًا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف، فهو من أعظم الناس سفسطة، ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدًا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي، الذي لا يقبل العدم وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب، موصوفًا بكل تشبيه وتجسيم، وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير، وهذا باب مطرد فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من الصفات: لا ينفي شيئًا فرارًا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودًا واجبًا قديمًا متصفًا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلًا لخلقه، فيقال له: هكذا القول في جمع الصفات وكل ما تثبته من الأسماء والصفات: فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به، وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال، أو يدور في الخيال.
وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات، فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟
قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به، واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، ولا يمكنهم الإجابة عنه، وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟
قيل له: كيف هو؟ فإذا قال لا أعلم كيفيته. قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفة، يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له، وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه، ونزوله، وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟.
وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابته في نفس الأمر، مستوجبه لصفات الكمال، لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لايشابهه فيها سمع المخلوقين، وبصرهم، وكلامهم، ونزولهم، واستواؤهم، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات، وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئًا ونفي شيئًا بالعقل، إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة، نظير ما يلزمه فيما أثبته؛ ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقًا؛ ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه، إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم.
فإذا قيل لهم: لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد؟. لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر، لزمهم في المعنى المصروف إليه، ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه، فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الارادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت، والرضا والسخط.
ولو فسر ذلك بمفعولاته، وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل لابد أن يقوم، أولًا بالفاعل والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه، المثيب المعاقب فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات.
فأما الأصلان: فأحدهما أن يقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقول: بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره، إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت: أن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه. وهذا هو التمثيل وإن قلت: أن له إرادة تليق به، كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به وإن قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فيقال له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة فإن قلت: هذه إرادة المخلوق قيل لك: وهذا غضب المخلوق وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفي عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات وإن قال: أنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين، فيجب نفيه عنه قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض، يقال له: فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته، فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم، ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا، ونحو ذلك، فإن قال: تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص، دل على الإرادة والإحكام، دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع، والبصر والكلام، أو ضد ذلك قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان: أحدهما أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل، كما على المثبت والسمع، قد دل عليه ولم يعارض، ذلك معارض عقلي، ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض.
المقام الثاني أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات، بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم، دل على الرحمة، كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب الكافرين، يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشهادة والخبر: من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة - تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة، وأولى لقوة العلة الغائية، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم، أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة، وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول: إنه حي عليم قدير، وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء، وإثبات الصفات فإنك إن قلت: إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهًا أو تجسيمًا، لأنا لا نجد في الشاهد متصفًا بالصفات إلا ما هو جسم قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانف الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم، فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابًا لذلك كان جوابًا لمثبتي الصفات، وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول: هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم، قيل له: كذلك إذا قلت: ليس بموجود، ولا حي، ولا عليم، ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات، فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودًا معدومًا أو لا موجودًا ولا معدومًا، ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم، أو الحياة والموت، أو العلم والجهل أو يوصف بنفي الوجود والعدم، ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل، فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلاً لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة، لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما، قيل لك: أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر، وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل: فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاءون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شيئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} [النحل: 20، 21].
فسمى الجماد ميتًا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم، وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر، ونحو ذلك من المتقابلات، أنقص مما يقبل ذلك -، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر، أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدًا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال، ووصفته بصفات الجامدات التي لا تقبل ذلك.
وأيضًا فما لا يقبل الوجود والعدم، أعظم امتناعًا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم، ونفيهما جميعًا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم. كان أعظم امتناعًا، مما نفيت عنه الوجود والعدم، وإذا كان هذا ممتنعًا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم، هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد، وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين: الوجود والعدم، ورفعهما كجمعهما.
ومن يقول لا أثبت واحدًا منهما، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر؛ لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل، وسكوت الساكت، الذي لا يعبر عن الحقائق، وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم، أعظم امتناعًا مما يقدر قبوله لهما، مع نفيهما عنه فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت، ولا العلم ولا الجهل، ولا القدرة ولا العجز، ولا الكلام ولا الخرس، ولا العمى ولا البصر، ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم الممتنع، مما يقدر قابلًا لهما، مع نفيهما عنه، وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلًا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود، قابلًا وجب له، لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
وقيل له أيضًا: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات؛ وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه، سبحانه وتعالى.
وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيهًا وتجسيمًا، تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل، وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم، حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة.
وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة؛ مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع، قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب، وعقل وعاقل ومعقول، وعاشق ومعشوق، ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة، في العقل وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدًا، فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة، وليس هذا تركيبًا ممتنعًا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة، وليس هو تركيبًا ممتنعًا وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول، أنه ليس معنى كون الشيء عالمًا، هو معنى كونه قادرًا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالمًا قادرًا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف، فهو من أعظم الناس سفسطة، ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدًا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي، الذي لا يقبل العدم وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب، موصوفًا بكل تشبيه وتجسيم، وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير، وهذا باب مطرد فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من الصفات: لا ينفي شيئًا فرارًا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودًا واجبًا قديمًا متصفًا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلًا لخلقه، فيقال له: هكذا القول في جمع الصفات وكل ما تثبته من الأسماء والصفات: فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به، وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال، أو يدور في الخيال.
وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات، فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟
قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به، واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، ولا يمكنهم الإجابة عنه، وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟
قيل له: كيف هو؟ فإذا قال لا أعلم كيفيته. قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفة، يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له، وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه، ونزوله، وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟.
وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابته في نفس الأمر، مستوجبه لصفات الكمال، لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لايشابهه فيها سمع المخلوقين، وبصرهم، وكلامهم، ونزولهم، واستواؤهم، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات، وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئًا ونفي شيئًا بالعقل، إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة، نظير ما يلزمه فيما أثبته؛ ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقًا؛ ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه، إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم.
فإذا قيل لهم: لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد؟. لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر، لزمهم في المعنى المصروف إليه، ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه، فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الارادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت، والرضا والسخط.
ولو فسر ذلك بمفعولاته، وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل لابد أن يقوم، أولًا بالفاعل والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه، المثيب المعاقب فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات.
 عدد المشاهدات *:
عدد المشاهدات *:
707716
 عدد مرات التنزيل *:
عدد مرات التنزيل *:
302158
 حجم الخط :
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013