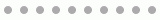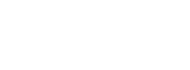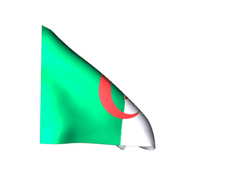وسئل ـ رَحمه اللّه تعالى:
هل هذه الأشياء المطعومات التي يؤخذ عليها المكس، وهي مضمنة، أو محتكرة، هل يحرم على من يشتري منها شيئًا، ويأكل منها؟ وإن عامل رجل لإنسان كل ماله حرام مثل ضامن المكس، أو من ليس له مال سوي المكس، فهل يفسق بذلك؟
فأجاب:
الحمد للّه، أما إذا كان الرجل يبيع سلعته من طعام أو غيره وعليهما وظيفة تؤخذ من البائع أو المشتري. فهذا لا يحرم السلعة، ولا الشراء، لا عن بائعها ولا على مشتريها، ولا شبهة في ذلك أصلا.
وكذلك إذا كان المأخوذ بعض السلعة،مثل أن يأخذوا من الشاة المذبوحة سواقطها، أو من الحبوب والثمار بعضها،ومن ظن في ذلك شبهة فهو مخطئ،فإن هذا المال المأخوذ ظلما،سواء أخذ من البائع أو من المشتري، لا يوجب وقوع الشبهة فيما بقي من المال، وكما لو ظلم الرجل وأخـذ بعض ماله، فإن ذلك لا يوجب وقوع الشبهة فيما بقي من ماله.
وهذه الوظائف الموضوعة بغير أصل شرعي، منها ما يكون موضوعًا / على البائع مثل سوق الدواب ونحوه. فإذا باع سلعته بمال فأخذ منه بعض ذلك الثمن كان ذلك ظلمًا له، وباقي ماله حلال له، والمشتري اشتري بماله، وربما يزاد عليه في الثمن لأجل الوظيفة، فيكون منه زيادة. فبأي وجه يكون فيما اشتراه شبهة؟ وإن كانت الوظيفة تؤخذ من المشتري فيكون قد أدي الثمن للبائع، والزيادة لأجل تلك الكلفة السلطانية، ولا شبهة في ذلك لا على البائع، ولا على المشتري؛ لأن المنافع لم تؤخذ إلا بما يستحقه، والمشتري قد أدي الواجب وزيادة.
وإذا قيل: هذا في الحقيقة ظلم للبائع؛ لأنه هو المستحق لجميع الثمن. قيل: هب أن الأمر كذلك، ولكن المشتري لم يظلمه، وإنما ظلمه من أخذ ماله، كما لو قبض البائع جميع الثمن، ثم أخذت منه الكلفة السلطانية.
وفي الحقيقة فالكلفة تقع عليهما؛ لأن البائع إذا علم أن عليه كلفة زاد في الثمن، والمشتري إذا علم أنه عليه كلفة نقص من الثمن، فكلاهما مظلوم بأخذ الكلفة، وكل منهما لم يظلم أحدًا، فلا يكون في مالهما شبهة من هذا الوجه، فما يبيعه المسلمون إذا كان ملكا لهم لم يكن في ذلك شبهة بما يؤخذ منهم في الوظائف.
وأما إذا ضمن الرجل نوعًا من السلع على ألا يبيعها إلا هو،/ فهذا ظالم من وجهين: من جهة أنه منع غيره من بيعها، وهذا لا يجوز، ومن جهة أنه يبيعها للناس بما يختار من الثمن، فيغليها، وهؤلاء نوعان:
منهم: من يستأجر حانوتًا بأكثر من قيمتها، إما لمقطع، وإما لغيره، على ألا يبيع في المكان إلا هو، أو يجعل عليه مالًا يعطيه لمقطع أو غيره بلا استئجار حانوت، ولا غير ذلك، وكلاهما ظالم، فإن الزيادة التي يزيدها في الحانوت لأجل منع الثاني من البيع، هو بمنزلة الضامن المنفرد.
والنوع الثاني: ألا يكون عليهم ضمان، لكن يلتزمون بالبيع للناس؛ كالطحانين والخبازين ونحوهم ممن ليس لهم وظيفة، لكن عليه أن يبيع كل يوم شيئًا مقدرًا، ويمنعون من سواهم من البيع؛ ولهذا جاز التسعير على هؤلاء، وإن لم يجز التسعير في الإطلاق. فإن هؤلاء قد أوجبت عليهم المبايعة لهذا الصنف، ومنع من ذلك غيرهم، فلو مكنوا أن يبيعوا بما أرادوا كان ظلما للمساكين، بخلاف ما إذا كان الناس كلهم متمكنين من ذلك، فإنه يكون كما في السنن عن أنس قال: غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول اللّه سعر لنا، فقال: (إن اللّه هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقي اللّه، وليس أحد يطلبني بمظلمة في مال).
/وأما في الصورة، فإذا كانوا قد ألزموا بالمبايعة لم يجز أن يلزموا بأن يبيعوا بدون ثمن المثل؛ لأن ذلك ظلم لهم، وإذا كان غيرهم قد منع من المبايعة لم يجز أن يمكنوا أن يبيعوا بما اختاروا؛ فإن ذلك ظلم للناس.
يبقي أن يقال: فهل يجوز التزامهم بمثل ذلك على هذا الوجه، على أن يكونوا هم البائعين لهذا الصنف دون غيرهم، وألا يبيعوه إلا بقيمة المثل من غير مكس يوضع عليهم؟ فهل يجوز للإمام أن يفعل بهم ذلك، أم يجب عليه ألا يترك أحدًا يفعل ذلك ؟
قيل: أما إذا اختاروا أن يقوموا بما يحتاج الناس اليه من تلك المبيعات، وألا يبيعوها إلا بقيمة المثل، على أن يمنع غيرهم من البيع،ومن اختار أن يدخل معهم في ذلك مكن، فهذا لا يتبين تحريمه، بل قد يكون في هذا مصلحة عامة للناس، وهذا يشبه ما نقل عن عمر في التسعير، وأنه قال: إن كنت تبيع بسعر أهل الأسواق، وإلا فلا تبع. فإن مصلحة الناس العامة في ذلك أن يباعوا بما يحتاجون اليه، وألا يباعوا إلا بقيمة المثل، وهذان مصلحتان جليلتان.
والباعة إذا اختاروا ذلك لم يكونوا قد أكرهوا عليه، فلا ظلم عليهم، وغيرهم من الناس لم يمنع من البيع، إلا إذا دخل في هذه / المصلحة العامة، بأن يشاركهم فيما يقومون به بقيمة المثل، فيكون الغير قد منع أن يبيع سلعة بأكثر من ثمن المثل، وألا يبيعها، إلا إذا التزم أن يبيع لواحد منهم. وقد يكون عاجزًا عن ذلك. وقد يقال: هذان نوعان من الظلم: إلزام الشخص أن يبيع، وأن يكون بيعه بثمن المثل، وفي هذا فساد. وحينئذ فإن كان أمر الناس صالحًا بدون هذا لم يجز احتمال هذا الفساد بلا مصلحة راجحة، وأما إن كان بدون هذا لا يحصل للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوه، أو لا يلقون ذلك إلا بأثمان مرتفعة، وبذلك يحصل ما يكفيهم بثمن المثل. فهذه المصلحة العامة يغتفر في جانبها ما ذكر من المنع.
وأما إذا ألزم الناس بذلك فهذا فيه تفصيل؛ فإن الناس إذا اضطروا الى ما عند الإنسان من السلعة والمنفعة وجب عليه أن يبذل لهم بقيمة المثل، ومنعه ألا يبيع سلعة حتى يبيع مقدارًا معينًا. وتفصيل هذه المسائل ليس هذا موضعه.
إذا تبين ذلك، فالذي يضمن كلفة من المكلف على ألا يبيع السلعة إلا هو، ويبيعها بما يختار، لا ريب أنه من جنس ظلم الكلف السلطانية من الوجهين اللذين تقدما؛ ولهذا كره من كره معاملة هذا لأجل الشبهة التي في ماله. فإنه إذا كان لا يبيع إلا هو بما يختار صار كأنه يكره الناس على الشراء منه بما يختاره، فيأخذ منهم أكثر مما يجب عليهم،/ وتلك الشبهة قد اختلطت بماله، فيصير في ماله شبهة من هذا الوجه؛ فلهذا كره من كره معاملتهم.
وهذا سبيل أهل الورع الذين لا يأكلون من الشواء المضمن، ونحو ذلك، فإنهم إنما تورعوا عما كان بهذه المثابة، وهو أن يكون بحيث لا يشوي إلا هو، ولا يبيع الشواء إلا هو بما يختاره، ولا يبيع الملح إلا هو بما يختاره، والملح ليست كغيرها، فإن الملح في الأصل هو من المباحات التي يشترك فيها المسلمون، كالسمك وغيره من المباحات، إذا لم يمكن من أخذها إلا واحد بضمان عليه، والذي يشتريها منه بماله لا يحرم؛ لأن هذا المشتري لم يظلم فيه أحدًا، بل لو أخذها من الأصل كان له ذلك، ولو استأجر هذا أو غيره ليأخذها له من موضعها المشترك كان ذلك جائزًا، ولو كانت مشتركة بين المسلمين لكانت تكون أرخص، وكان المشتري يأخذها بدون ما أعطاه الضامن، فهذا الضامن يظلم المشتري وغيره.
وأما المشترون منه فهم لا يظلمون أحدًا، ولم يشتروا منه شيئا ملكه بماله، فإنما حرم عليه من الظلم من ترك ملكه لا يفوته، ولم يظلم فيه أحدًا؛ لأنها في الأصل مباحة، والمسلمون الذين يشترونها هم المظلومون، فإنه لولا الظلم لتمكنوا من أخذها بدون الثمن، فإذا ظلموا وأخذ منهم أكثر مما عليهم لم يكن ذلك محرمًا عليهم لما كان / مباحا لهم؛ إذ الظلم إنما يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم.
ألا ترى أن المدلس والغاش ونحوهما إذا باعوا غيرهم شيئًا مدلسًا لم يكن ما يشتريه حرامًا عليه؛ لأنه أخذ منه أكثر مما يجب عليه، وإن كانت الزيادة التي أخذها الغاش حرامًا عليه. وأمثال هذا كثير في الشريعة؛ فإن التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر، كما لو اشتري الرجل ملكه المغصوب من الغاصب، فإن البائع يحرم عليه أخذ الثمن، والمشتري لا يحرم عليه أخذ ملكه، ولا بذل ما بذله من الثمن؛ ولهذا قال العلماء: يجوز رشوة العامل لدفع الظلم، لا لمنع الحق، وإرشاؤه حرام فيهما. وكذلك الأسير والعبد المعتق، إذا أنكر سيده عتقه، له أن يفتدي نفسه بمال يبذله، يجوز له بذله، وإن لم يجز للمستولي عليه بغير حق أخذه.
وكذلك المرأة المطلقة ثلاثًا إذا جحد الزوج طلاقها، فافتدت منه بطريق الخلع في الظاهر كان حرامًا عليه ما بذلته ويخلصها من رق استيلائه؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لأعطي أحدهم العطيَّة فيخرج بها يتلظَّاها نارًا)، قالوا: يا رسول الله، فلم تعطيهم؟ قال: (يأبون إلا أن يسألوني، ويأبي الله لي البُخل).
ومن ذلك قوله: (ما وقي به المرء عرضه فهو صدقة). فلو أعطي الرجل شاعرًا، أو غير شاعر؛ لئلا يكذب عليه بهجو أو غيره، أو لئلا يقول في عرضه ما يحرم عليه قوله، كان بذله لذلك جائزًا، وكان ما أخذه ذلك لئلا يظلمه حرامًا عليه؛ لأنه يجب عليه ترك ظلمه. والكذب عليه بالهجو من جنس تسمية العامة: [ قطع مصانعه ] وهو الذي يتعرض للناس، وإن لم يعطوه اعتدي عليهم، بأن يكون عونًا عليهم في الإثم والعدوان، أو بأن يكذب عليهم، وأمثال ذلك. فكل من أخذ المال لئلا يكذب على الناس، أو لئلا يظلمهم كان ذلك خبيثًا سحتًا؛ لأن الظلم والكذب حرام عليه، فعليه أن يتركه بلا عوض يأخذه من المظلوم، فإذا لم يتركه إلا بالعوض كان سحتًا.
فالمباحات التي يشترك فيها المسلمون في الأصل؛ كالصيود البرية والبحرية، المباحات النابتة في الأرض، والمباحة من الجبال والبراري ونحو ذلك، كالمعادن وكالملح، وكالأطرون وغيرها إذا حجرها السلطان وأمر ألا يأخذها إلا نوابه، وأن تباع للناس، لم يحرم عليهم شراؤها؛ لأنهم لا يظلمون فيها أحدًا، ولأنهم هم المظلومون بحجرها عليهم، فكيف يحرم عليهم أن يشتروا مالهم أن يأخذوه بلا عوض؛ فإن نواب السلطان لا يستخرجونها إلا بأثمانها التي أخذوها ظلمًا، أو نحو ذلك من الظلم.
قيل: تلك الأموال أخذت من المسلمين ظلمًا، والمسلمون هم / المظلومون، فقد منعوا حقوقهم من المباحات، إلا بما يؤخذ منهم يستخرج ببعضه تلك المباحات، والباقي يؤخذ، وذلك لا يحرم عليهم ما كان حلالًا لهم، وهذا ظاهر فيما كان الظلم فيه مناسبًا، مثل أن يباع كل مقدار بثمن معين، ويؤخذ من تلك الأثمان ما يستخرج به تلك المباحات، وهنا لا شبهة على المشتري أصلا؛ فإن ما استخرجت به المباحات هو حقهم أيضا. فهو كما لو غصب رجل بيت رجل، وأمر غلمان المالك أن يطبخوا مما في بيته طعامًا فإن ذلك لا يحرم على المغصوب؛ لأنه يملك الأعيان والمنافع، وليس في ذلك إلا أن يكون التصرف وقع بغير وكالة منه، ولا ولاية عليه، وهذا لا يحرم ماله، بل ولا بذل ماله باتفاق المسلمين. وإن كان ما يستخرج به تلك المباحات بدون المعاملة بالأموال السلطانية المشتركة.
وأما إذا استخرج نواب السلطان بغير حق من يستخرج تلك المباحات، فهذا بمنزلة أن يغصب من يطبخ له طعاما أو ينسج له ثوبا، وبمنزلة أن يطبخ الطعام بحطب مغصوب، وأمثال ذلك مما تكون العين فيه مباحة، لكن وقع الظلم في تحويلها من حال إلى حال. فهذا فيه شبهة، وطريق التخلص منها أن ينظر النفع الحاصل في تلك العين بعمل المظلوم، فيعطي المظلوم أجره، وإن تعذر معرفة المظلوم تصدق به عنه؛ فإن هذا غايته أن يكون قد اختلط حلال وحرام، ولو اختلطت الأعيان التي يملكها بالأثمان التي / غصبها وأخذها حرامًا، مثل أن تختلط دراهمه ودنانيره بما غصبه من الدراهم والدنانير، واختلط حبه أو ثمره أو دقيقه أو خله أو ذهبه بما غصبه من هذه الأنواع، فإن هذا الاختلاط لا يوجب تحريم ماله عليه؛ لأن المحرمات نوعان:
محرم لوصفه وعينه: كالدم والميتة ولحم الخنزير. فهذا إذا اختلط بالمائع وظهر فيه طعم الخبث أو لونه أو ريحه حرم.
ومحرم لكسبه: كالنقدين، والحبوب، والثمار، وأمثال ذلك. فهذه لا تحرم أعيانها تحريما مطلقا بحال، ولكن تحرم على من أخذها ظلمًا أو بوجه محرم،فإذا أخذ الرجل منها شيئا، وخلطه بماله، فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم، وقدر ماله حلال له. ولو أخرج مثله من غيره؟ ففيه وجهان في مذهب الشافعي وأحمد.
أحدهما: أن الاختلاط كالتلف، فإذا أخرج مثله أجزأ.
والثاني: أن حق المظلوم يتعلق بالعين مع الخلط، فلابد أن يخرج قدر حق المظلوم من ذلك المال المختلط.
إذا تبين هذا، فإذا كان أثر عمل المظلوم قائمًا بالعين؛ مثل طبخه أو نسجه ونحو ذلك، فإنما يستحق قيمة ذلك النفع، فإذا أعطي المظلوم / قيمة ذلك النفع أخذ حقه، فلا يبقي لصاحب العين شريك، فلا يحرم عليه. وأما إذا لم يعرف المظلوم فإنه يتصدق به عنه عند جمهور العلماء، كما لو حصل بيده أثمان من غصوب وعوارٍ وودائع لا يعرف أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم؛ لأن المجهول كالمعدوم في الشريعة، والمعجوز عنه كالمعدوم؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: (فإن جاء صاحبها فأدها إليه، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء).
فإذا كان في اللقطة التي تحرم، بأنها سقطت من مالك، لما تعذر معرفة صاحبها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للملتقط ـ ولا نزاع بين المسلمين في جواز صدقته بها، وإنما تنازعوا في جواز تملكه لها مع الغني، والجمهور على جواز ذلك ـ فكيف ما يجهل فيه ذلك.
وفي هذه المسألة آثار معروفة، مثل حديث عبد الله بن مسعود لما اشتري جارية، ثم خرج ليوفي البائع الثمن فلم يجده، فجعل يطوف على المساكين، ويقول: اللهم هذه عن صاحب الجارية، فإن رضي فقد برئت ذمتي، وإن لم يرض فهو عني، وله على مثلها يوم القيامة. وحديث الرجل الذي غل من الغنيمة، في غزوة قبرص، وجاء إلى معاوية يرد إليه المغلول، فلم يأخذه، فاستفتي بعض التابعين فأفتاه بأن يتصدق بذلك عن الجيش، ورجع إلى معاوية فأخبره، فاستحسن ذلك؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ، والمال / الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه، فيصرف في مصالح المسلمين، والصدقة من أعظم مصالح المسلمين. وهذا أصل عام في كل مال جهل مالكه، بحيث يتعذر رده إليه؛ كالمغصوب، والعواري والودائع، تصرف في مصالح المسلمين على مذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة، وغيرهم.
وإذا صرفت على هذا الوجه جاز للفقير أخذها؛ لأن المعطي هنا إنما يعطيها نيابة عن صاحبها، بخلاف من تصدق من غلول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحـديث الصحيح: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول).
فهذا الذي يحوز المال ويتصدق به. مع إمكان رده إلى صاحبه، أو يتصدق صدقة متقرب، كما يتصدق بماله، فالله لا يقبل ذلك منه، وأما ذاك فإنما يتصدق به صدقة متحرج متأثم، فكانت صدقته بمنزلة أداء الدين الذي عليه، وأداء الأمانات إلى أصحابها، وبمنزلة إعطاء المال للوكيل المستحق، ليس هو من الصدقة الداخلة في قوله: (ولا صدقة من غلول).
هل هذه الأشياء المطعومات التي يؤخذ عليها المكس، وهي مضمنة، أو محتكرة، هل يحرم على من يشتري منها شيئًا، ويأكل منها؟ وإن عامل رجل لإنسان كل ماله حرام مثل ضامن المكس، أو من ليس له مال سوي المكس، فهل يفسق بذلك؟
فأجاب:
الحمد للّه، أما إذا كان الرجل يبيع سلعته من طعام أو غيره وعليهما وظيفة تؤخذ من البائع أو المشتري. فهذا لا يحرم السلعة، ولا الشراء، لا عن بائعها ولا على مشتريها، ولا شبهة في ذلك أصلا.
وكذلك إذا كان المأخوذ بعض السلعة،مثل أن يأخذوا من الشاة المذبوحة سواقطها، أو من الحبوب والثمار بعضها،ومن ظن في ذلك شبهة فهو مخطئ،فإن هذا المال المأخوذ ظلما،سواء أخذ من البائع أو من المشتري، لا يوجب وقوع الشبهة فيما بقي من المال، وكما لو ظلم الرجل وأخـذ بعض ماله، فإن ذلك لا يوجب وقوع الشبهة فيما بقي من ماله.
وهذه الوظائف الموضوعة بغير أصل شرعي، منها ما يكون موضوعًا / على البائع مثل سوق الدواب ونحوه. فإذا باع سلعته بمال فأخذ منه بعض ذلك الثمن كان ذلك ظلمًا له، وباقي ماله حلال له، والمشتري اشتري بماله، وربما يزاد عليه في الثمن لأجل الوظيفة، فيكون منه زيادة. فبأي وجه يكون فيما اشتراه شبهة؟ وإن كانت الوظيفة تؤخذ من المشتري فيكون قد أدي الثمن للبائع، والزيادة لأجل تلك الكلفة السلطانية، ولا شبهة في ذلك لا على البائع، ولا على المشتري؛ لأن المنافع لم تؤخذ إلا بما يستحقه، والمشتري قد أدي الواجب وزيادة.
وإذا قيل: هذا في الحقيقة ظلم للبائع؛ لأنه هو المستحق لجميع الثمن. قيل: هب أن الأمر كذلك، ولكن المشتري لم يظلمه، وإنما ظلمه من أخذ ماله، كما لو قبض البائع جميع الثمن، ثم أخذت منه الكلفة السلطانية.
وفي الحقيقة فالكلفة تقع عليهما؛ لأن البائع إذا علم أن عليه كلفة زاد في الثمن، والمشتري إذا علم أنه عليه كلفة نقص من الثمن، فكلاهما مظلوم بأخذ الكلفة، وكل منهما لم يظلم أحدًا، فلا يكون في مالهما شبهة من هذا الوجه، فما يبيعه المسلمون إذا كان ملكا لهم لم يكن في ذلك شبهة بما يؤخذ منهم في الوظائف.
وأما إذا ضمن الرجل نوعًا من السلع على ألا يبيعها إلا هو،/ فهذا ظالم من وجهين: من جهة أنه منع غيره من بيعها، وهذا لا يجوز، ومن جهة أنه يبيعها للناس بما يختار من الثمن، فيغليها، وهؤلاء نوعان:
منهم: من يستأجر حانوتًا بأكثر من قيمتها، إما لمقطع، وإما لغيره، على ألا يبيع في المكان إلا هو، أو يجعل عليه مالًا يعطيه لمقطع أو غيره بلا استئجار حانوت، ولا غير ذلك، وكلاهما ظالم، فإن الزيادة التي يزيدها في الحانوت لأجل منع الثاني من البيع، هو بمنزلة الضامن المنفرد.
والنوع الثاني: ألا يكون عليهم ضمان، لكن يلتزمون بالبيع للناس؛ كالطحانين والخبازين ونحوهم ممن ليس لهم وظيفة، لكن عليه أن يبيع كل يوم شيئًا مقدرًا، ويمنعون من سواهم من البيع؛ ولهذا جاز التسعير على هؤلاء، وإن لم يجز التسعير في الإطلاق. فإن هؤلاء قد أوجبت عليهم المبايعة لهذا الصنف، ومنع من ذلك غيرهم، فلو مكنوا أن يبيعوا بما أرادوا كان ظلما للمساكين، بخلاف ما إذا كان الناس كلهم متمكنين من ذلك، فإنه يكون كما في السنن عن أنس قال: غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول اللّه سعر لنا، فقال: (إن اللّه هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقي اللّه، وليس أحد يطلبني بمظلمة في مال).
/وأما في الصورة، فإذا كانوا قد ألزموا بالمبايعة لم يجز أن يلزموا بأن يبيعوا بدون ثمن المثل؛ لأن ذلك ظلم لهم، وإذا كان غيرهم قد منع من المبايعة لم يجز أن يمكنوا أن يبيعوا بما اختاروا؛ فإن ذلك ظلم للناس.
يبقي أن يقال: فهل يجوز التزامهم بمثل ذلك على هذا الوجه، على أن يكونوا هم البائعين لهذا الصنف دون غيرهم، وألا يبيعوه إلا بقيمة المثل من غير مكس يوضع عليهم؟ فهل يجوز للإمام أن يفعل بهم ذلك، أم يجب عليه ألا يترك أحدًا يفعل ذلك ؟
قيل: أما إذا اختاروا أن يقوموا بما يحتاج الناس اليه من تلك المبيعات، وألا يبيعوها إلا بقيمة المثل، على أن يمنع غيرهم من البيع،ومن اختار أن يدخل معهم في ذلك مكن، فهذا لا يتبين تحريمه، بل قد يكون في هذا مصلحة عامة للناس، وهذا يشبه ما نقل عن عمر في التسعير، وأنه قال: إن كنت تبيع بسعر أهل الأسواق، وإلا فلا تبع. فإن مصلحة الناس العامة في ذلك أن يباعوا بما يحتاجون اليه، وألا يباعوا إلا بقيمة المثل، وهذان مصلحتان جليلتان.
والباعة إذا اختاروا ذلك لم يكونوا قد أكرهوا عليه، فلا ظلم عليهم، وغيرهم من الناس لم يمنع من البيع، إلا إذا دخل في هذه / المصلحة العامة، بأن يشاركهم فيما يقومون به بقيمة المثل، فيكون الغير قد منع أن يبيع سلعة بأكثر من ثمن المثل، وألا يبيعها، إلا إذا التزم أن يبيع لواحد منهم. وقد يكون عاجزًا عن ذلك. وقد يقال: هذان نوعان من الظلم: إلزام الشخص أن يبيع، وأن يكون بيعه بثمن المثل، وفي هذا فساد. وحينئذ فإن كان أمر الناس صالحًا بدون هذا لم يجز احتمال هذا الفساد بلا مصلحة راجحة، وأما إن كان بدون هذا لا يحصل للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوه، أو لا يلقون ذلك إلا بأثمان مرتفعة، وبذلك يحصل ما يكفيهم بثمن المثل. فهذه المصلحة العامة يغتفر في جانبها ما ذكر من المنع.
وأما إذا ألزم الناس بذلك فهذا فيه تفصيل؛ فإن الناس إذا اضطروا الى ما عند الإنسان من السلعة والمنفعة وجب عليه أن يبذل لهم بقيمة المثل، ومنعه ألا يبيع سلعة حتى يبيع مقدارًا معينًا. وتفصيل هذه المسائل ليس هذا موضعه.
إذا تبين ذلك، فالذي يضمن كلفة من المكلف على ألا يبيع السلعة إلا هو، ويبيعها بما يختار، لا ريب أنه من جنس ظلم الكلف السلطانية من الوجهين اللذين تقدما؛ ولهذا كره من كره معاملة هذا لأجل الشبهة التي في ماله. فإنه إذا كان لا يبيع إلا هو بما يختار صار كأنه يكره الناس على الشراء منه بما يختاره، فيأخذ منهم أكثر مما يجب عليهم،/ وتلك الشبهة قد اختلطت بماله، فيصير في ماله شبهة من هذا الوجه؛ فلهذا كره من كره معاملتهم.
وهذا سبيل أهل الورع الذين لا يأكلون من الشواء المضمن، ونحو ذلك، فإنهم إنما تورعوا عما كان بهذه المثابة، وهو أن يكون بحيث لا يشوي إلا هو، ولا يبيع الشواء إلا هو بما يختاره، ولا يبيع الملح إلا هو بما يختاره، والملح ليست كغيرها، فإن الملح في الأصل هو من المباحات التي يشترك فيها المسلمون، كالسمك وغيره من المباحات، إذا لم يمكن من أخذها إلا واحد بضمان عليه، والذي يشتريها منه بماله لا يحرم؛ لأن هذا المشتري لم يظلم فيه أحدًا، بل لو أخذها من الأصل كان له ذلك، ولو استأجر هذا أو غيره ليأخذها له من موضعها المشترك كان ذلك جائزًا، ولو كانت مشتركة بين المسلمين لكانت تكون أرخص، وكان المشتري يأخذها بدون ما أعطاه الضامن، فهذا الضامن يظلم المشتري وغيره.
وأما المشترون منه فهم لا يظلمون أحدًا، ولم يشتروا منه شيئا ملكه بماله، فإنما حرم عليه من الظلم من ترك ملكه لا يفوته، ولم يظلم فيه أحدًا؛ لأنها في الأصل مباحة، والمسلمون الذين يشترونها هم المظلومون، فإنه لولا الظلم لتمكنوا من أخذها بدون الثمن، فإذا ظلموا وأخذ منهم أكثر مما عليهم لم يكن ذلك محرمًا عليهم لما كان / مباحا لهم؛ إذ الظلم إنما يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم.
ألا ترى أن المدلس والغاش ونحوهما إذا باعوا غيرهم شيئًا مدلسًا لم يكن ما يشتريه حرامًا عليه؛ لأنه أخذ منه أكثر مما يجب عليه، وإن كانت الزيادة التي أخذها الغاش حرامًا عليه. وأمثال هذا كثير في الشريعة؛ فإن التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر، كما لو اشتري الرجل ملكه المغصوب من الغاصب، فإن البائع يحرم عليه أخذ الثمن، والمشتري لا يحرم عليه أخذ ملكه، ولا بذل ما بذله من الثمن؛ ولهذا قال العلماء: يجوز رشوة العامل لدفع الظلم، لا لمنع الحق، وإرشاؤه حرام فيهما. وكذلك الأسير والعبد المعتق، إذا أنكر سيده عتقه، له أن يفتدي نفسه بمال يبذله، يجوز له بذله، وإن لم يجز للمستولي عليه بغير حق أخذه.
وكذلك المرأة المطلقة ثلاثًا إذا جحد الزوج طلاقها، فافتدت منه بطريق الخلع في الظاهر كان حرامًا عليه ما بذلته ويخلصها من رق استيلائه؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لأعطي أحدهم العطيَّة فيخرج بها يتلظَّاها نارًا)، قالوا: يا رسول الله، فلم تعطيهم؟ قال: (يأبون إلا أن يسألوني، ويأبي الله لي البُخل).
ومن ذلك قوله: (ما وقي به المرء عرضه فهو صدقة). فلو أعطي الرجل شاعرًا، أو غير شاعر؛ لئلا يكذب عليه بهجو أو غيره، أو لئلا يقول في عرضه ما يحرم عليه قوله، كان بذله لذلك جائزًا، وكان ما أخذه ذلك لئلا يظلمه حرامًا عليه؛ لأنه يجب عليه ترك ظلمه. والكذب عليه بالهجو من جنس تسمية العامة: [ قطع مصانعه ] وهو الذي يتعرض للناس، وإن لم يعطوه اعتدي عليهم، بأن يكون عونًا عليهم في الإثم والعدوان، أو بأن يكذب عليهم، وأمثال ذلك. فكل من أخذ المال لئلا يكذب على الناس، أو لئلا يظلمهم كان ذلك خبيثًا سحتًا؛ لأن الظلم والكذب حرام عليه، فعليه أن يتركه بلا عوض يأخذه من المظلوم، فإذا لم يتركه إلا بالعوض كان سحتًا.
فالمباحات التي يشترك فيها المسلمون في الأصل؛ كالصيود البرية والبحرية، المباحات النابتة في الأرض، والمباحة من الجبال والبراري ونحو ذلك، كالمعادن وكالملح، وكالأطرون وغيرها إذا حجرها السلطان وأمر ألا يأخذها إلا نوابه، وأن تباع للناس، لم يحرم عليهم شراؤها؛ لأنهم لا يظلمون فيها أحدًا، ولأنهم هم المظلومون بحجرها عليهم، فكيف يحرم عليهم أن يشتروا مالهم أن يأخذوه بلا عوض؛ فإن نواب السلطان لا يستخرجونها إلا بأثمانها التي أخذوها ظلمًا، أو نحو ذلك من الظلم.
قيل: تلك الأموال أخذت من المسلمين ظلمًا، والمسلمون هم / المظلومون، فقد منعوا حقوقهم من المباحات، إلا بما يؤخذ منهم يستخرج ببعضه تلك المباحات، والباقي يؤخذ، وذلك لا يحرم عليهم ما كان حلالًا لهم، وهذا ظاهر فيما كان الظلم فيه مناسبًا، مثل أن يباع كل مقدار بثمن معين، ويؤخذ من تلك الأثمان ما يستخرج به تلك المباحات، وهنا لا شبهة على المشتري أصلا؛ فإن ما استخرجت به المباحات هو حقهم أيضا. فهو كما لو غصب رجل بيت رجل، وأمر غلمان المالك أن يطبخوا مما في بيته طعامًا فإن ذلك لا يحرم على المغصوب؛ لأنه يملك الأعيان والمنافع، وليس في ذلك إلا أن يكون التصرف وقع بغير وكالة منه، ولا ولاية عليه، وهذا لا يحرم ماله، بل ولا بذل ماله باتفاق المسلمين. وإن كان ما يستخرج به تلك المباحات بدون المعاملة بالأموال السلطانية المشتركة.
وأما إذا استخرج نواب السلطان بغير حق من يستخرج تلك المباحات، فهذا بمنزلة أن يغصب من يطبخ له طعاما أو ينسج له ثوبا، وبمنزلة أن يطبخ الطعام بحطب مغصوب، وأمثال ذلك مما تكون العين فيه مباحة، لكن وقع الظلم في تحويلها من حال إلى حال. فهذا فيه شبهة، وطريق التخلص منها أن ينظر النفع الحاصل في تلك العين بعمل المظلوم، فيعطي المظلوم أجره، وإن تعذر معرفة المظلوم تصدق به عنه؛ فإن هذا غايته أن يكون قد اختلط حلال وحرام، ولو اختلطت الأعيان التي يملكها بالأثمان التي / غصبها وأخذها حرامًا، مثل أن تختلط دراهمه ودنانيره بما غصبه من الدراهم والدنانير، واختلط حبه أو ثمره أو دقيقه أو خله أو ذهبه بما غصبه من هذه الأنواع، فإن هذا الاختلاط لا يوجب تحريم ماله عليه؛ لأن المحرمات نوعان:
محرم لوصفه وعينه: كالدم والميتة ولحم الخنزير. فهذا إذا اختلط بالمائع وظهر فيه طعم الخبث أو لونه أو ريحه حرم.
ومحرم لكسبه: كالنقدين، والحبوب، والثمار، وأمثال ذلك. فهذه لا تحرم أعيانها تحريما مطلقا بحال، ولكن تحرم على من أخذها ظلمًا أو بوجه محرم،فإذا أخذ الرجل منها شيئا، وخلطه بماله، فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم، وقدر ماله حلال له. ولو أخرج مثله من غيره؟ ففيه وجهان في مذهب الشافعي وأحمد.
أحدهما: أن الاختلاط كالتلف، فإذا أخرج مثله أجزأ.
والثاني: أن حق المظلوم يتعلق بالعين مع الخلط، فلابد أن يخرج قدر حق المظلوم من ذلك المال المختلط.
إذا تبين هذا، فإذا كان أثر عمل المظلوم قائمًا بالعين؛ مثل طبخه أو نسجه ونحو ذلك، فإنما يستحق قيمة ذلك النفع، فإذا أعطي المظلوم / قيمة ذلك النفع أخذ حقه، فلا يبقي لصاحب العين شريك، فلا يحرم عليه. وأما إذا لم يعرف المظلوم فإنه يتصدق به عنه عند جمهور العلماء، كما لو حصل بيده أثمان من غصوب وعوارٍ وودائع لا يعرف أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم؛ لأن المجهول كالمعدوم في الشريعة، والمعجوز عنه كالمعدوم؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: (فإن جاء صاحبها فأدها إليه، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء).
فإذا كان في اللقطة التي تحرم، بأنها سقطت من مالك، لما تعذر معرفة صاحبها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للملتقط ـ ولا نزاع بين المسلمين في جواز صدقته بها، وإنما تنازعوا في جواز تملكه لها مع الغني، والجمهور على جواز ذلك ـ فكيف ما يجهل فيه ذلك.
وفي هذه المسألة آثار معروفة، مثل حديث عبد الله بن مسعود لما اشتري جارية، ثم خرج ليوفي البائع الثمن فلم يجده، فجعل يطوف على المساكين، ويقول: اللهم هذه عن صاحب الجارية، فإن رضي فقد برئت ذمتي، وإن لم يرض فهو عني، وله على مثلها يوم القيامة. وحديث الرجل الذي غل من الغنيمة، في غزوة قبرص، وجاء إلى معاوية يرد إليه المغلول، فلم يأخذه، فاستفتي بعض التابعين فأفتاه بأن يتصدق بذلك عن الجيش، ورجع إلى معاوية فأخبره، فاستحسن ذلك؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ، والمال / الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه، فيصرف في مصالح المسلمين، والصدقة من أعظم مصالح المسلمين. وهذا أصل عام في كل مال جهل مالكه، بحيث يتعذر رده إليه؛ كالمغصوب، والعواري والودائع، تصرف في مصالح المسلمين على مذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة، وغيرهم.
وإذا صرفت على هذا الوجه جاز للفقير أخذها؛ لأن المعطي هنا إنما يعطيها نيابة عن صاحبها، بخلاف من تصدق من غلول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحـديث الصحيح: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول).
فهذا الذي يحوز المال ويتصدق به. مع إمكان رده إلى صاحبه، أو يتصدق صدقة متقرب، كما يتصدق بماله، فالله لا يقبل ذلك منه، وأما ذاك فإنما يتصدق به صدقة متحرج متأثم، فكانت صدقته بمنزلة أداء الدين الذي عليه، وأداء الأمانات إلى أصحابها، وبمنزلة إعطاء المال للوكيل المستحق، ليس هو من الصدقة الداخلة في قوله: (ولا صدقة من غلول).
 عدد المشاهدات *:
عدد المشاهدات *:
707430
 عدد مرات التنزيل *:
عدد مرات التنزيل *:
302146
 حجم الخط :
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013