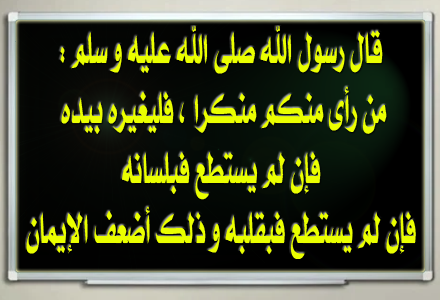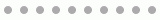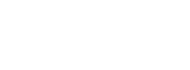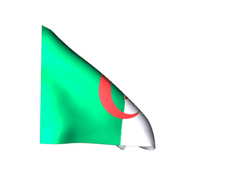وسئل شيخُ الإسلام عـن رجل أخذ ماله ظلما بغير حق، وانتهك عرضه، أو نيل منه في بدنه، فلم يقتص في الدنيا، وعلم أن ما عند اللّه خير وأبقي. فهل يكون عفوه عن ظالمه مسقطا عند اللّه؟ أم نقصا له؟ أم لا يكون؟ أو يكون أجره باقيا كاملا موفرًا؟ وأيما أولي مطالبة هذا الظالم والانتقام منه يوم القيامة وتعذيب اللّه له. أو العفو عنه وقبول الحوالة على اللّه تعالى؟
فأجاب:
لا يكون العفو عن الظالم، ولا قليله مسقطا لأجر المظلوم عند اللّه، ولا منقصا له، بل العفو عن الظالم يصير أجره على اللّه تعالى؛ فإنه إذا لم يعف كان حقه على الظالم، فله أن يقتص منه بقدر مظلمته، وإذا عفا وأصلح فأجره على اللّه. وأجره الذي هو على اللّه خير وأبقي. قال تعالى: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [الشوري: 40]
فقد أخبر أن جزاء السيئة سيئة مثلها بلا عدوان، وهذا هو القصاص في الدماء، والأموال، والأعراض،ونحو ذلك.ثم قال: /{فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}، وقد ذكر عن الإمام أحمد لما ظلم في محنته المشهورة أنه لم يخرج حتي حلل من ظلمه. وقال: ذكرت حديثا ذكر عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال:إذا كان يوم القيامة نادي مناد: ألا ليقم من وجب أجره على فلا يقوم إلا من عفا وأصلح.
وقد قال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ} [النحل: 126] ، وأباح لهم ـ سبحانه وتعالى ـ إذا عاقبوا الظالم أن يعاقبوه بمثل ما عاقب به، ثم قال:{وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ}، فعلم أن الصبر عن عقوبته بالمثل خير من عقوبته. فكيف يكون مسقطا للأجر أو منقصًا له؟!
وقد قال تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ} [المائدة: 45] . فجعل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم ـ وهو العفو عن القصاص ـ كفارة للعافي، والاقتصاص ليس بكفارة له، فعلم أن العفو خير له من الاقتصاص. وهذا لأن ما أصابه من المصائب مكفر للذنوب، ويؤجر العبد على صبره عليها، ويرفع درجته برضاه بما يقضيه اللّه عليه منها. قال اللّه تعالى: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: 11] ، قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند اللّه، فيرضي ويسلم، وفي الصحيحين عن النبي /صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما يصيب المؤمن من وَصَب ولا نَصَب ولا هَمّ ولا حَزَن ولا غَمّ ولا أذي حتي الشوكة يشاكها، إلا كفر اللّه بها من خطاياه).
وفي المسند: أنه لما نزل قوله تعالى: {مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] ، قال أبو بكر: يارسول اللّه، نزلت قاصمة الظهر، وأينا لم يعمل سوءًا ؟! فقال: (يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء. فذلك ما تجزون به) وفيه أيضا: (المصائب حطة تحط الخطايا عن صاحبها، كما تحط الشجرة القائمة ورقها).
والدلائل على أن المصائب كفارات كثيرة، إذا صبر عليها أثيب على صبره، فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل ـ وهو الصبر ـ وأما نفس المصيبة فهي من فعل اللّه، لا من فعل العبد، وهي من جزاء اللّه للعبد على ذنبه، وتكفيره ذنبه بها. وفي المسند: أنهم دخلوا على أبي عبيدة بن الجراح وهو مريض، فذكروا أنه يؤجر على مرضه، فقال: مالى من الأجر ولا مثل هذه. ولكن المصائب حطة. فبين لهم أبو عبيدة ـ رضي اللّه عنه ـ أن نفس المرض لا يؤجر عليه، بل يكفر به عن خطاياه.
وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب،فيكون فيه أجر بهذا /الاعتبار.ومن الناس من يقول: لابد فيه من التعويض والأجر والامتنان، وقد يحصل له ثواب بغير عمل، كما يفعل عنه من أعمال البر.
وأما الصبر على المصائب ففيها أجر عظيم، قال تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة:155ـ157] فالرجل إذا ظلم بجرح ونحوه فتصدق به، كان الجرح مصيبة يكفر بها عنه، ويؤجر على صبره، وعلى إحسانه إلى الظالم بالعفو عنه؛ فإن الإحسان يكون بجلب منفعة، وبدفع مضرة؛ ولهذا سماه اللّه صدقة.
وقد قال تعالى: {وَسَارِعُواْ إلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 133، 134] فذكر: أنه يحب المحسنين، والعافين عن الناس. وتبين بهذا أن هذا من الإحسان. والإحسان ضد الإساءة، وهو فعل الحسن، سواء كان لازمًا لصاحبه، أو متعديا إلى الغير، ومنه قوله: {مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} [الأنعام: 160] . فالكاظم للغيظ، والعافي عن الناس، قد أحسن إلى نفسه، وإلى الناس؛ فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه، ومع الناس، ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه. كما يروي عن بعض السلف أنه قال: ما أحسنت إلى أحد، وما أسأت إلى أحد، /وإنما أحسنت إلى نفسي، وأسأت إلى نفسي، قال تعالى: {إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء:7] ، وقال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا} [فصلت: 46] .
ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق إحسانًا إلى المحسن، يعود نفعه عليه، لكان فاعلا إثمًا أو ضررًا؛ فإن العمل الذي لا يعود نفعه على فاعله، إما حيث لم يكن فيه فائدة، وإما شر من العبث؛ إذا ضر فاعله. والعفو عن الظالم أحد نوعي الصدقة؛ المعروف، والإحسان إلى الناس. وجماع ذلك الزكاة.
واللّه ـ سبحانه ـ دائمًا يأمر بالصلاة، والزكاة، وهي الصدقة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: (كل معروف صدقة)، وذلك نوعان:
أحدهما: اتصال نفع اليه.
الثاني: دفع ضرر عنه. فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم، ونفسه تدعوه اليه، فكف نفسه عن ذلك، ودفع عنه ما يدعوه اليه من إضراره، فهذا إحسان منه اليه، وصدقة عليه، واللّه تعالى يجزي المتصدقين، ولا يضيع أجر المحسنين. فكيف يسقط أجر العافي؟!
وهذا عام في سائر ما للعبد من الحقوق على الناس؛ولهذا إذا /ذكر اللّه في كتابه حقوق العباد، وذكر فيها العدل ندب فيها إلى الإحسان، فإنه ـ سبحانه ـ يأمر بالعدل والإحسان، كما قال تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280] . فجعل الصدقة على المدين المعسر بإسقاط الدين عنه خيرا للمتصدق من مجرد إنظاره.
وقال تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} [النساء: 92] ، فسمي إسقاط الدية صدقة. وقال تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237] ، فجعل العفو عن نصف الصداق الواجب على الزوج بالطلاق قبل الدخول أقرب للتقوي من استيفائه. وعفو المرأة إسقاط نصف الصداق باتفاق الأمة.
وأما عفو الذي بيده عقدة النكاح، فقيل: هو عفو الزوج، وأنه تكميل للصداق للمرأة، وعلى هذا يكون هذا العفو من جنس ذلك العفو، فهذا العفو إعطاء الجميع، وذلك العفو إسقاط الجميع. والذي حمل من قال هذا القول عليه؛ أنهم رأوا أن غير المرأة لا تملك إسقاط حقها الواجب، كما لا تملك إسقاط سائر ديونها. وقيل: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة المستقل بالعقد بدون استئذانها؛ /كالأب للبكر الصغيرة، وكالسيد للأمة، وعلى هذا يكون العفوان من جنس واحد. ولهذا لم يقل: إلا أن يعفون، أو يعفوهم، والخطاب في الآية للأزواج.
وقال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [لقمان: 17] ، وقال تعالى: {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [الشوري: 41ـ43] .
فهناك في قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقال: {إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [لقمان: 17] ، وهنا ذكر الصبر والعفو، فقال: {إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} وذكر ذلك بعد قوله: {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ}، فذكر ـ سبحانه ـ الأصناف الثلاثة، في باب الظلم الذي يكون بغير اختيار المظلوم؛ وهم: العادل، والظالم، والمحسن.
فالعادل من انتصر بعد ظلمه وهذا جزاؤه أنه ما عليه من سبيل،فلم يكن بذلك ممدوحا، ولكن لم يكن بذلك مذمومًا. وذكر الظالم بقوله: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ}، فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة، والاقتصاص. وذكر المحسنين /فقال: {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}. والقرآن فيه جوامع الكلم.
وهذا كما ذكر في آخر البقرة أصناف الناس في المعاملات، التي تكون باختيار المتعاملين، وهم ثلاثة: محسن، وظالم، وعادل. فالمحسن: هو المتصدق. والظالم: هو المربي. والعـادل: هـو البائع. فذكـر هنـا حكـم الصدقـات، وحكم الربـا، وحكم المبايعـات، والمداينات.
وكما أن من توهم أنه بالعفو يسقط حقه أو ينقص، غالط جاهل ضال، بل بالعفو يكون أجره أعظم؛ فكذلك من توهم أنه بالعفو يحصل له ذل، ويحصل للظالم عز واستطالة عليه، فهو غالط في ذلك. كما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاث إن كنتُ لحالفا عليهن: ما زاد اللّه عبدًا بعفو إلا عزًا، وما نقصت صدقة من مال، وما تواضع أحد للّه إلا رفعه اللّه). فبين الصادق المصدوق: أن اللّه لا يزيد العبد بالعفو إلا عزًا، وأنه لا تنقص صدقة من مال، وأنه ما تواضع أحد للّه إلا رفعه اللّه. وهذا رد لما يظنه من يتبع الظن، وما تهوي الأنفس، من أن العفو يذله، والصدقة تنقص ماله، والتواضع يخفضه.
وفي الصحيحين عن عائشة ـ رضي اللّه عنها ـ قالت: ماضرب /رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خادمًا له، ولا امرأة، ولا دابة، ولا شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل اللّه، ولا نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه؛ إلا أن تنتهك محارم اللّه، فإذا انتهكت محارم اللّه لم يقم لغضبه شيء. حتي ينتقم للّه. وخُلُق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم القرآن أكمل الأخلاق، وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه، وإذا انتهكت محارم اللّه لم يقم لغضبه شيء حتي ينتقم للّه، فيعفو عن حقه، ويستوفي حق ربه.
والناس في الباب أربعة أقسام:
منهم: من ينتصر لنفسه ولربه، وهو الذي يكون فيه دين وغضب.
ومنهم: من لا ينتصر لا لنفسه ولا لربه، وهو الذي فيه جهل وضعف دين.
ومنهم: من ينتقم لنفسه لا لربه، وهم شر الأقسام.
وأما الكامل فهو الذي ينتصر لحق اللّه، ويعفو عن حقه. كما قال أنس بن مالك: خدمت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي: أف قط. وما قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله:لم لا فعلته؟وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول: (دعوه لو قضي شيء لكان).فهذا في العفو عما يتعلق بحقوقه /وأما في حدود اللّه،فلما شفع عنده أسامة بن زيد ـ وهو الحب ابن الحب، وكان هو أحب اليه من أنس، وأعز عنده ـ في امرأة سرقت شريفة أن يعفو عن قطع يدها. غضب، وقال: (يا أسامة، أتشفع في حد من حدود اللّه؟! إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها). فغضب على أسامة لما شفع في حد للّه، وعفا عن أنس في حقه. وكذلك لما أخبره أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال: لا إله إلا اللّه. قال: (أقتلته بعدما قال: لا إله إلا اللّه)، فما زال يكررها حتي قلت: ليته سكت.
والأحاديث والآثار في استحباب العفو عن الظالم، وأن أجره بذلك أعظم كثيرة جدًا. وهذا من العلم المستقر في فطر الآدميين. وقد قال تعالى لنبيه: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199] ، فأمره أن يأخذ العفو في أخلاق الناس، وهو ما يقر من ذلك. قال ابن الزبير: أمر اللّه نبيه أن يأخذ بالعفو من أخلاق الناس، وهذا كقوله: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219] ، من أموالهم. هذا من العفو، ويأمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين. وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة؛ فإن الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه غير /ما يحب، أو ما يكره. فأمر أن يأخذ منهم ما يحب ما سمحوا به، ولا يطالبهم بزيادة. وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم، وأما هو فيأمرهم بالمعروف. وهذا باب واسع.
فأجاب:
لا يكون العفو عن الظالم، ولا قليله مسقطا لأجر المظلوم عند اللّه، ولا منقصا له، بل العفو عن الظالم يصير أجره على اللّه تعالى؛ فإنه إذا لم يعف كان حقه على الظالم، فله أن يقتص منه بقدر مظلمته، وإذا عفا وأصلح فأجره على اللّه. وأجره الذي هو على اللّه خير وأبقي. قال تعالى: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [الشوري: 40]
فقد أخبر أن جزاء السيئة سيئة مثلها بلا عدوان، وهذا هو القصاص في الدماء، والأموال، والأعراض،ونحو ذلك.ثم قال: /{فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}، وقد ذكر عن الإمام أحمد لما ظلم في محنته المشهورة أنه لم يخرج حتي حلل من ظلمه. وقال: ذكرت حديثا ذكر عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال:إذا كان يوم القيامة نادي مناد: ألا ليقم من وجب أجره على فلا يقوم إلا من عفا وأصلح.
وقد قال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ} [النحل: 126] ، وأباح لهم ـ سبحانه وتعالى ـ إذا عاقبوا الظالم أن يعاقبوه بمثل ما عاقب به، ثم قال:{وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ}، فعلم أن الصبر عن عقوبته بالمثل خير من عقوبته. فكيف يكون مسقطا للأجر أو منقصًا له؟!
وقد قال تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ} [المائدة: 45] . فجعل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم ـ وهو العفو عن القصاص ـ كفارة للعافي، والاقتصاص ليس بكفارة له، فعلم أن العفو خير له من الاقتصاص. وهذا لأن ما أصابه من المصائب مكفر للذنوب، ويؤجر العبد على صبره عليها، ويرفع درجته برضاه بما يقضيه اللّه عليه منها. قال اللّه تعالى: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: 11] ، قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند اللّه، فيرضي ويسلم، وفي الصحيحين عن النبي /صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما يصيب المؤمن من وَصَب ولا نَصَب ولا هَمّ ولا حَزَن ولا غَمّ ولا أذي حتي الشوكة يشاكها، إلا كفر اللّه بها من خطاياه).
وفي المسند: أنه لما نزل قوله تعالى: {مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] ، قال أبو بكر: يارسول اللّه، نزلت قاصمة الظهر، وأينا لم يعمل سوءًا ؟! فقال: (يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء. فذلك ما تجزون به) وفيه أيضا: (المصائب حطة تحط الخطايا عن صاحبها، كما تحط الشجرة القائمة ورقها).
والدلائل على أن المصائب كفارات كثيرة، إذا صبر عليها أثيب على صبره، فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل ـ وهو الصبر ـ وأما نفس المصيبة فهي من فعل اللّه، لا من فعل العبد، وهي من جزاء اللّه للعبد على ذنبه، وتكفيره ذنبه بها. وفي المسند: أنهم دخلوا على أبي عبيدة بن الجراح وهو مريض، فذكروا أنه يؤجر على مرضه، فقال: مالى من الأجر ولا مثل هذه. ولكن المصائب حطة. فبين لهم أبو عبيدة ـ رضي اللّه عنه ـ أن نفس المرض لا يؤجر عليه، بل يكفر به عن خطاياه.
وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب،فيكون فيه أجر بهذا /الاعتبار.ومن الناس من يقول: لابد فيه من التعويض والأجر والامتنان، وقد يحصل له ثواب بغير عمل، كما يفعل عنه من أعمال البر.
وأما الصبر على المصائب ففيها أجر عظيم، قال تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة:155ـ157] فالرجل إذا ظلم بجرح ونحوه فتصدق به، كان الجرح مصيبة يكفر بها عنه، ويؤجر على صبره، وعلى إحسانه إلى الظالم بالعفو عنه؛ فإن الإحسان يكون بجلب منفعة، وبدفع مضرة؛ ولهذا سماه اللّه صدقة.
وقد قال تعالى: {وَسَارِعُواْ إلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 133، 134] فذكر: أنه يحب المحسنين، والعافين عن الناس. وتبين بهذا أن هذا من الإحسان. والإحسان ضد الإساءة، وهو فعل الحسن، سواء كان لازمًا لصاحبه، أو متعديا إلى الغير، ومنه قوله: {مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} [الأنعام: 160] . فالكاظم للغيظ، والعافي عن الناس، قد أحسن إلى نفسه، وإلى الناس؛ فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه، ومع الناس، ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه. كما يروي عن بعض السلف أنه قال: ما أحسنت إلى أحد، وما أسأت إلى أحد، /وإنما أحسنت إلى نفسي، وأسأت إلى نفسي، قال تعالى: {إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء:7] ، وقال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا} [فصلت: 46] .
ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق إحسانًا إلى المحسن، يعود نفعه عليه، لكان فاعلا إثمًا أو ضررًا؛ فإن العمل الذي لا يعود نفعه على فاعله، إما حيث لم يكن فيه فائدة، وإما شر من العبث؛ إذا ضر فاعله. والعفو عن الظالم أحد نوعي الصدقة؛ المعروف، والإحسان إلى الناس. وجماع ذلك الزكاة.
واللّه ـ سبحانه ـ دائمًا يأمر بالصلاة، والزكاة، وهي الصدقة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: (كل معروف صدقة)، وذلك نوعان:
أحدهما: اتصال نفع اليه.
الثاني: دفع ضرر عنه. فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم، ونفسه تدعوه اليه، فكف نفسه عن ذلك، ودفع عنه ما يدعوه اليه من إضراره، فهذا إحسان منه اليه، وصدقة عليه، واللّه تعالى يجزي المتصدقين، ولا يضيع أجر المحسنين. فكيف يسقط أجر العافي؟!
وهذا عام في سائر ما للعبد من الحقوق على الناس؛ولهذا إذا /ذكر اللّه في كتابه حقوق العباد، وذكر فيها العدل ندب فيها إلى الإحسان، فإنه ـ سبحانه ـ يأمر بالعدل والإحسان، كما قال تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280] . فجعل الصدقة على المدين المعسر بإسقاط الدين عنه خيرا للمتصدق من مجرد إنظاره.
وقال تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} [النساء: 92] ، فسمي إسقاط الدية صدقة. وقال تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237] ، فجعل العفو عن نصف الصداق الواجب على الزوج بالطلاق قبل الدخول أقرب للتقوي من استيفائه. وعفو المرأة إسقاط نصف الصداق باتفاق الأمة.
وأما عفو الذي بيده عقدة النكاح، فقيل: هو عفو الزوج، وأنه تكميل للصداق للمرأة، وعلى هذا يكون هذا العفو من جنس ذلك العفو، فهذا العفو إعطاء الجميع، وذلك العفو إسقاط الجميع. والذي حمل من قال هذا القول عليه؛ أنهم رأوا أن غير المرأة لا تملك إسقاط حقها الواجب، كما لا تملك إسقاط سائر ديونها. وقيل: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة المستقل بالعقد بدون استئذانها؛ /كالأب للبكر الصغيرة، وكالسيد للأمة، وعلى هذا يكون العفوان من جنس واحد. ولهذا لم يقل: إلا أن يعفون، أو يعفوهم، والخطاب في الآية للأزواج.
وقال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [لقمان: 17] ، وقال تعالى: {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [الشوري: 41ـ43] .
فهناك في قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقال: {إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [لقمان: 17] ، وهنا ذكر الصبر والعفو، فقال: {إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} وذكر ذلك بعد قوله: {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ}، فذكر ـ سبحانه ـ الأصناف الثلاثة، في باب الظلم الذي يكون بغير اختيار المظلوم؛ وهم: العادل، والظالم، والمحسن.
فالعادل من انتصر بعد ظلمه وهذا جزاؤه أنه ما عليه من سبيل،فلم يكن بذلك ممدوحا، ولكن لم يكن بذلك مذمومًا. وذكر الظالم بقوله: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ}، فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة، والاقتصاص. وذكر المحسنين /فقال: {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}. والقرآن فيه جوامع الكلم.
وهذا كما ذكر في آخر البقرة أصناف الناس في المعاملات، التي تكون باختيار المتعاملين، وهم ثلاثة: محسن، وظالم، وعادل. فالمحسن: هو المتصدق. والظالم: هو المربي. والعـادل: هـو البائع. فذكـر هنـا حكـم الصدقـات، وحكم الربـا، وحكم المبايعـات، والمداينات.
وكما أن من توهم أنه بالعفو يسقط حقه أو ينقص، غالط جاهل ضال، بل بالعفو يكون أجره أعظم؛ فكذلك من توهم أنه بالعفو يحصل له ذل، ويحصل للظالم عز واستطالة عليه، فهو غالط في ذلك. كما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاث إن كنتُ لحالفا عليهن: ما زاد اللّه عبدًا بعفو إلا عزًا، وما نقصت صدقة من مال، وما تواضع أحد للّه إلا رفعه اللّه). فبين الصادق المصدوق: أن اللّه لا يزيد العبد بالعفو إلا عزًا، وأنه لا تنقص صدقة من مال، وأنه ما تواضع أحد للّه إلا رفعه اللّه. وهذا رد لما يظنه من يتبع الظن، وما تهوي الأنفس، من أن العفو يذله، والصدقة تنقص ماله، والتواضع يخفضه.
وفي الصحيحين عن عائشة ـ رضي اللّه عنها ـ قالت: ماضرب /رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خادمًا له، ولا امرأة، ولا دابة، ولا شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل اللّه، ولا نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه؛ إلا أن تنتهك محارم اللّه، فإذا انتهكت محارم اللّه لم يقم لغضبه شيء. حتي ينتقم للّه. وخُلُق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم القرآن أكمل الأخلاق، وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه، وإذا انتهكت محارم اللّه لم يقم لغضبه شيء حتي ينتقم للّه، فيعفو عن حقه، ويستوفي حق ربه.
والناس في الباب أربعة أقسام:
منهم: من ينتصر لنفسه ولربه، وهو الذي يكون فيه دين وغضب.
ومنهم: من لا ينتصر لا لنفسه ولا لربه، وهو الذي فيه جهل وضعف دين.
ومنهم: من ينتقم لنفسه لا لربه، وهم شر الأقسام.
وأما الكامل فهو الذي ينتصر لحق اللّه، ويعفو عن حقه. كما قال أنس بن مالك: خدمت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي: أف قط. وما قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله:لم لا فعلته؟وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول: (دعوه لو قضي شيء لكان).فهذا في العفو عما يتعلق بحقوقه /وأما في حدود اللّه،فلما شفع عنده أسامة بن زيد ـ وهو الحب ابن الحب، وكان هو أحب اليه من أنس، وأعز عنده ـ في امرأة سرقت شريفة أن يعفو عن قطع يدها. غضب، وقال: (يا أسامة، أتشفع في حد من حدود اللّه؟! إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها). فغضب على أسامة لما شفع في حد للّه، وعفا عن أنس في حقه. وكذلك لما أخبره أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال: لا إله إلا اللّه. قال: (أقتلته بعدما قال: لا إله إلا اللّه)، فما زال يكررها حتي قلت: ليته سكت.
والأحاديث والآثار في استحباب العفو عن الظالم، وأن أجره بذلك أعظم كثيرة جدًا. وهذا من العلم المستقر في فطر الآدميين. وقد قال تعالى لنبيه: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199] ، فأمره أن يأخذ العفو في أخلاق الناس، وهو ما يقر من ذلك. قال ابن الزبير: أمر اللّه نبيه أن يأخذ بالعفو من أخلاق الناس، وهذا كقوله: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219] ، من أموالهم. هذا من العفو، ويأمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين. وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة؛ فإن الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه غير /ما يحب، أو ما يكره. فأمر أن يأخذ منهم ما يحب ما سمحوا به، ولا يطالبهم بزيادة. وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم، وأما هو فيأمرهم بالمعروف. وهذا باب واسع.
 عدد المشاهدات *:
عدد المشاهدات *:
663152
 عدد مرات التنزيل *:
عدد مرات التنزيل *:
293339
 حجم الخط :
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013